مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
January 14, 2024
نشأة المجامع المارونيّة وتطورها (1557 - 2004)

ميشال جميل غانم *
The emergence and development of Maronite councils (1557 - 2004) -Dr. Michel Ghanem
مستخلصهل المجامع المارونية التي انعقدت على مدى أربعة عقود ساهمت في احداث تغيير في واقع الكنيسة المارونية، وفي تطوير شؤون الطائفة؟ وهل حققت أهدافها المحدّدة؟بعد جدل طويل بين المؤرخين حول العدد الحقيقي لهذه المجامع، تمّ التأكيد على وجود ثمانية عشر مجمعًا مارونيًّا عقدت على مدى ثلاثمائة سنة (1557 - 1856)، وفي رأي الباحثين جميعًا أن هذه المجامع تشكل فصلًا مهمًا من تاريخ الطائفة المارونيّة لجهة تنظيم ذاتها، ومصادر تشريعاتها، وتأكيد هويتها، وتأدية رسالتها المشرقية ضمن الكنيسة الجامعة، في حلقاتٍ مترابطة الأجزاء موحّدة الأهداف تمدّ السابقة منها اللاحقة بمقوّمات البقاء والديمومة، مما يزيد في تجذيرها في تربة التاريخ، وترسيخها في عمق الوجدان الماروني المتطلّع أبدًا إلى الأمام، عين له على الماضي المجيد، وعين على المستقبل ذي الآمال العريضة، أما أثرها فيضرب أعماق العقيدة والطقوس والتنظيم الكنسي والشرع، والحياة الاجتماعية والثقافية التي أسهمت هذه المجامع في إنمائها وإغنائها.لقد رافقت هذه المجامع البطاركة العظام الذين دعوا إليها ورعوها في تنقلاتهم بين الشمال والجبل والجنوب، بحيث كانت تعقد في مقرّاتهم المتنقلّة أو في أحد الأديار والكنائس المجاورة، وفقًا للظروف السياسية والاجتماعية التي غالبًا ما كانت تتحكّم بقرار الدعوة. فالمجامع الستّة الأولى التأمت في وادي قنّوبين وضواحيها، كما شهدت كسروان التئام القسم الأكبر من المجامع اللاحقة. أما نصوص أعمالها، فتتراوح بين الصفحة الواحدة والمجلد الكبير. كذلك عدد الجلسات، فمن جلسة واحدة قصيرة إلى خمس عشرة جلسة صباحية ومسائية على مدى أسبوع كامل. أما الدعوة إلى الانعقاد، فأحيانا كان يقوم بها البطريرك بنفسه، وأحيانًا تأخذ روما المبادرة، فتوفد قاصدًا رسوليًّا من قبلها، ليتفق وإيّاه على عقد مجمع يرأسه الاثنان معًا. وما يلفت النظر ان روما لم تثبت رسميًّا من كل هذه المجامع سوى ثلاثة فقط، وربما انها اعتبرت حضور مندوبها المجمع موافقة ضمنية عليه.ونقسم بحثنا أربعة أقسام، على عدد القرون التي عقدت فيها هذه المجامع.
- الكلمات المفتاحية: لبنان؛ الكنيسة المارونية، تاريخ لبنان، المجامع المارونية
***
- باحث لبناني. حائز شهادة دكتوراه في التاريخ في الجامعة اللبنانية
المصادر والمراجع
- البطريرك اسطفان الدويهي: تاريخ الأزمنة، طبعة فهد، مطابع الكريم الحديثة، جونية 1976- الدكتور ساسين عساف: البطريركان موسى العكاري وميخائيل الرزي والمجمعان المارونيان الأولان، في "المنارة" 1983- الأباتي بطرس فهد: بطاركة الموارنة وأساقفتهم في القرن السادس عشر، جونية 1982- الأب أغناطيوس طنوس الخوري: حقيقة الموارنة وبعض رجالاتهم في الأجيال، في "السنابل"، عدد خاص 1958- الأب لويس شيخو: الطائفة المارونية والرهبانية اليسوعية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، المطبعة الكاثولوكية، بيروت 1923- الأب بطرس فهد: علاقات الطائفة المارونية بالكرسي الرسولي المقدس، مطبعة الكريم، جونية 1961- الأب سركيس الطبر الأنطوني: البطريرك ميخائيل الرزي ومجمع دير سيدة قنوبين 1580، في "المنارة" 1983- المونسنيور جوزف الفغالي: البطريركان سركيس ويوسف الرزي ومجامع 1596 و1598، في "المنارة" 1983- الدكتور جان شرف: البطريرك يوسف العاقوري ومجمع حراش 1644، في "المنارة: 1983- سلسلة بطاركة الطائفة المارونية للدويهي، طبعة الشرتوني، بيروت، 1901- الأب بولس صفير: المجمع اللبناني في نسخته العربية واللاتينية، في "المنارة" 1983- الآباتي بطرس فهد: العلّامة المطران يوسف سمعان السمعاني، مطابع الكريم الحديثة، جونية 1973: في مجموعة وثائق وأبحاث في التراث اللبناني، الجزء الأول 1983، دار كنعان، جونية- الآباتي بطرس فهد: مجموعة المجامع الطائفية المارونية عبر التاريخ، مطابع الكريم الحديثة، جونية 1975- البطريرك سمعان عواد ومجامعه الثلاثة، في "المنارة" 1983، ص 107- 120.- القس بولس عبود: بصائر الزمان، مطبعة صبرا، بيروت 1911، - محفوظات بكركي، جارور البطريرك طوبيا الخازن، رقم 57- الأب فيليب السمراني: النائب البطريركي ميخائيل الخازن ومجمع ميفوق، في "المنارة" 1983 ص 127-146. - الأب انطوان ضو: البطريرك يوسف اسطفان ومجمع بكركي- الأب إبراهيم حرفوش: مفوّض بن سلّوم التيّان من بيروت، في "المنارة" 1937.- الخوري أسقف يوسف زيادة: مجمع بلاد بشاره، في "المنارة" 1932 ص 196 – 203- الدكتور نعيم بارود: البطريرك يوحنا الحلو ومجمع سيدة اللويزه 1818، في "المنارة" 1983، ص 195-204.- الأب بولس مسعد: المجمع البلدي 1856 في مجموعة نصوص ودراسات، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1959، المحامي هيام ملّاط: البطريرك بولس مسعد والمجمع اللبناني، بكركي 1856 في "المنارة" 1983 ص 205-218.- المطران نصر الله صفير: أثر المجامع الطائفية في حياة الكنيسة المارونية، في "المنارة" 1983 ص 10
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 193/194 - س. 25 - صيف Summer 2018ISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on January 14, 2024 14:39
جدل النهضة العربية

كمال علي منذر *The Arab Renaissance controversy - Dr. Kamal Monzer
مستخلصعُدّ عصر النهضة مرحلة تاريخية مهمة بالنسبة إلى العرب؛ فهذه المرحلة كانت هي المؤثّر الأكبر في الوعي العام، وفي تشكيل هذا الوعي والتاريخ المعاصرين، كما شكّلت المؤثّر في التيارات الفكرية والسياسية والدينية وغيرها...فما هي مؤثّرات هذه النهضة، وكيف ظهرت؟في الواقع، إنّ المجتمع العربي عاش في ظلّ حضارة الإسلام، تقدّمًا متتاليًا، بينما انعكس ذلك اليوم تخلفًا مزدوجًا؛ تخلفًا حضاريًا وتخلفًا أدبيًا... وكأن العالم العربي قد عاد إلى ما قبل الإسلام، إلى العصر الجاهلي، إذ نشاهد وبأمّ العين حالات التراجع الفكريّ والحضاريّ في الجامعات والمدارس، كما نلاحظ الشتات الذي تعاني منه الأمّة العربية الإسلامية. فما هي أسبابه؟خلاصة ذلك، النهضة نتيجة لعملية النهوض في أواخر العصر العثماني؛ وفي هذه الحال لم تكن نهضة كاملة تخلّص من خلالها العرب من عوامل التخلّف، وبالتالي لم يستطع الانطلاق والنهوض الايجابي بعيدًا من القيود المختلفة التي بقي رازحًا تحت ثقلها.النهضة في مفهومها عملية التغير من داخل المجتمع، عبر حدوث تجديدات فيه، أو من خارجه عبر إبرازها الاحتكاك بالثقافات الأخرى، وبالتالي نحن نقف أمام أمرين مهمين في نشوء النهضة: نحن والآخر، الأوّل يقتضي توافر ظروف خاصّة تنهض بالأمّة، والثاني التأثير الخارجي بطيئًا كان أم سريعًا([i]).والسؤال الذي يطرح هنا ما هو الدور الخارجي في النهضة العربية؟
- الكلمات المفتاحية: النهضة العربية؛ تاريخ العرب الحديث؛ المجتمع العربي
***
* باحث لبناني. أستاذ دكتور في التاريخ – الجامعة اللبنانية
[i]- إسماعيل صبري عبد الله، نحو نهضة عربية ثانية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 161، 1992، ص4.
المصادر والمراجع
1- أحمد السماوي، الاستبداد والحرية في فكر النهضة، اللاذقية: دار الحوار، ط2، 1989.2- اسماعيل صبري عبدالله، نحو نهضة عربية ثانية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 161، 1992.3- السيد يسين، أين نحن الآن من نهضة مطلع القرن، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 3 و4، 1998 المجلّد 26.4- جون لويس، مدخل الى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك، بيروت، دار الحقيقة، ط3، 1978.5- طارق البشري، التجديد الإسلامي بين قرن مضى وقرن يجيئ، مجلة المنار الجديد: القاهرة، العدد1، 19986- طارق شمس، ظروف النهضة العربية، محاضرة القيت في مؤتمر النهضة والعرب، النبطية في 12/1/2014.7- طارق شمس، العولمة بين التاريخ والجغرافيا، بيروت: دار العودة، ط 1، 2005.8- علي الشامي، الفلسفة والإنسان، بيروت، دار الإنسانية، ط1، 1990.9- غالي شكري، دكتاتورية التخلف العربي، القاهرة: النهضة المصرية العامة للكتاب، 1994.10- كمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، بيروت: دار الطليعة، ط1، 1992.11- محمد أركون، الفكر العربي، ترجمة عادل العوا، بيروت، منشورات عويدات، ط3، 1985.12- منير شفيق، الإسلام في معركة الحضارة، تونس، دار البراق، ط1، 199113- محمد عمارة، الإسلام بين التنوير والتزوير، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1995.14- محمد عمارة، أزمة الثقافة العربية، مجلة الاجتهاد، بيروت، العدد 10 و11، 1991.15- هشام غصيب، جدل الوعي العلمي، عمان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، 1992.16- وليد نويهض، النخبة ضد الأهل، بيروت، دار ابن حزم، ط1، 1994.
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 193/194 - س. 25 - صيف Summer 2018ISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on January 14, 2024 13:06
December 15, 2023
عصام نور الدين ... معنا وبيننا ستبقى


فقدت الساحة الثقافية واللغوية والأكاديمية اللبنانية والعربية، علمًا من أعلام اللغة العربية وآدابها، الكاتب والمفكر والباحث الأستاذ الدكتور عصام نور الدين الذي فارق الحياة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2023 في فرنسا.
عصام نور الدين الذي ولد في بلدة خربة سلم (جنوب لبنان) في العام 1947، عرفته في منتصف ستينيات القرن العشرين، كان مشغولا بهموم الوطن العربي وبلغته. في نتاج حياته عشرات الكتب والأبحاث والمعاجم المتعلقة بعلوم اللغة العربية، كذلك كانت هموم رفيقة حياته، شريكته خديجة أبو ضهر مرآة حياته، وشريكته في بعض ما أنتجه من أعمال خصوصًا اللغة العربية.لم يكن عصام نور الدين بعيدًا من سيبويه، وإن كان تلميذًا لبطرس البستاني، ومعاصرًا لعبد الله العلايلي، ومتبنيًا لفكره. فمن كان يزوره في بيته في بيروت قبل أن ينتقل للعيش في فرنسا، يرى جميع من أبدعوا وأرّخوا للغة العربية، كلهم كانوا أصدقاءه... فلم أذهب مرةً إلى منزله إلا ورأيته يحاور عالمًا من علماء اللغة، سواء أكانوا من القدامى أم المعاصرين، كان عصام يحاكي القدامى منهم والمعاصرين، يحاور القدماء بلغتهم حينًا، وبلغة عصره في معظم الأحيان؛ ففي قاموسه اللغوي (قاموس نور الدين) كان قد لخّص في صفحاته الألفين ويزيد، خلاصة ما أنتجه جميع من أرّخوا للغة العربية من القدماء والمعاصرين، وساهموا بدور فاعل في عصرنة اللغة العربية. لقد عاش عصام معهم كواحدٍ منهم. نعم، عايشهم وعاش معهم وبينهم، كأنه عاش مع كلّ واحد منهم، كأنه واحد من جيلهم، وإن تعددت صلاته بأجيال عصره، فهؤلاء العلماء كانوا من عائلته، كانوا واحدًا في عصام، يحاورونه ويتحاور معهم، يعيشون معه في كل زاوية من زوايا بيته.انشغل عصام بهموم الوطن العربي، انفصل عن التقليد والسلفية ليلتصق ويعبّر عن ثقافة عصره والعلوم التي تلبي حاجات مجتمعه، لقد حاكى عصام اللغة التي أبدع بها طه حسين ومحمد حسين هيكل والزيات، ولم يكن بعيدًا من جابر عصفور، فضلا عن مزاملته لعبد القادر الفاسي الفهري، هذا الذي استكمل ولم ينفصل عمّا قدمه المعلم بطرس البستاني، وعمّا قدمه عبد الله العلايلي، وصولا لما استكمله من دروس علماء عرب من أمثال: اللبناني عفيف دمشقية، والجزائريان عبد المالك مرتاض ومحمد العربي ولد خليفة، والسوريان عمر الدقاق وعدنان الخطيب، والسعودي عبد العزيز الحربي، والمصري كمال بشر... من دون نسيان السوري زكي الأرسوزي والمصري شوقي ضيف... فعصام نور الدين لم يزامل الكثيرين ممن تعرف إليهم وكانوا معه وبين رفوف مكتبته فحسب، بل كان واحدًا من عائلاتهم، وواحدًا منهم.عصام ذكرياتنا معًا لن تنضب، فثمة تاريخ من العلاقة بيننا يا عصام، وبالجوار جيران شكّلوا قيمًا وأمثلة في مجتمعهم الصغير والكبير؛ فجارك الشامخ الدكتور خليل أحمد خليل الذي كان ولا يزال واحدًا ممن تعلم جيلنا منه. قلما في زياراتي التي لم تنقطع، إلى منزلك في بيروت، لم أجد الصديق خليل إلا محاورًا وأستاذًا موسوعيًّا وتلميذًا للكبير كمال جنبلاط؛ لم يكن خليل صديقًا فحسب، بل كان مدرسة مثلك، نهل منها آلاف الجامعيين وطلاب العلم في العالم العربي وفي خارجه، فمؤلفات خليل وترجماته التي تجاوزت مئة عمل فكري وعلمي وأدبي وفني، كما تعلم يا صديق عصام، ستبقى شاهدة على تاريخه، وهو من الأعلام العرب الذين بنوا تراثًا ستنهل منه أجيال وأجيال... كذلك لن أنسى جارك وابن شقيقتك الطبيب والفنان مصطفى جرادي الذي ترك ولا يزال، بصمة إنسانية عند الآلاف ممن ساهم في معالجتهم وتضميد جراحهم. هذا الطبيب المبدع الذي لم يترك بصمة في عمله الإنساني كطبيب فحسب، بل ترك بصمة في ما قدمه من أعمال فنية خلد فيها أناسًا أضافوا بما قدموه، إبداعات جلية للأجيال، كما خلّد جرادي في لوحاته أمكنة كانت ستبقى مجهولة، وخلّد أحداثًا وأشخاصًا سيستعين بها المؤرخون لتوثيق ما سيكتبونه عن الزمن الذي نعيش فيه...عصام أنت لا تزال، وإن ابتعدت، تعيش بيننا، بين عشرات الآلاف ممن عرفوك، سواء أكانوا طلابًا أم مثقفين أم الجيران.عصام الذي ترك بلده لبنان إلى فرنسا منذ سنوات، في الأحاديث الأخيرة معه عن أحداث غزة، تحدث عن مفهوم الدولة، وكيف يطبّق في الغرب، وعن مفهوم الدولة الشرقية (الذي أسماها سابقًا، كل من: أحمد صادق سعد وسمير أمين، الدولة الخراجية أو دولة النمط الأسيوي للإنتاج).قال لي عصام ونحن نتحدث عمّا يمارسه الكيان الصهيوني في غزة: الدول الغربية الاستعمارية حينما تتعامل مع العرب والمسلمين، تتعامل معهم بعقلية فوقية، أي كشعوب لا تزال تعيش في ظل أنظمة اقطاعية.قلت له: هذا هو واقع الثقافة الغربية الاستعمارية التي فرضت على شعوبنا بعد الحرب العالمية الأولى، النظام الملّي العثماني المستمر إلى اليوم. نعم شعوبنا لم ترتق لتأسيس دولة القانون، فمثلًا عندما يكون دين الدولة الإسلام، فان بقية مكوّنات الشعوب العربية، ستشعر أنها تعيش كما عاش أجدادهم، في ظل نظام مماثل لنظام أهل الذمة. إن ما يميز الغرب هو أنه فصل الدين عن الشأن المجتمعي، لكن هذا الغرب لا يزال يرى ضمنيًا، أن الصراع بين الشرق والغرب هو صراع بين المسيحية والإسلام، وبالتالي لم يتخلص هذا الغرب، من عقدة أن المسلمين في العصور السابقة، سيطروا على عدد من البلدان الغربية، وكان ردّ فعله التاريخي، إطلاق الحروب الصليبية. يا صديقي عصام، تلك العقدة لا تزال تعيشها شعوب مسيحية في الغرب، وإسلامية في الشرق... وهذه العقدة يوظفها النظام الرأسمالي في العصر الحديث، لبقاء سيطرته الاستعمارية وترسيخ نفوذه، وهي التي تحكم نظرته لنا ونظرتنا له.عصام نور الدين يا صديق العمر، ها أنت تذهب إلى عائلة جديدة، إلى جيران جدد، الجيران الذين عشت معهم ابتعدوا عنك... اشتقت يا عصام إلى جارك عبد الله العلايلي، كما اشتقت إلى البعيد القريب، أنستاس ماري الكرملي، وخاصة إلى بطرس البستاني الذي سبقك في فتح الآفاق للتلاقح بين الفكر التنويري الغربي والعربي.عصام صديق العمر والأيام الصعبة ذكرياتنا معًا لن تنضب، أنت لا تزال، وإن ابتعدت، تعيش بيننا؛ فإن تركتنا إلى مكان آخر، أنت معنا طالما حيينا، لقد تركت عائلة هي أيضًا تتابع طريقك؛ زوجتك خديجة شريكة حياتك، وشريكة نضالك الفكري والأدبي واللغوي، كذلك تركت شبابًا منك واعدين، هم من يكملون ويستكملون، ضمن اختصاصاتهم، الطريق الذي رسمته: عدي وتمّام ووائل، لكل منهم وظيفته في المجتمع، بل في مجتمعات غربية لا تزال تميز؛ إذ تقول بحقوق الإنسان وتمارس عكس ما تقوله تمامًا للأسف.عصام نور الدين تغيب عنّا لنرجع ونلتقي سواء كنت هنا أو هناك، تغمدك الله بواسع رحمته، وصبّر عائلتك وأحباءك، وطلابك الكثر في لبنان والعالم.
فرحان صالح
رئيس تحرير مجلة الحداثة – وأمين عام حلقة الحوار الثقافي في لبنان
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on December 15, 2023 13:59
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
November 17, 2023
مجلة الحداثة: الفكاهة الرقميّة والواقع اللبناني اجتماعيًّا وتربويًّا ونفسيًّا - أبحاث في التنمية والأدب والفن والتعليم والتاريخ والجغرافيا
مجلة الحداثة

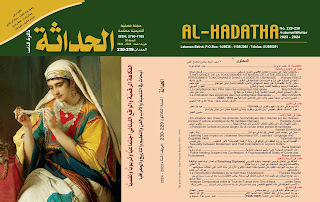
صدر العدد الجديد من مجلة الحداثة (al Hadatha journal – فصلية أكاديمية محكّمة - ISSN:2790-1785) تحت عنوان:
مجلة الحداثة: الفكاهة الرقميّة والواقع اللبناني اجتماعيًّا وتربويًّا ونفسيًّا
أبحاث في التنمية والأدب والفن والتعليم والتاريخ والجغرافيا
استهل العدد الجديد (خريف/شتاء 2023 - 2024، عدد 229/230) بافتتاحية للباحث اللبناني الدكتور جان عبدالله توما، تحت عنوان: إنّه عصر الرواية.وضم العدد الجديد عددًا من الملفات والدراسات والأبحاث الأكاديمية. وهي:
♦ ملف: في الاجتماع والتنمية- ملاحظات أوليّة على مشروع التكامل الإقليمي الشرق أوسطي - فرحان صالح- L’INFLUENCE DE LA TOXICOMANIE AU NIVEAU DE LA VIE SOCIALE DES PERSONNES TOXICOMANES DANS LA SOCIETE LIBANAISE - Richard RBEIZ- العوامل المؤثرة على توزّع المؤسسات الصّناعيّة في البقاع - طارق مشيك- تأثير الأزمة الاقتصادية على النمط الاستهلاكي للأسرة اللبنانية (شمال لبنان نموذجًا) - عليّه ملحم- الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (نموذج لبنان) - أنطوان الدويهي- La compétence des PRH dans les entreprises libanaises - May KANAAN- نظرة المجتمع اللبناني للصّحة النّفسيّة (نماذج مختارة من البقاع) - تمام علي منذر- La motivation des employés dans les entreprises libanaises - May KANAAN- التوسع العمراني لمدينة يايجي وأثره على الأراضي الزراعية بين 1970 و2020 - طارق سليمان مشيك - جمعة غازي طه النعيمي
♦ ملف: في الفنون- السينوغرافي مخرجًا: مفهوم فكري أم وظيفة فنيّة؟ - عبد الله العابر- حوار "مائيَّات المنظر الطبيعي" بين الشرق والغرب (نماذج تشكيليّة مختارة من لبنان وفرنسا) - مأمون النجّار
♦ ملف: في اللغة والأدب- En situation des crises, les énoncés humoristiques des Libanais sur les réseaux sociaux (Lecture analytique de 50 modèles libanais) - Paulette Ayoub- معجم الطّبيعة وأثره في تنظيم الخطاب الشّعريّ لدى صلاح ستيتيّة - يعقوب شبلي- «Portrait de l’artiste en jeune singe» ou le roman entre poésie et symboles - Samah DAAKOUR- لبنان في زجليات أنيس الفغالي (قراءة في ديوانه) - زينة زغيب-Learning Loss Impact on Lebanese Secondary EFL Learners’ Language and Cognitive Skills - Fatemah Bazzi- القضايا العربية ورؤيا المثقف إلى الواقع في رواية "رقصة الفيلسوف" لأنور الخطيب - جنى قبيسي- Sexuality between Modernism and Post Colonialism in Joyce's Dubliners - Rana Salloom- آثار التّحوّلات السّياسة على أساليب درويش الشّعرية - زوات زكريا- Police Healing Suspect into Confession: A Psychoanalytical Study of Crime and Punishment - Rana Salloom
♦ ملف: في التربية والتعليم- العلاقة بين التحاق خريجي الجامعات بدبلوم التدريس (Teaching Diploma) وتحسّن أوضاعهم الوظيفيّة والاقتصاديّة (خريجو الجامعات في لبنان - دراسة حالة) - لارا الحلبي- أثر ممارسة الهوايات الفنِّيَّة على تحصيل طلبة الصفِّ الثانويِّ الأوَّل في مادَّة الأدب على اختلاف مستوياتهم واهتماماتهم - جوزف أبي هاشم- La construction identitaire ou le Self chez l’Adolescent - Thérèse Hlayhel- دور لوائح البيانات في تقويم أداء المعلّم والمُتعلّم في مرحلة رياض الأطفال (دراسة حالة في مدرسة رسميّة في جبل لبنان) - سيلفا صادق- Analyse Comparative entre le Tour de France et le Giro d'Italia - Joelle Daou- الأسس المعرفيّة في بناء المنهج التعليميّ (تعليم اللغة العربيّة في المرحلة الأساسيّة في لبنان أنموذجًا) - سلمى يزبك
♦ ملف: في التاريخ- إبراهيم هنانو: قائد ثوري... وزعيم سياسي - ميسون الجمال- بيروت المحروسة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني - رافع عبد المجيد- أوضاع مصر من النكبة حتى النكسة (1948-1967) - عمار حسن عواد حسيناوي
♦ مراجعات: "العلماء الموحدون في القرن العشرين: إسهامات نهضوية"- كامل صالح
♦ نوافذ: حجر المقامات – نصوص - فرات إسبر
♦ غياب: غاب طلال سلمان وبقيت الأسطورة - أسرة الحداثة
الحداثة (Al-Hadatha)
مجلة فصليّة أكاديميّة محكّمة
ISSN: 2790-1785
السنة 30
خريف/شتاء 2023/2024
العددان 229 - 230
NO. 229 – 230
Autumn - Winter
2023/2024
شرح الصورة
The pearl necklace – Jean-François Portaels (1818 – 1895)
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

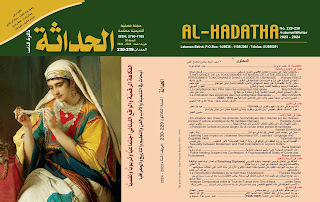
صدر العدد الجديد من مجلة الحداثة (al Hadatha journal – فصلية أكاديمية محكّمة - ISSN:2790-1785) تحت عنوان:
مجلة الحداثة: الفكاهة الرقميّة والواقع اللبناني اجتماعيًّا وتربويًّا ونفسيًّا
أبحاث في التنمية والأدب والفن والتعليم والتاريخ والجغرافيا
استهل العدد الجديد (خريف/شتاء 2023 - 2024، عدد 229/230) بافتتاحية للباحث اللبناني الدكتور جان عبدالله توما، تحت عنوان: إنّه عصر الرواية.وضم العدد الجديد عددًا من الملفات والدراسات والأبحاث الأكاديمية. وهي:
♦ ملف: في الاجتماع والتنمية- ملاحظات أوليّة على مشروع التكامل الإقليمي الشرق أوسطي - فرحان صالح- L’INFLUENCE DE LA TOXICOMANIE AU NIVEAU DE LA VIE SOCIALE DES PERSONNES TOXICOMANES DANS LA SOCIETE LIBANAISE - Richard RBEIZ- العوامل المؤثرة على توزّع المؤسسات الصّناعيّة في البقاع - طارق مشيك- تأثير الأزمة الاقتصادية على النمط الاستهلاكي للأسرة اللبنانية (شمال لبنان نموذجًا) - عليّه ملحم- الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (نموذج لبنان) - أنطوان الدويهي- La compétence des PRH dans les entreprises libanaises - May KANAAN- نظرة المجتمع اللبناني للصّحة النّفسيّة (نماذج مختارة من البقاع) - تمام علي منذر- La motivation des employés dans les entreprises libanaises - May KANAAN- التوسع العمراني لمدينة يايجي وأثره على الأراضي الزراعية بين 1970 و2020 - طارق سليمان مشيك - جمعة غازي طه النعيمي
♦ ملف: في الفنون- السينوغرافي مخرجًا: مفهوم فكري أم وظيفة فنيّة؟ - عبد الله العابر- حوار "مائيَّات المنظر الطبيعي" بين الشرق والغرب (نماذج تشكيليّة مختارة من لبنان وفرنسا) - مأمون النجّار
♦ ملف: في اللغة والأدب- En situation des crises, les énoncés humoristiques des Libanais sur les réseaux sociaux (Lecture analytique de 50 modèles libanais) - Paulette Ayoub- معجم الطّبيعة وأثره في تنظيم الخطاب الشّعريّ لدى صلاح ستيتيّة - يعقوب شبلي- «Portrait de l’artiste en jeune singe» ou le roman entre poésie et symboles - Samah DAAKOUR- لبنان في زجليات أنيس الفغالي (قراءة في ديوانه) - زينة زغيب-Learning Loss Impact on Lebanese Secondary EFL Learners’ Language and Cognitive Skills - Fatemah Bazzi- القضايا العربية ورؤيا المثقف إلى الواقع في رواية "رقصة الفيلسوف" لأنور الخطيب - جنى قبيسي- Sexuality between Modernism and Post Colonialism in Joyce's Dubliners - Rana Salloom- آثار التّحوّلات السّياسة على أساليب درويش الشّعرية - زوات زكريا- Police Healing Suspect into Confession: A Psychoanalytical Study of Crime and Punishment - Rana Salloom
♦ ملف: في التربية والتعليم- العلاقة بين التحاق خريجي الجامعات بدبلوم التدريس (Teaching Diploma) وتحسّن أوضاعهم الوظيفيّة والاقتصاديّة (خريجو الجامعات في لبنان - دراسة حالة) - لارا الحلبي- أثر ممارسة الهوايات الفنِّيَّة على تحصيل طلبة الصفِّ الثانويِّ الأوَّل في مادَّة الأدب على اختلاف مستوياتهم واهتماماتهم - جوزف أبي هاشم- La construction identitaire ou le Self chez l’Adolescent - Thérèse Hlayhel- دور لوائح البيانات في تقويم أداء المعلّم والمُتعلّم في مرحلة رياض الأطفال (دراسة حالة في مدرسة رسميّة في جبل لبنان) - سيلفا صادق- Analyse Comparative entre le Tour de France et le Giro d'Italia - Joelle Daou- الأسس المعرفيّة في بناء المنهج التعليميّ (تعليم اللغة العربيّة في المرحلة الأساسيّة في لبنان أنموذجًا) - سلمى يزبك
♦ ملف: في التاريخ- إبراهيم هنانو: قائد ثوري... وزعيم سياسي - ميسون الجمال- بيروت المحروسة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني - رافع عبد المجيد- أوضاع مصر من النكبة حتى النكسة (1948-1967) - عمار حسن عواد حسيناوي
♦ مراجعات: "العلماء الموحدون في القرن العشرين: إسهامات نهضوية"- كامل صالح
♦ نوافذ: حجر المقامات – نصوص - فرات إسبر
♦ غياب: غاب طلال سلمان وبقيت الأسطورة - أسرة الحداثة
الحداثة (Al-Hadatha)
مجلة فصليّة أكاديميّة محكّمة
ISSN: 2790-1785
السنة 30
خريف/شتاء 2023/2024
العددان 229 - 230
NO. 229 – 230
Autumn - Winter
2023/2024
شرح الصورة
The pearl necklace – Jean-François Portaels (1818 – 1895)
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 17, 2023 07:34
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
November 16, 2023
L’INFLUENCE DE LA TOXICOMANIE AU NIVEAU DE LA VIE SOCIALE DES PERSONNES TOXICOMANES DANS LA SOCIETE LIBANAISE

Richard Emil RBEIZ *
- نبذة عن البحث باللغة العربية:
تأثير الإدمان على الحياة الاجتماعية للشخص المدمن
في المجتمع اللبناني
يعدّ الانحراف خطيرًا في كلّ المجتمعات، لأنه يؤدي إلى عدم احترام القيم، والعادات، والثوابت الاجتماعية. ويلحظ أن كلّ مجتمع يسنّ القوانين بهدف التمييز بين الشخص المنحرف والشخص الذي ينخرط بمجتمعه بشكل ايجابي وفعّال.تعالج هذه الدراسة تأثير الإدمان الذي يعدّ نوعًا من أنواع الانحراف على الحياة الاجتماعية للشخص المدمن، وذلك عبر حالات محددة أُخذت من المجتمع اللبناني وتحديدًا من "جمعية أم النور". فقد أجرينا مقابلات مع أشخاص قرروا التوقف عن الادمان من خلال اتباع برنامج علاج صحي واجتماعي ونفسي في "جمعية أم النور" التي نجحت منذ عشرات السنين بعلاج عدد كبير من المدمنين الذين استطاعوا بفضل الاختصاصيين في هذه الجمعية، من التخلص من الادمان وإعادة الانخراط في مجتمعهم اللبناني.توصل هذا البحث الاجتماعي إلى أن الادمان يحدث تغيرات جذرية في حياة المدمن الاجتماعية، ويؤدي إلى البطالة، والعزلة الاجتماعية، والسرقة، والعنف، وعدم الانخراط في المجتمع، والطلاق أو الاضطراب في العلاقات الزوجية، وتهديد استمرارية العلاقات الاجتماعية، والتهميش الاجتماعي، وفقدان الثقة بالشخص المدمن.
- الكلمات المفاتيح: الادمان، الانحراف، المجتمع اللبناني، انهيار الروابط الاجتماعية، الفئات الاجتماعية، منظمة غير حكومية
***
- RESUME: Dans toute société, les normes et les valeurs sociales sont utiles pour distinguer entre les agents sociaux qui sont déviants et ceux qui ne le sont pas. Elles sont indispensables pour sanctionner négativement toute action déviante ou inacceptable de point de vue culturel.Notre enquête sociologique vise à étudier l’impact et l’influence de la toxicomanie, qui est une forme de la déviance, au niveau de la vie sociale des personnes toxicomanes dans la société libanaise. Dans le cadre de notre étude, des entretiens ont été réalisés, dans l’organisation non gouvernementale «OUM EL NOUR», avec des personnes qui étaient toxicomanes et qui ont décidé de mettre fin à la consommation de la drogue grâce à l’aide des agents spécialisés, de cette association à but non lucratif, qui visent la réhabilitation et la réintégration de ces agents sociaux toxidépendants.Suite à notre étude, nous constatons que la toxicomanie cause une «rupture biographique», c’est-à-dire la vie sociale des personnes toxicomanes n’ est pas de tout la même après leur consommation régulière et excessive des différents types de drogues. Nous déduisons que la toxicomanie a bouleversé la vie sociale de ces individus tout en introduisant des mutations désavantageuses et nuisibles: exclusion sociale, isolement, marginalisation, stigmatisation, rejet, critiques, manque de confiance et rupture relationnelle.La solidarité sociale, qui se concrétise à travers l’existence des agents sociaux comme les membres de l’organisation «OUM EL NOUR», sauve ces personnes qui décident de mettre fin à leur toxicomanie afin de revivre une vie sociale normale qui se conforme à toutes les règles et les principes sociaux.
Mots-clés: Toxicomanie, Toxidépendance, Déviance, Culture, Valeurs, Traditions, Exclusion sociale, Rupture biographique, Intégration sociale, Rupture des liens sociaux, Groupes sociaux, Organisation non gouvernementale
***
* د. ريشار اميل ربيز: باحث لبناني – حائز شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية. أستاذ محاضر في معهد العلوم الاجتماعية - الجامعة اللبنانية منذ العام 2016، وفي جامعة القديس يوسف منذ العام 2000. رئيس قسم الابستمولوجيا والمنهجية والتقنيات في معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الثاني) - الجامعة اللبنانية.
* Richard Emil RBEIZ: Docteur en Sciences sociales. Chercheur dans le domaine de la Sociologie. Enseignant à l'Université libanaise depuis l'année 2016. Enseignant à l'Université Saint Joseph depuis l'année 2000. Chef de département de méthodologie, d'épistémologie et des techniques à l'Institut des Sciences Sociales II à Rabieh.
BIBLIOGRAPHIE
1. Dictionnaire de la sociologie, sous la direction de Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, Larousse, Paris, 1993.2. http://etablissement.org3. http://fr.m.wikipedia.org4. H. Mendras, Elément de sociologie, Armand Colin, Paris, 2013.5. B. CHEVALIER, I. MARTINACHE, Déviances et contrôle social, Bréal, 20176. L. MUCCHIELLI, Sociologie de la délinquance, Armand Colin, Paris, 20147. E. GOFFMAN, Stigma: Notes on the management of Spoiled Identity, Penguin, London,1963 (traduction française: Stigmates, les usages sociaux du handicap, Paris, les éditionsde Minuit, 1975).8. E. GOFFMAN, Asylums, Dloubleday Company, London, 1961, (traduction française, Asiles,études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus, Paris; Minuit, 1968)9. H. BECKER, Outsiders, Etudes de la sociologie de la déviance, The Free Press of Glencoe,1963, traduit sous ce même titre aux Editions METAILIE, Paris, 1985.10. M. CUSSON, Déviance, in Traité de sociologie (R. BOUDON), PUF, Paris, 199211. P. ADAM et C. HERZLICH, Sociologie de la maladie et de la médecine, Armand Colin, Paris,2016.12. Raynald PINEAULT, Comprendre le système de santé pour mieux le gérer, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2012, p.22.13. M. BURY, «Chronic illness as biographical disruption», Sociology of Health and Illness,4, 198214. N. BERTHIER, Les techniques d’enquête en sciences sociales, Armand Colin, Paris, 201615. L. VAN CAMPENHOUDT, J. MARQUET, R. QUIVY, Manuel de recherche en sciences sociales,DUNOD
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on November 16, 2023 22:07
November 15, 2023
مراجعات: ملاحظات أولية على مشروع التكامل الإقليمي الشرق أوسطي

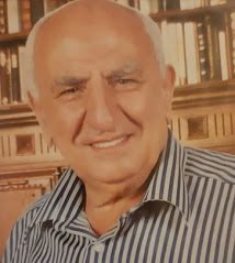
فرحان صالح *
قرأت خلاصة مشروع المشاركين في "منتدى التكامل الإقليمي الشرق أوسطي"[1] الذي يحتوي على مقدمة طويلة، ومن ثم تقديم دراسة عن الذكاء الاصطناعي. وقد أرسله لي الباحث اللبناني سعد محيو. ما يعنيني، هو ما ورد في المقدمة التي تبدأ بإعطاء جرعة من التفاؤل حين يشار إلى أن "النظام الدولي (والمقصود بالنظام الرأسمالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية) يمرّ بمرحلة تاريخية كبرى قوامها نزوله عن عرش الزعامة"، وهناك ملامح "لنشوء نظام عالمي جديد بتعدد الحضارات"، و"فرصة التقدم عند شعوب المنطقة مرهونة برفدها بجهود ذاتية من جانب أركان "الحضارة الإسلامية"(!)، وأن المشرق المتوسطي بزعامة تركيا وإيران والعرب والاكراد، ومن ثم أندونيسيا وماليزيا والهند الإسلامية (!) وباكستان، هم من على شعوبهم النهوض بهذه الحضارة. ودون ذلك ستبقى مكوّنات الحضارة الإسلامية(!) كالرجل المريض الذي يجب فرض الحجر الصحي عليه، وتقاسم مناطقه وأدواره وموارده بين القوى الكبرى الجديدة".يلحظ "المشروع" أيضًا أن "حضارة الإقليم تمثّل وحدة جغرافية متكاملة" (!) مع الإشارة إلى خطورة التطرف الديني الفاشي والقبلي والعشائري، حيث تسعى "قوى دولية إلى إعادة رسم الخرائط السياسية للإقليم بدموية فظيعة تضمن انخراط الجميع ضد الجميع"، من ضمن هذا الواقع "علينا أن نستولد الحلم"، وأن "الحضارات الأسيوية لم تتغربن تمامًا، ولم تتبدد، فالحضارات الشرقية تلج كليًّا الحداثة دون أن تتغربن إلا جزئيًّا"، وهذا ما عبر عنه رئيس وزراء ماليزيا السابق "مهاتير بن محمد، حين قال: إننا حديثون لكننا لا نريد أن نصبح غربيين". وهنا يشيد مصيغو البيان "بالسقوط المجلجل والنهائي للفكر الكمالي الأتاتوركي الداعي إلى حلّ الحضارة الإسلامية، والاندماج الكلّي في الغرب". وفي هذه الإشارة علامة استفهام كبيرة: فهل مصيغو المشروع يرفضون خيار فصل الدين عن السياسة الذي أخذ به أول رئيس للجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك (1881 – 1938)؟ينتهي البيان بالدعوة إلى "الحوار باعتباره المنقذ الوحيد من ظلال الانتحار الجماعي"، وإلى حثّ "النخب العقلانية في الإقليم على وضع نموذج فكري حضاري جديد، يدير ظهره للتعصب القومي والديني"، وينشد إلى "الروحانية الحضارية الإسلامية، والتكامل الجيوسياسي بين دول الإقليم"، وباكستان ونيجيريا، ناهيك بين مسلمي الهند ومسلمي السعودية، والهدف "لإنقاذ البيئة المتوسطية من المهالك الموجودة".
- حضارة إسلامية أم حضارة عربية؟
حين قراءة المشروع الشرق أوسطي المقدم من مجموعة من المثقفين اللبنانيين والعرب، يمكن النظر إليه في الظاهر، بحسبانه دعوة لتجاوز ونقد هذه السكينة التي تعرفها شعوبنا، إلى حدّ وصول مجتمعاتنا إلى التكيف مع كل المستجدات السلبية الدولية. وفي المشروع هناك العديد من المحطات الإيجابية التي أُشير إليها، وهناك ما يمكن مناقشته والتحاور حوله، لتوضيح الحاجة إليه، ولتبيان المقصود من طرحه.في الظاهر يلحظ أن الوجه الأساسي الذي يحاول أصحاب المشروع، ترويجه، وجعله حافزًا للاهتمام، هو أنهم وضعوا غطاءً جعلوا من "الحضارة الإسلامية" حاضنة لتاريخه ولمستقبله. لكن حين العودة إلى معطيات المشكلة لهذه الحضارة، يرى المتابع، أن الغطاء التاريخي (لهذا المشروع) لم يوضع في المكان المناسب. لهذا ترانا نعود إلى هذا التاريخ لنقرأه مجددًا؛ فحين نعيد رسم صورة أولية للمنطقة التي ولد فيها المشروع المحمدي، يُسجّل أنه ولد في حضن الصراعات الطاحنة بين المسيحيين الذين بعد "مجمع نيقية"[2] انقسموا قسمين، ومنذ ما بعد هذا المجمع، اشتدت الصراعات بين من يعدّون أن المسيح إلهٌ (أخذ بهذا الاتجاه بابا الإسكندرية الكسندروس الأول والقديس أثناسيوس الرسولي)، ومن يعدّونه نبيًّا (حمل هذا الاتجاه الراهب الإسكندراني آريوس).وحين المتابعة للمجريات التاريخية التي حصلت ما بين القرنين: الخامس والسابع، يلحظ ازدهار الحضارة الفارسية، ومن أسباب ازدهارها استمرارية الحروب ببن أصحاب العقيدتين المسيحيتين. أما الرسول محمد، كما يروي الراهب يوحنا الدمشقي (675 - 749م) كان عربيًّا، ويزعم أنه من "أتباع العقيدة الآريوسية". لكنه أمام شدة الانقسامات والصراعات وخطورتها، تكوّنت لديه ولدى نخبة من جيله، ثقافة منحازة لأبناء قومه؛ فبدأ يؤسس لمواجهة تهدف إلى التخلص من مسببي هذه الحروب، فأعلن ثورته، ولم تكن العقيدة التي يؤمن بها، سوى الدافع، فكان أن طوّع عقيدته لخدمة مشروعه، فعقد الأحلاف بين المهاجرين والأنصار (أي بين التيارين المسيحيين المتخاصمين)، ونادى بإله أكبر من جميع آلهة القبائل المنتشرة في المعابد.كانت توجهات رسول الإسلام ليست ضد الوثنيين، بل ضد الحكّام البيزنطيين والفرس والروم الذين يسيطرون، ويضيقون على السكان (رعيتهم) بأبشع أنواع الظلم. فانطلقت الثورة المحمدية لإنهاء الظلم، ونشر العدل الإلهي، معبّرةً عن الحاجات الأمنية والمعيشية والتحررية للعرب المحكومين من قوى غريبة عنهم ولا تمثلهم أو تمثل مصالحهم. توالت هزائم الحكّام البيزنطيين والرومان، فضلًا عن الفرس الذين كانوا يحتضنون أصحاب العقيدة الموسوية، وهم ضالتهم لتوسيع نفوذهم ضد أخصامهم من الرومان والبيزنطيين.في هذه المناخات إذًا، ولد المشروع المحمدي؛ فقام الرسول بتوحيد القبائل العربية، والعمل على توحيد التيارين المسيحيين، ولم يكن أصحاب العقيدة اليهودية بعيدين من ذلك، بل كانوا في صلب الحدث، بل ويقال إنهم كانوا من قوّاد هذا المشروع، فخاضوا حروبًا قاسية لتحرير القدس وغيرها من بلدان.أدت هذه الانتصارات إلى تأسيس منحى حضاري جديد ركيزته "الإسلام" (يعتقد بعض المؤرخين أن مصطلح الإسلام، لم يكن مذكورًا قبل العصر العباسي)، لكن في العمق والواقع، كانت ركيزته وقاعدته عربية، ولغة من قاموا بهذه الثورة "اللغة العربية السريانية". أما الأمويون الذين يبدو أنهم آمنوا بـ"ألوهية المسيح" وكانت دمشق قاعدتهم، فقد عقد الرسول (بزعم الدمشقي أنه كان من أتباع العقيدة الآريوسية) حلفًا ومؤاخاة معهم. هذا الحلف الذي شمل معظم القبائل العربية "في مصر والمشرق العربي والبلدان المغاربية"، جاء تحت شعار "الله أكبر"؛ والمقصود الله الذي هو أكبر من كل الأوثان القبلية التي قيل إن عددها 365 قبيلة، وإله السموات والأرض.قد تكون هذه هي الأيديولوجية التي حملتها النواة العربية الأولى التي قامت بالثورة المحمدية وغيرت وجه العالم، واستمر حكمها حتى بدايات القرن الحادي عشر، حيث بدأت الخلافة العباسية تتراجع وتتفتت وتتجوّف من داخلها.هذه الثورة التي يقال إنها انطلقت بنواة من القيادات "المسيحية اليهودية"، توسع حضور المشاركين فيها من غير العرب، وهم من أطلقوا عليها تسمية "حضارة إسلامية"، والسبب لأنهم بهذه التسمية، يوجدون مكانًا لهم داخلها. لقد رسم الفقهاء العباسيون في ما بعد القرن العاشر، تاريخًا ليس له علاقة بتاريخ المرحلة الممتدة من القرن السابع إلى القرن العاشر، تاريخًا صاغه الفقهاء الآريوسيون في العراق.بعد هذا التوضيح، يمكننا العودة للدخول في الحوار والنقاش في المشروع المقدم تحت عنوان: مشروع التكامل الاقتصادي الإقليمي".
- هل المشروع مناسب للعالم العربي؟
لنبدأ الحوار مع ما ورد في المشروع من "المهالك والعقبات التي تحول دون تقدم الشعوب..."، ونتساءل: هل العنوان الحاضن لهذا المشروع (الحضارة الإسلامية) هو العنوان المناسب؟ أليس الإيرانيون ما زالوا يتغنون بالحضارة الفارسية، والهنود بالحضارة الهندية، والصينيون بالحضارة الصينية؟ أليس هذه الدعوة تلغي هويات الشعوب، حيث لكل شعب تجاربه التاريخية، وهويته التي تعبر عن خصوصيات هذه المجتمعات؟ أليست هذه التسمية لها انعكاسات سلبية على نجاح هذا المشروع، بل إنها تعود بنا لتبني الثقافة اللاهوتية الدينية بدلا من العقلانية التي بشّر بها الفيلسوف ابن رشد (1126 - 1198م)، وجعلها مرشدًا له في ما كتبه؟ وهكذا هي "المهالك" بتعدديتها، أليست هي نتاج شبكة العلاقات التي اخترق بها النظام الرأسمالي العالمين العربي "والإسلامي"، والمستمرة منذ القرن السادس عشر إلى اليوم؟أليس عبر هذه التراكمات الثقافية السلبية المتنوعة، تم تجويف وتغريب العقول العربية وتدجينها؟لقد برزت قوى تقارن بين ما أنتجه الغرب، وما قدمه للحضارة الإنسانية، وبين المعجزات التي بموجبها انتصر الإسلام وحقق أهدافه، هذه المقارنة العربية لم تكن كما رسمت في الغرب أي بين المصنع والكنيسة وبين النظام الاقطاعي والنظام الجمهوري، بين التشريعات المدنية والتشريعات الدينية، بل قارنت الأحزاب الدينية الإسلامية بين منجزات الغرب العلمية والاجتماعية الحضارية، وبين النظام الإسلامي الذي ساد عند نشؤ الإسلام.لقد رسم المشهد في الغرب بانتصار المصنع والعقل البشري، وتجلّى كل ذلك، بفصل الدين عن الشأن العام. لكن في ثقافتنا بشقيها العربي والإسلامي، انتصرت العقلية السلفية الذكورية، وبقي النظام الإسلامي نموذجًا ودليلًا. وشكّل هذا النظام بالنسبة إلى المستعمر قاعدة لبناء المداميك الأساسية لسيطرته؛ فكانت أدواته هي الجماعات الإسلامية، وما تحمله من موروثات، إذ تبنى الإنجليز والفرنسيون النظام الملّي العثماني، وأعادوا نشر التشريعات الإسلامية، وبموجبــــــها تم تقسيم وتقاسم المنطــــقة (وديـــــن الدولة في الدول العربية هو الإسلام).فهل يريد من وضعوا لمشروعهم حاضنة "حضارية إسلامية"، إعادة استحضار هذه التشريعات التي هي من موروثات الحضارة الإسلامية، وخلاصة الأنظمة الإقطاعية التي تجلببت بالدين ولم تسمح بالمساواة بين مكونات شعوبها، ناهيكَ عن التمييز بين المرأة والرجل؟ أليست هذه من المعوقات الأساسية، وعبر استمرارها تستمر (الثقافة الذكورية للعصور الوسطى)، وتستمر الهيمنة الاستعمارية؟ أليست هذه الموروثات هي العدة التي يعيد الاستعمار أخذها واستعمالها لبقاء سيطرته واستمرار نفوذه؟ ولعل الأخطر في المشروع الشرق أوسطي أن من صاغوه، يستبعدون مسبقًا، المكوّنات الاجتماعية غير المسلمة من مسيحيين ويهود وغيرهم من قوى غير متدينة، من المشاركة والتعبير عن رأيهم في مستقبل بلدانهم!نتساءل هنا، وفي حال تجاوزنا وضع فلسطين المحتلة: أليس اليهود والمسيحيون من الرواد المؤسسين لهذه الحضارة المسمات "إسلامية"، أو أنهم دخلاء عليها؟ أليس هذا الانشداد الفكري للماضي، يؤسس لإعادة إحياء الأوهام حول الكثير مما هو متداول، وأصبح جزءًا من بناء ذهنية، منها يتم التعامل مع أمور الحاضر على أن مرجعيتها ماضوية؟ أليست رغبة كاتبي المشروع في إحياء "الحضارة الإسلامية"، رغبه تدعو إلى القلق؟ ولماذا هذه الدعوة اليوم، خاصة إن الولايات المتحدة التي يشير إليها البيان، ويعدّها حضارة تتراجع، هي من تؤسس لمشروع جديد للمنطقة يقوم على إنشاء دين جديد تمت تسميته "الدين الإبراهيمي"؟ فهل يمكن عدّ هذا المشروع بريئًا؛ كونه سيدفع بالآخرين من الديانة اليهودية، للمطالبة بإحياء الحضارة اليهودية، والتبرير لما يدعون إليه بإنشاء "دولة يهودية" في فلسطين؟كذلك ومن ضمن ردود الأفعال المنتظرة: لماذا لا يطالب المسيحيون (أيضًا) بإحياء الحضارة المسيحية؟ فهل ناشرو البيان لا يتوقعون ردود أفعال بهذا الحجم؟ ومن قال إن هذا المشروع يمكن أن تتبناه الشعوب التي ذكرت، وهي ما زالت تميز بين شعوبها على أسس عرقية ودينية، كذلك بين المرأة والرجل، وما زالت تأخذ بموروثات ماضوية في بنائها للسلطة ونظام ولاية الفقيه خير تعبير عن ذلك؟هل الصديق محمد محيو (وسواه ممن أعدّوا المشروع)، يمكنه، وعبر هذه الكوكتيلات من تنوع الأنظمة، تنفيذ هذا المشروع وإحياء الحضارة الإسلامية؟ وهل من يريدون إعادة العثمانية الأردوغانية، يمكن لهم أن يأخذوا بهذا المشروع، وهم من نراهم يتعاملون مع واقع شعوبهم استنادًا إلى ثقافة "تشخصن القضايا"، وبعقلية ثقافية تقليدية أبوية، "رغم أن بعض الدول تنصّ قوانينها على فصل الدين عن السياسة"، كما تركيا التي "ترفض الأردوغانية" والحقوق التاريخية للأكراد؟أليست الشعوب التي تطلقون عليها اسم "الشعوب الإسلامية"، لكلّ منها هويته وتشريعاته وقوانينه؟ مثلًا إذا عدنا إلى الهوية التقليدية للشعوب العربية، فعلى الرغم من أن لغتها عربية، لكن هناك تنوع في اللهجات والعقائد والثقافة للمكوّنات البشرية لكل دولة؛ فلماذا وصف هذه الدول بأنها جزء من العالم الاسلامي؟ أليست هذه الدول جزء من العالم العربي؟ فالعرب مثلًا الذين جمعتهم اللغة والتاريخ والثقافة والجغرافية والتراث والتطلعات المستقبلية، وميزتهم عن غيرهم من الشعوب الأخرى، لماذا لا نعيد المعنى لهويتهم الحضارية؟ وللسبب نفسه، يمكن الحديث عن الشعوب الفارسية، والباكستانية، والهندية، والتركية... ونقف هنا عند الدعوة إلى ضم المسلمين الهنود لهذا المشروع. فهل بهذه الدعوة، يمكن الحوار مع الآخر الهندي؟ وهل هذه الدعوة لا تهدف إلى تفكيك الهند وغيرها من الدول على أسس دينية؟إن الدعوة إلى التعاون والحوار والتنافس بين مكوّنات هذه الشعوب هي دعوة مقدسة. ويأتي تعبير "القداسة" بالمعنى الإنساني لا الديني. نعم، بالتعاون واحترام المصالح المشتركة بين الشعوب، تبني ثقة الشعوب ببعضها البعض وفي المجالات كافة، وبالتعاون والحوار، وليس بالمراهنة على ما هو روحاني "للحضارة الإسلامية". هذه الروحانية التي "تتميز ولا تزال بغلبة الثقافة القبلية العشائرية على ما عداها، بينما "الروحانية الإنسانية تقوم على المساواة بين البشر الذين يهتمون بمقام التربية والسلوك وبتربية النفس".[3] بهذا يتم تجذير بناء الروح الإنسانية بين الشعوب.في المقابل، هل يمكن لأصحاب هذا المشروع، الموافقة على ما تقوم به تركيا وإيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وحتى في فلسطين وقبرص، عبر التعدي على حقوق الغير وباسم الدين؟إن كلّ تلك الممارسات، يكمن في جوهرها، عدم احترام حقوق الآخر. فإيران مثلًا، يلحظ أنها رسمت مشروعًا لمسار اعتقادي، تعود مرجعيته إلى قوانين وتشريعات "ولاية الفقيه"، وتنطلق منه لطرح رؤية جديدة للتاريخ من وجهة نظر دينية صرف، يتغلب فيها المكوّن الشيعي على سواه. واللافت أيضًا، الانتباه لما يحصل في إيران من حركات اعتراضية، ليتبين هذا التمييز الصارخ بين المرأة والرجل، وبين الشعوب الإيرانية وغير الإيرانية.لقد تم تقسيم شعوب المنطقة على أسس عرقية وطائفية... وهذا التقسيم من موروثات كان يُعمل بها في دولة الخلافة، وتم الأخذ بها في المرحلة الاستعمارية التي عرفتها وما زالت تعرفها، الشعوب العربية. فهل بهذا المشروع القائم على التمييز بين السنّة والشيعة وغيرهما، ستبني إيران علاقات جيدة مع محيطها؟ أيضًا، هل من مشروع أنجزته إيران في علاقاتها العربية، يمكن عدّه نموذجًا يحتذى؛ ألم تساهم بإحياء ثقافة "سنّة – شيعة"... وبهذا ذاته تقدم إيران – مباشرة أم غير مباشرة - مبررًا للولايات المتحدة لاستمرار وجودها في المنطقة، بحجة حماية دول الخليج التي تدّعي الولايات المتحدة الأمريكية أن قواعدها موجودة لحمايتهم من "العدو" الإيراني؟إذا لم تكن هذه المهالك هي هذه التي أشرنا إليها، فماذا هي غير ذلك؟
- الديانة الإبراهيمية والمشروع الأمريكي!
إن هذا المشروع الشرق أوسطي الذي يلغي هويات الدول والشعوب (الهوية نتاج جهد ونضال طويل ومستمر)، يقدم هدية مجانية للولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول انشاء الديانة الإبراهيمية، اعتمادًا منها أن أديان المنطقة قد تم استهلاكها، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات الولايات المتحدة في تجذير نفوذها وسيطرتها.الدين الجديد الذي ستعارضه الأجيال القديمة، موجّه للأجيال الجديدة، وهناك اغراءات كثيرة في متنه، ستدفع هذه الأجيال لتبنيه.لذا، وانطلاقًا مما سبق، يلحظ أن مشروع التكامل الإقليمي الشرق أوسطي الذي يهدف لإعادة إحياء الحضارة الإسلامية، يساعد على تفتيت المنطقة إلى هويات، ولن تستفيد منه سوى الولايات المتحدة الأمريكية عبر رسم صورة لهويات دينية، وليس هويات حضارية اجتماعية ثقافية سياسية إنسانية. وتفتيت كل دولة تسعى إلى التطور والتقدم. فالعالم الغربي بشقيه الروسي - الأوروبي الأمريكي، تقدم بفصل الدين عن الشأن العام، بينما الشعوب العربية والإسلامية لا تحمل هوية واحدة، بل هويات؛ فهل يمكن توحيد هوية هذه الشعوب تحت مسمّى الحضارة الإسلامية؟ وقد كان لافتًا للانتباه، اعتبار المشروع أن "حضارة الإقليم تمثّلها وحدة حضارية متكاملة؟". فما يجمع مسلمو الهند مع مسلمي مصر أو تركيا؟يشير المشروع أيضًا إلى القيم التي تتمتع بها الحضارات الأسيوية تلك التي لم تتغربن، فهل النظام العالمي عبر عولمته، أصبح بعيدًا من هذه الدول التي هي خارج مدار جغرافية هذا الكون؟إلى ذلك، من يقرأ بعض الداعين إلى "مشروع نحو شرق أوسط جديد"، يلحظ كأنها تأتي في سياق تكملة مشروع الديانة الإبراهيمية التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنه تكملة لصورة الشرق الأوسط الذي بموجب التسمية، يتم إلغاء الكيانات القومية التاريخية، وإحلال بديلًا منها، كيانات طائفية وعرقية وإثنية، فضلًا عن رسم صورة لشرق أوسط مشكّل من فسيفسائيات دينية متنوعة.إن الصورة التي يرسمها المشروع الأمريكي للمنطقة، تقوم على عزل أصحاب الهويات غير الإسلامية عن حضورهم في التاريخ الإسلامي، وإذا وجدوا، فلهم حضور هامشيّ في تاريخ ومصير بلدانهم، وحينما يصبح هؤلاء تحت عباءة الحضارة الإسلامية، وحينما يصبح دين الدولة هو الإسلام، فمن هاتين التسميتين يتم التمييز والإلحاق، ويصبح معتنقو الأديان الأخرى "أهل ذمة"!السؤال الذي يمكن توجيهه للمنظرين للمشرق المتوسطي الذي تحتضنه "الحضارة الإسلامية" دون سواها: هل تريدون "أسلمة" اليهود والمسيحيين الذين جمعهم تاريخ مشترك وشراكة حياة مع أقرانهم من المسلمين؟ وإذا لم يفعلوا ذلك، هل تعدّونهم "أهل ذمة" أو من المرتدين؟ إذا كان الجواب عن السؤال غير ذلك، فلماذا وضعتم جميع المكوّنات التاريخية للمشرق المتوسطي، في حضن ما أسميتموه "الحضارة الإسلامية"؟ أليس بهذه التسمية، تريدون إعادة أو التذكير بنظام أهل الذمة الذي عرفته الشعوب التي عانت من التبعية لنظام اقطاعي (ديني) مضى إلى غير رجعة، وليس كما تدعون من "عدم وجود واقع لثقافة حضارية إنسانية مكتملة في ذاتها".إن على أي فئة تريد تقديم مشروع جديد، أن تقطع مع هذا الماضي، وأن تزيل الصفة الدينية اللاهوتية عن نفسها، وأن تنظر إلى ذلك التاريخ، تاريخًا لأجيال مضت، والمطلوب مراجعته والاستفادة من تجاربه وليس العودة إليه، ومن دون هذه المراجعة، ستعيش شعوبنا التي انفصلت عن هذا التاريخ، في مراوحه وموت بطيء.
- لماذا مشروع الديانة الإبراهيمية؟
تقدم الباحثة هبة جمال الدين في كتابها الجديد "الديانة الإبراهيمية وصفقة العصر"،[4] تعريفًا بهذا الدين العالمي الذي ينسب لنبي الله إبراهيم، وقد جاء بتعاليمه منذ ثلاثة آلاف سنة، منفصلًا ومبشرًا بدين تبناه وأخذ به الأنبياء: موسى، وعيسى (المسيح/يسوع)، ومحمد. لقد تجاوزت التعاليم الإبراهيمية موروثات العصور الوثنية التي سادت قبل ذلك، لتؤسس للدين التوحيدي (الله أكبر إله السماء والأرض). لذا، فإن الموروث "الإبراهيمي" خلاصة الموروثات التي أخذت بها الديانات السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. وإن كان بعض المتابعين، يعتقدون أن الأسطورة الإبراهيمية الهندية، امتداد لأسطورة إبراهيم الخليل أو العكس.إن من يتابع كيفية ولادة أفكار هذا المشروع، سيقف طويلًا للنظر في العقل الأمريكي الاستعماري وكيف يفكر ويخطط.يمكن القول إن مفهوم "الدولة الإبراهيمية"، ولدت في عقل مواطن أمريكي من أصول عربية مصرية في العام 1990، هو "سيد نصير" الذي كان يطمح للخروج من السجن، لاتهامه بقتل مؤسس "حركة كاخ" والعضو السابق في برلمان "الكيان الإسرائيلي" الحاخام مائير كاهانا (1932 – 1990) داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وللخروج من السجن، سلّم نصير السيدة الأولى السابقة هيلاري كلنتون (Hillary Clinton) هذا المشروع (الوثيقة) الذي أسماه "الاتحاد (أو الدولة) الإبراهيمي".[5] وقد رفعته كلنتون، بحسبانه وثيقة تخدم الأمن الأمريكي، إلى الإدارة الأمريكية، وبعد دراسة وثيقة نصير، تم اعتماده، وتبنيه، وبدأت هذه الإدارة العمل على تنفيذ مضمونه، بدءًا من العام 2000.لكن حين البحث والتدقيق في مضامين هذه الوثيقة، يلحظ أن الأهداف الأساسية لطرحها، سياسية وليس لها علاقة بالدين، بل إن الهدف من نشرها تطويع الأجيال الجديدة على طريقة جديدة للحياة المشتركة بين الأديان. فالمشروع الإبراهيمي هو ضمنيًّا، تكملة لما قدمه كيسنجر (Kissinger/ 1923م)، وبرنارد لويس (Bernard Lewis/ 1916 – 2018م) من مشاريع تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما قدمه سيد نصير تحول من فكر مجرد إلى مشروع واقع. لقد أعطى نصير وثيقة معينة لأصحاب القرار، وتم توظيفها على النطاق السياسي، لتخدم عمليًّا استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم. ظاهريًّا جعل الدين الإبراهيمي طريقًا وحلًا للنزاعات والصراعات السياسية بين اليهود والفلسطينيين، بينما في العمق، للتغطية على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم في العالم. لقد وصف المشروع بأنه سيكون حلًا لمشاكل الشرق الأوسط الدينية، ومن ثم للمشاكل المتماثلة في العالم إذا وجدت. لكنه أيضًا، للهروب من الحلول للمأزق الذي يمرّ بها الصراع العربي الصهيوني. لذا جاء هذا المشروع لمساعدة ما يسمّى "إسرائيل"، ولإخراج النظام الرأسمالي من أزماته.إن مشروع الإبراهيمية الجديدة الذي تطمح الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعميمه وتقديمه، سيرسم فعليًّا صورة لعالم جديد. وعلى الرغم من أن هناك من لم ولن يقبل هذا المشروع من الأجيال المسنّة، إلا إنه موجّه تحديدًا، لمحو ذاكرة الأجيال الجديدة، ويمكن لمن يريد الاطلاع والاستفادة، متابعة ما تحتويه هذه الوثيقة.يطرح "الدين الجديد" مدينة أور العراقية التي انطلقت منها الدعوة الإبراهيمية، مكانًا للحج بديلًا من مكة وبيت لحم والقدس والفاتيكان...، ومنها تبثّ الروح الإبراهيمية الجديدة، عبر الصلاة الجماعية المشتركة التي تجمع الجميع، والجميع عليهم أن يجتمعوا لقراءة مشتركة للكتب السماوية، وصولًا لتكريس العبادة المشتركة. وبهذا يتم استبعاد كلّ ما هو مختلف وابقاء المتفق عليه. مثلًا سيتم استبعاد القول: إن اليهود "شعب الله المختار"، كذلك إن المسلمين "خير أمة أخرجت للناس"...، بهذا يتم استبعاد "أنا" الاختلاف، والتأسيس للسلام الديني العالمي وللأخوة الإنسانية التي تتوج بقانون يسمح باستئجار الأرحام، وبأعمال مشتركة بين المؤمنين وغير المؤمنين. كما يتم بناء أخلاقيات جديدة لوطن بلا حدود، ولقيم قائمة على العدل والمساواة والرحمة. فالأرض هي المساحة المشتركة التي تجمع الجميع. كما تم اختيار يوم 14 أيار/مايو يومًا للصلاة المشتركة والحوار الشعائري لكل العالم.هذه هي خلاصة تعاليم المشروع الإبراهيمي الجديد الذي تطمح الولايات المتحدة الأمريكية أن تعممه، ليصبح "الإله الأمريكي" هو الجامع، وهو إله هذا الكون؛ إله يجمع الجميع، ويكون البديل من الصيغ الدينية التقليدية التاريخية (المسيحية واليهودية والإسلامية) المنتشرة في العالم منذ آلاف السنين. وكأن هذا المشروع يعيد التاريخ إلى الوراء من خلال إعادة إحياء تلك العقائد بعد ما يزيد على ألفي سنة.إن طرح هذه "الديانة"، ليس سوى استخفاف بعقول المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم. فهل تعتقد الولايات المتحدة أن الشعوب التي آمنت بهذه الأديان في ذلك التاريخ، يمكن استنساخها اليوم، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول إعادة زرع بذور لوعي بشري متشابه لما كان عليه وعي شعوب ذلك الزمن، وها هي قد وضعت الأسس لاسترجاع ذلك العالم الذي تقوم اليوم بتقسيم شعوبه إلى يهود ومسلمين في البدء فلسطين مثالًا، كذلك إلى مسيحيين ومسلمين، والمثال لبنان والسودان؟أما المرحلة الجديدة التي يتم التحضير لها في "الفيلم الأمريكي الطويل"، فتهدف إلى تقسيم المنطقة ببن السنة والشيعة، مثال ما رسم للعراق وسوريا واليمن ولبنان، وما يرسم لدول أخرى. ففي هذه البلدان رسمت الولايات المتحدة الأمريكية صورة لمشروعها، ويأتي المشروع الإبراهيمي لزرعه في دول مفككة فاشلة معظم مكوّنات شعوبها من الأميين.لقد عملت الولايات المتحدة على تغيير الديموغرافيات السكانية لهذه الدول، فتم مثلًا في الدول الغربية في القرن العشرين، اجتثاث القسم الأكبر من معتنقي الديانة اليهودية. وما فعله هتلر (Hitler) لم يكن سوى نموذج لـــــما كـــــان يمارس ضد اليهود من عنصرية. أما في العالم العربي ولتحقيق الحلم الاستعماري، فقد تكفلت "الوكالة اليهودية" التي هي بإدارة استعمارية، مع سلطات الانتداب، بدفع المواطنين اليهود العرب من ترك مواطنهم العربية التاريخية.لذا، إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول تعميم المشروع الإبراهيمي، تركّز على تسويقه كما تشير الباحثة جمال الدين في كتابها، في "الجامعات، وفي دول عدة، وسيكون الهدف من نشره، كما تدعي، تعزيز فكرة الاستقرار في الشرق الأوسط، باعتبار الشرق الأوسط أساس الاستقرار في العالم". هذا وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسويق مشروعها أيضًا عبر "محافل دولية منها منظمة الأمم المتحدة، كذلك عبر الدعوة إلى مؤتمرات وقمم دولية. وأيضًا فهي تركز على الشباب باعتبارهم أساس الحركة المجتمعية".إن لهذا المشروع أخطارًا كثيرة سترافق نشر هذا الدين، وترى جمال الدين أن اتساع عدد المؤمنين به، سيكون له انعكاسات سلبية على الأديان الثلاثة الذين سيفقدون قدسية ما يؤمنون به، وما توارثوه، وأصبح منغرزًا في كياناتهم الوجودية، بل في شرايينهم وروحهم. نعطي مثالًا حول الأضرار التي ستنجم عنه، مصير مكة والفاتيكان والقدس وبيت لحم.من دون نسيان، إن المشروع، سيكون له انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين في أرضهم، وتعميمه سيفتح الأبواب للحديث على أماكن وقضايا لاهوتية قديمة ومستحدثة.
- خاتمة
يبدو من المفيد القول في خلاصة هذه الدراسة (الحوار)، إنها ليست سوى لإشعار الأصدقاء في المنتدى الشرق أوسطي، بعمق ثقتي بهم، وتقديري العالي لما يقدمونه. لكن هذا التقدير لم يمنع من إبداء وجهة نظر تنسجم مع تفكير صاحبها. وتعبّر عن هواجسه وتطلعاته. لهذا وبهذا الحب والتقدير، كانت هذه الدراسة بهدف طرح سؤال: هل الشعوب العربية عاجزة عن رسم صورة لحياتها، كي تستعين بالسماء؟إن الممارسات والمشاريع الاستعمارية التاريخية التي نفذتها بدايةً الدول الاستعمارية من فرنسية وإنجليزية، قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها، ولاحقًا أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، سيلحظ أن هذه الدول ولتنفيذ مشاريعها، لم يكن مساعد لها سوى استغلال الدين لبثّ الخلافات، وبثّ الفتن، والهدف تحقيق هيمنتها وديمومة وجودها.لقد التفت الانجليز لأهمية استخدام الدين في منتصف القرن الثامن عشر حينما ساهموا بتأسيس "الوهابية" التي عبرها رُسم الشكل الأول لدول الخليج العربي، وفي بداية القرن العشرين تم تأسيس "منظمة الإخوان المسلمين" التي رسمت صورة مشبوهة ومشوهة للشعوب العربية، ومن ثم "وعد بلفور"، ثم "مؤتمر سايكس بيكو"... هذه المشاريع لم تكن من بنات أفكار الإنجليز والفرنسيين، وإنما تمت العودة إلى التاريخ الإسلامي بهدف استغلاله، ومنه أعيد الحسبان لما كانت عليه التقسيمات الاجتماعية في أواخر حكم الدولة الإسلامية العباسية، فتم تأسيس وطرح هذه المشاريع لزرع بذور التمايز والتفرقة ببن المكوّنات الاجتماعية العربية والمتعددة الأيديولوجيات الدينية.كان هدف هذه الدول الاستعمارية إعادة تجذير التمييز الذي كانت عليه شعوب القرون الوسطى، فأعادت نظام أهل الذمة الذي دُمج بالنظام الملّي العثماني، ومنه تم تقسيم وتشكيل الوطن العربي. وحديثًا يتم رسم صورة جديدة للعالم العربي، مبنية على تقسيمات جديدة؛ ففي سوريا والعراق وفلسطين تم اجتثاث المواطنين المسيحيين ومعهم الملايين من مواطني العراق وسوريا من السنّة، كما تم تقسيم السودان إلى دولتين، وفي لبنان يتم اجتثاث المسيحيين على نار باردة، وفي المرحلة الأخيرة، يتم تقسيم المنطقة إلى سنّة وشيعة.بهذه السياسة تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد رسمت مشروعًا أعادت به إحياء ما كانت عليه شعوب القرون الوسطى من جهة، وإعادة رسم خرائط جديدة مبنية على متغيرات في الأوضاع الديموغرافية للشعوب العربية من جهة ثانية.وعلى أنقاض ما تفعله، تسوّق لمشروع "الديانة الإبراهيمية" لتحققه على واقع تقسيمي جديد ترسمه للمنطقة، واقع يشبه بما كان عليه الوضع العربي في عالم الدول الفارسية والرومانية والبيزنطية قبل ألفي سنة. والآن وفي الألفية الثالثة، بوجود الدولة الصهيونية والخلافة العثمانية ودولة ولاية الفقيه، وفي ظل التحولات المفصلية في النظام الرأسمالي، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتضع مشروعها التقسيمي الذي يعيد مكوّنات الشعوب العربية إلى واقع النظام القبلي الديني الذي تخطط له، وتضعه كما تعتقد، على أرض صلبة يمكن أن يعيش فيها هذا المشروع!
***
* رئيس التحريرالهوامش[1]- عقد المؤتمر في الحمراء (بيروت)، في شهر تموز/يوليو 2023، عن التأثيرات والمضاعفات المحتملة للذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط. وقد حاضر في المؤتمر عدد من الباحثين والمفكرين العرب، منهم: رئيس جامعة المقاصد الخيرية الإسلامية البروفسور حسان غزيري، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر د. محمد سالم، ومدير منتدى التكامل الإقليمي سعد محيو... وشرع القيمون على المؤتمر بمناقشة "نداء بيروت" تمهيدًا لإطلاق النداء، وتشكيل وفد إقليمي يجول على الدول الرئيسة في المنطقة، لطرحه على أصحاب القرار ونخب المجتمعات المدنية.[2]- يعدّ المجمع المسكوني الأول. وقد عقد في 20 آذار/مارس أو أيار/مايو إلى 19 حزيران/يونيو 325 م، في مدينة نيقية الواقعة في الشمال الغربي لآسيا الصغرى، بحضور الإمبراطور قسطنطين الأول ونحو 318 أسقفًا معظمهم من الشرق. وهدف المجمع دراسة الخلافات في كنيسة الإسكندرية بين آريوس وأتباعه من جهة، وبابا الإسكندرية الكسندروس الأول وأتباعه من جهة أخرى، حول طبيعة يسوع: هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة البشر؟[3]- التعبير للباحثة اللبنانية عايدة الجوهري. ينظر كتابها: "رمزية الحجاب: مفاهيم ودلالات"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011، (311 صفحة)[4]- صدر كتاب "الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن"، عن الدار المصرية اللبنانية، 2022 (256 صفحة)[5]- كشف سيد نصير عن رسائل متبادلة بينه وبين عدد آخر من المسؤولين الأمريكيين حول فكرته عن إحلال السلام في الشرق الأوسط، التي تعرف باسم "دولة إبراهيم الفيدرالية". وقال في رسالة مطولة تلقتها صحيفة "الشرق الأوسط" من سجن فلورنس الفيدرالي بولاية كولورادو الذي يحتجز فيه أيضًا الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لـ"الجماعة الإسلامية" المصرية المحظورة، وقياديين أصوليين آخرين أدينوا في قضية تفجيرات نيويورك في العام 1993: إن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني تلقى منه رسالتين، وأمر بإيداعهما في ملف نصير الخاص بمصلحة السجون. ينظر: صحيفة الشرق الأوسط، عدد 8103 في 3 شباط/فبراير 2001، وعدد 8958 في 8 حزيران/ يونيو 2003، وعدد 21 آذار/ مارس 2016م.
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on November 15, 2023 00:55
November 12, 2023
الافتتاحية: إنّه عصر الرواية

جان عبد الله توما *
إنّه عصر الرّواية. هو سعي النّاس إلى التّماثل ومحاكاة الما بعد. كأنّه مكتوب للنصّ أن يصيرَه كلّ ملتهم معرفة، ولاهث وراء صورة، ولمّام الجمال أنّى كان. تأتي الرّواية لتحتضن هذه المشاعر كلّها، حواسًا وشوقًا إلى الماورائيّ، بديلًا من تداني الواقع الجاف، حيث يبدو المرء مستسلمًا إلى مهارات الحاضر في اقتناص العقول، وتعليب الأفكار، وكبسلة المفاصل الثّقافيّة.هو عصر البحث عن البطل السرديّ، ذاك الذي رسمه الناقد السعوديّ معجب العدوانيّ بصفاته: "المثاليّة، والشجاعة، والصدق، والنزاهة وغيرها، وأيضًا محاربًا للشّر، مصارعًا من أجل الخير، وتحقيق العدالة". هذا بحث عن الشّخصيّة الخارجة من ضعفات البشر إلى مصادر القوة الفاعلة الأسطوريّة، كأنّ الرواية العربيّة اليوم تنهج مسرى فضاءات الملاحم اليونانيّة، وما بُني على المبالغات في الحكايات الشعبيّة العربيّة، أو المعرّبة، كما في "ألف ليلة وليلة"، وبطولات السندباد، وبساط الريح والفانوس السحريّ، تتداخل المعطيات في الرواية حتى لتبدو كالخارجة من نار لا تُحْرِق ولا تحترق، كالآتيات المنتظرة والممتنعات، كالضدّ وضدّه، لذا تأتي أنسنة الرّواية من بناء مخرج عبور من مكان إلى المكان، ومن زمان إلى الزمان.إنّه عصر الرواية، ولو اختلفت شخصيّة الراوي في هذا العصر الرقميّ الكاسح الماسح، حيث تكبر الفجوة لنختنق داخلها عابرين بإرادة مسلوبة، مستسلمة، صاغرين. تبقيك الرواية الورقيّة على اتصال إنسانيّ مع الماورائي، تخترعه، تركّب معارجه وساحاته وأماكن اللقاء، تعلّق بيديك إطارات الصور على حيطان الرواية، الخوف اليوم من تحوّل العصر، وقد تحوّل ربّما، من مقولة ديكارت (Descartes): أنا أفكر إذا أنا موجود" إلى حالة جديدة عجيبة قد تُختزل بعبارة "أنا موصول، إذا أنا موجود"، فهو أسير اتصال سلكي أو لاسلكي، ولكنه من نار حارقة، تلفح وتحرق، وتترك البشر كالأيّائل الملتهمة شيئًا ضارًا، فتسعى إلى مجاري المياه لتطفئ حرقة أحشائها. من هنا كشفت الأستاذة اللبنانيّة في كلّية الإعلام نهوند القادري عيسى في مقالتها "التموضع العربيّ في البيئة الرقميّة: رهانات وتحديات": عن كون "هذه التقنيات التي عُدّت وسائل تحرّر، وسائل جديدة صارت تشكّل من الرقابة ومن الضغط، في الوقت عينه؛ فبتنا نشهد رواجًا للأدوات الذكيّة التي تجمع المعطيات عن المستخدمين، وهو ما يُمكّن الـ"بيغ داتا" من شقّ سريرتنا، والكشف عن المعنى الخفيّ لسلوكنا، بغرض فهم انفعالاتنا، واستباق رغباتنا، ومراقبتنا وإيقاظ المستهلك الراقد في داخلنا؛ ففي ممارسة الشبكات الاجتماعيّة يحصل انتهاك للخصوصيّة والداخليّة، بهذا تسير بنا الثورة الرقميةّ إلى عالم حيث الإنسان يكون مفصولاً عن نفسه، وينتهي إلى أن يكون قابلًا للرقابة المطلقة من دون إكراه ولا عنف."في المقابل، فإنّ الذهاب إلى الرواية يجعلك تَكْتَشف بدل أن تُكشَف، لأنّك وأنت تقرأها تكون السيّد على متاهة خيالك، ولو قادك راوٍ إلى مسالكه، ليضع بين يديك قنديل سفر، ومصباح "ديوجين" الباحث عن الحقيقة في عزّ الظهيرة. إنّ قارئ الرواية، معزول عن عجقة العالم بإنجازاته، منصرف إلى السكينة برويّة أحرف الأبجديّة الناطقة بجمادها وصمتها. القارئ في الرواية مبحر في أمداء الفضاء السرديّ، حيث تسلّمه مجرّة إلى مجرّة أخرى، فيما الفضاء الرقميّ يجرّه إلى الثقب الأسود ليصير الرقم المستهدف والمطلوب.إنّ القارئ يغرق في الحيّز الرقميّ، وفي مدّه المتوالي، فيما تدعـــوه الرواية إلـــــى إطـــلاق اسم من يحبّ على الكواكب والمجرّات وما يبصره بمرصد قلبه، ألـــم يطلق المؤلفون على كتبهم أسماء تشعر وتحسّ وتئن؟: "زينب" لمحمد حسين هيكل، "روميــــو وجوليت" لوليم شكسبير، "ميرامار" لنجيب محفوظ، "مدام بوفاري" لغوستاف فلوبير، "آنا كارنينا" لليو تولستوي، وغيرها، لم تكـــن يومًا مجرّد روايات، بل شكّلت كتل نار رفعـــــــها الروائيون كواكب وشهبًا في الفضاء الروائيّ السرديّ.انطلاقًا من هذه المنصّة تذكر الناقدة المصريّة والروائيّة رضوى عاشور أنّ "كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق" لأحمد فارس الشدياق هو أوّل رواية عربيّة، أو سيرة روائيّة، وأنّ الفارياق (ابن النحس) هو الشخصية الأساسيّة، وهو اسم مشتقّ من اسم الكاتب الأول ولقب عائلته (فارس والشدياق)"، وفي هذه السيرة يشير الناقد اللبنانيّ صبحي عبد الوهاب إلى فرادة كتاب الشدياق في "مسألة التفكير في خيارات اللغة والأسلوب أثناء التأليف، انتقال بين الفصحى والعاميّة، النفور من علامات الترقيم".هذا لا يعني أن لا عجائبيّة للرواية، بل هي وريثة النصوص المقروءة والمحكيّة والمسرودة والمتداولة في المجالس المتنوّعة. كلّ رواية هي ترجمة لتراكم ثقافيّ وغنى في خزانة حفظ التراث، وهي ذات قدرة على مواكبة الحياة، بتفاصيلها الظاهرة والمخفيّة والماورائيّة والمتخيّلة، لذلك أكّد الفيلسوف اللغويّ الروسيّ ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtin) على المنحى التجدّدي للرواية تحديدًا، فهــي بالنسبة إليـــه النوع الأدبيّ الوحيد الذي ما زال في طور التكوّن، لكون الرواية تَكتب ما ينتجه التاريخ، وجديدها هو جديده.ما يفيدنا من هذا كلّه في مجلة رائدة كمجلة "الحداثة"، المنصة الثقافيّة العامرة والواعدة، الإشارة بوضوح إلى أنّ العصر، ولو كان عصر الرواية، إلّا أنّ الرواية العربيّة، وربّما العالميّة، ستبقى دائما في انتظار حكواتيها، أو راويها، أو رائيها، ليكتبوا لنا الرواية التي لم تُكتَب بعد.
***
* باحث لبناني. أستاذ دكتور (الجامعة اللبنانية). رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الجنان
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on November 12, 2023 04:58
تأثير الأزمة الاقتصادية على النمط الاستهلاكي للأسرة اللبنانية (شمال لبنان نموذجًا)

عليّه علي ملحم *
- المستخلص
تعالج هذه الدراسة أثر الأزمة الاقتصاديّة التي يشهدها لبنان على السّلوك الاستهلاكي للأسرة اللبنانيّة (شمال لبنان- نموذجًا) التي تبدّلت أولوياتها وتآكلت القدرة الشرائيّة لديها، خاصة للأفراد الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانيّة.استهدفت الدراسة عيّنة من المجتمع اللبناني تمركزت في الجانب الشّمالي من لبنان، حيث بلغت العينة 289 أسرة توزّعت على محافظات: عكار، والمنية - الضنية، وطرابلس، وتم استخدام العينة العشوائيّة لتشمل الطّبقات الاجتماعيّة الثلاث.وقد كشفت الدراسة عن تراجع في الاستهلاك الأسري من خلال قياس دخل الفرد ومقارنته بالدخل الذي كان يتقاضاه قبل الأزمة. ومن خلال ذلك، تبين التراجع الاستهلاكي للأسرة في السّلع الأساسيّة، خاصة السّلع الغذائيّة مثل اللحوم والأسماك والخضراوات التي تُعدّ من السّلع المهمة في تحديد النظام الغذائي الجيد للفرد وتحديد كمية السّعرات الحراريّة التي يحتاجها خلال يومه. وقد تم التحقق من ذلك من خلال أن المبلغ المخصص لهذه السّلع قبل الأزمة بقي نفسه خلال الأزمة إذا ما احتسبنا المبلغ بالليرة اللبنانيّة. المفارقة الواضحة، إن هذا المبلغ لم يعد يأتي بشيء يذكر خلال الأزمة، ما يرجح أن يصل هذا التراجع في الاستهلاك للسلع الغذائيّة إلى مستوى عالٍ من سوء التغذية للفرد خلال السنوات القادمة إن لم يتم تدارك الأمر، ووضع حلول جذريّة لهذه الأزمة التي فتكت بالمواطن اللبناني وقلبت حياته رأسًا على عقب، وتحوّلت أساسياته إلى كماليات، الأمر الذي يعود بدوره الى نتائج سلبية على الصعيد الاجتماعي والنفسي.
- الكلمات المفتاحية: الاستهلاك، الأسرة اللبنانيّة، الأزمة الاقتصاديّة، مجتمع شمال لبنان
***
* باحثة لبنانية. حائزة شهادة دكتوراه في العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية. عضوة في مركز استشارات بحثية، وخبيرة في المجال الإحصائي والدراسات الإحصائية.
المصادر والمراجع
- العربية- الباشا، محمد؛ شحادة، نظمي؛ والجيوسي، محمد (2000). مبادئ التسوق الحديثة. السعودية: دار صفاء للنشر والتوزيع- البنك الدولي (2021). أزمة لبنان الاقتصادية والمالية بين أشد 10 أزمات منذ عام 1850 mc-doualiya.com.- بيان صحفي (1-25-2022). الأزمة في لبنان: إنكار كبير في ظل حالة كساد متعمد. بيروت: المرصد الاقتصادي اللبناني- التقرير الاقتصادي- فانا (25 آب 2021). لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة. بيروت: الوكالة الوطنية للإعلام NNA- جار الله، محمد (2008). إدارة الأزمات. عمان، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع- الجميل، سرمد كوكب (2002). التمويل الدولي، مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات. الموصل: الدار الجامعية للطباعة والنشر- خواجة، أحمد. (2021). كيف أثرّت الأزمة الاقتصادية على نمط حياة المواطن اللبناني؟ ultrasawt.com.- الدليمي، علي أحمد درج ومصطفى فاضل حمد (2018). انعكاسات الأزمة المالية العالمية 2008 على اقتصادات أقطار مجلس التعاون الخليجي. مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، مج. 10، ع. 22 (ص ص. 115-137)- عبابنة، عمر؛ يوسف، عبد الله (2011). الأزمة المالية المعاصرة، تقدير اقتصادي اسلامي. عمان: اربد للنشر والتوزيع- عبيدات، ذوقان؛ عدس، عبد الرحمن؛ وعبد الحق، كايد (2014). البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه. عمان: دار الفكر للنشر ط1- العقون، نادية (2013). العولمة الاقتصادية والأزمات المالية: دراسة أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية. باتنة، الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج الخضر- عمران، تغريد وآخرون (2006). المهارات الحياتية. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. ط1.- غزال، ميسر قاسم (2002). الأزمة المالية العالمية. مجلة العلوم الاقتصادية والادارية 15.- معراوي، أميمة (2020). سلوك المستهلك. سوريا: منشورات الجامعة الافتراضية- معلوف، لويس (1986). المنجد في اللغة. بيروت: دار المعرفة- نوفل، ربيع (2006). اقتصاديات الأسرة وترشيد الاستهلاك. الرياض: دار الناشر الدولي- يونيسف (21 ديسمبر 2020). تأثير الأزمة غير المسبوقة كبير جدًا على الأطفال في لبنان. بيروتUNICEF Lebanon
- الأجنبية- Durham, W. (2004). the family planning communication of voluntarily child-free couples. Dissertation Abstrats international.- Institute, E. B. (2003). Family savings: results of the survey of consumer finances. Washington: dc
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on November 12, 2023 04:40
العوامل المؤثّرة على توزّع المؤسسات الصّناعيّة في البقاع
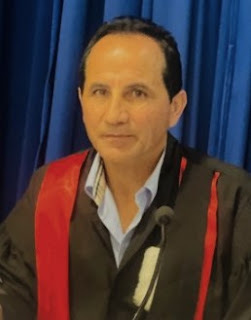
طارق سليمان مشيك *
- المستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص الطبيعيّة والبشريّة والاقتصاديّة في منطقة البقاع اللبناني، وأثرها على توزّع المؤسسات الصّناعيّة، بهدف معرفة أنواع الصّناعات التي يمكن أن تنجح أكثر من غيرها في هذه المنطقة، من أجل تحقيق التّنمية وتحسين الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة للسّكان.تتضمّن الدراسة إطارًا نظريًّا، وعددًا من النقاط الأساسيّة التي يمكن ايجازها على النحو الآتي: الخصائص الطبيعيّة لمنطقة الدراسة - الخصائص البشريّة والاقتصاديّة – حجم المؤسسات الصّناعيّة - التّوزيع القطاعي للمؤسسات الصّناعيّة – الخلاصة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات، من أهمها: إن للعوامل الطبيعيّة في منطقة الدراسة، أثرًا كبيرًا في توطّن الصّناعات، لكن استطاع الإنسان بمساعدة التطور التكنولوجي والتقني، أن يقلل من أثر بعض هذه العوامل، حيث تمكّن من تكييف الظروف المناخيّة المحيطة به داخل المصنع وخلق بيئة ملائمة للعمل، بالمقابل يُعدّ أثر العوامل البشريّة والاقتصاديّة محدودًا نسبيًّا.
- الكلمات المفتاحية: الصناعة في البقاع، العوامل الطبيعية والبشرية، التنمية، مناخ لبنان
***
Factors affecting the distribution of industrial establishments in the Bekaa
- Abstract: This study seeks to reveal the natural, human and economic characteristics of the bekaa region, and their impact on the distribution of industrial institutions, with the aim of knowing the types of industries that can succeed more than others in this region, in order to achieve development and improve the economic and social conditions of the residents of this region.The study included a theoretical framework and a number of basic points that can be summarized as follows: (natural characteristics of the study area-human and economic characteristics- size of industrial enterprises- sectoral distribution of industrial enterprises – conclusion – references and sources).This study reached a number of conclusions, the most important of which are: that natural factors in the study area have a major impact on the localization of industries, but man has been able, with the help of technological and technological development, to reduce the impact of some of these factors, as he was able to adapt the climatic conditions surrounding him inside the factory and create an environment suitable for work, on the other hand, the impact of human and economic factors is relatively limited.
- key words: Sectoral distribution of institutions, Industrial density, Human factors, Natural factors
***
* باحث لبناني. حائز شهادة دكتوراه في الجغرافيا. أستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع الخامس) - الجامعة اللبنانية
المصادر والمراجع
· الدراسة الميدانية
- المراجع العربية:- أبو عيانة، فتحي (1986)، التحليل الاحصائي في الجغرافيا البشرية، بيروت: دار النهضة العربية- أبو راضي، فتحي عبد العزيز (2004)، أسس الجغرافيا المناخية والنباتية، بيروت: دار النهضة العربية- جودة، حسين (1985)، جغرافية لبنان الإقليمية، الإسكندرية: منشأة المعارف- الكناني، كامل كاظم بشير (د. ت.)، دراسة نظرية الموقع الصناعي، عمان: دار الصفاء للطباعة والنشر
- المراجع الأجنبية:- Ducousso, Gaston: l’industrie de la soie, paris – date non mentionee- RIZK, BOTROS, l’administration libanaise 1943-1979.
- المؤسسات الرسميّة:- بلدية بعلبك وزحلة- غرفة الصناعة والتجارة في بعلبك وزحلة.- وزارة الصناعة اللبنانية (2022)، القطاع الصناعي في لبنان، بيانات غير منشورة.
- مقابلات:- مقابلة مع رئيس تجمع الصّناعيين في البقاع، حزيران 2022.
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on November 12, 2023 04:31
نظرة المجتمع اللبناني للصّحة النّفسيّة (نماذج مختارة من البقاع)

تمام علي منذر *
- المستخلص
بالرّغم من تطور الطب النفسي وعلاجاته، إلاّ أن البعض لم يتخلّص من موروث السنوات الطويلة من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن زيارة الطبيب النفسي، هذا ما أكّده عددٌ من المستجوبين الذين استطلعنا آراءهم، الأمر الذي أدّى إلى انكفاء العديد من الأشخاص عن زيارة الطبيب أو المعالج النفسي. أمّا الواقع الحالي ومقارنةً مع الماضي، فإن النظرة تغيّرت إلى حدّ ما. على الرغم من ذلك فإن المريض يتأثر بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده المتبّعة في مجال العلاج، لأن المجتمع يكون مشدودًا بالفطرة نحو العادات والتقاليد، ولا سيما في المجتمعات الشرقية.تبيّن في البحث أن الأمراض النفسية ردّ فعل طبيعي لظروف الحياة، ولا فائدة من علاجها من دون حلّ للمشكلات الحياتية؛ فالصراعات المجتمعية، وحالات الفقر والبطالة جميعها، ضغوط تؤدّي بالضرورة، إلى اختلال في توازن الإنسان وسلوكه. من هنا، يشدد البحث على أهمية دور الطبيب النفسي الذي يساعد المريض على أن يتماهى مع البيئة والظروف والمشكلات الضاغطة التي يواجهها.
- الكلمات المفتاحية: الصحة النفسية، المجتمع اللبناني، الطبيب النفسي، البعد الاجتماعي
***
* باحثة لبنانية. تعدّ أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع في المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية
المصادر والمراجع
- العربية:- الزبيدي، كامل علوان (2000). الضغوط النفسيّة وعلاقتها بالرضا المهني والصحّة النفسيّة لدى أعضاء الهيئة التدريسيّة في الجامعة، أطروحة دكتوراه، كليّة الآداب، جامعة بغداد، العراق.- عكاشة، أحمد (2010). الطبّ النفسي المعاصر، ط1، القاهرة: مكتبة الانجلو المصريّة- النابلسي، محمد أحمد (د. ت.). العلاج النفسي العائلي. سلسلة علم نفس الطفل، بيروت: خلق العربية للطباعة والنشر
- الأجنبية:
- Felman, Adam. What is mental health? Retrieved on 19th of September 2020, from: https://www,medicalnewstoday,com/articles/154543- Rosenhan, David L (1973). D. Rosenhan on being sane in insane places. Science (internet). (cited 13 April 2020); 179 (4070): 250 – 258, Available from.- Rosental, Susan; Campbell, Patricia, (2016). Marxism and Psychology, Kindle Edition (67 pages)- Sallin, K.; lagercrantz, H.; Evers, K.; Engstrom, I.; Hjern, A.; petrovic, p. (29 January 2016). Resignation Syndrome: Catatonia? Culture – bound? Front Behav. Neurosci, (1-18). doi: 10.3389/fnbeh.2016.00007 - https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2016.00007/full
- المقابلات:- مقابلة مع الاختصاصية النفسيّة "ن. م." (من مدينة زحلة)- مقابلة مع الاختصاصية النفسيّة ع. ه. بتاريخ 10/7/2017 (البقاع - لبنان)
- مواقع إلكترونية- صفحة لينا خوري على YouTube/ https://www.youtube.com/@KhouryLina- موقع الأنباء الكويتية (الأحد 2021/10/10)/ https://www.alanba.com.kw/1075838- موقع علم النفس الصحي/ https://psyc.sudanforums.net- موقع للعلم (المشاعر السلبية مفتاح الصحة النفسية - 9 يوليو 2016)/www.scientificamerican.com/arabic/articles/from-the-magazine/negative-emotions-key-well-being/- موقع منظمة الصحة العالمية/ https://www.who.int
الحداثة (Al Hadatha) – ع. 229/230 – خريف/شتاء 2023 – 2024 Autumn /WinterISSN: 2790-1785
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on November 12, 2023 04:20
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers



