بسمة العوفي's Blog
February 11, 2016
صوت العاشق
صوت العاشقصديقي العزيز.. هذه رسالتي الأولى والأخيرة إليك.. بعد الاطمئنان على أحوالك، سأخبرك ما لم تعرفه عني من قبل، ليس للشكوى، وإنما لدي أمر يهم العالم، وعليك أن تساعدني يا صديقي في نشر هذه الرسالة، ليس لديّ حل آخر. عليك أن تقرأ هذه الكلمات كمن عثر على زجاجة آتية من عمق المحيط بها قطعة ورق حملتها الأمواج، ربما يكون صاحبها غرق، وربما يكون في انتظار المساعدة.
لقد اخترتك تحديدًا لأني أعرفك جيدًا، وأعرف قلبك الطيب، التقينا مرّات من قبل، ولم أخبرك أبدًا بإعجابي بذكاءك الحاد واجتهادك وأمانتك، أعرف أيضًا أن هناك من تكالب عليك لتترك مهنتك بسبب تحقيقك عن مواد كيماوية تصيب الأطفال بالسرطان واتضح أنها مافيا من كبار رجال الدولة، وأعرف أنك الآن تعمل موظفًا للعلاقات العامة بمصنع ملابس. ليس لدي شخص آخر يقوم بهذه المهمة غيرك، خاصة عندما علمت أنك تركت المهنة التي جمعتنا سويًا، ولكني أعلم أن قصة مثل هذه قد تعود بك إلى صفوف المقدمة، كما كنت دومًا.
سأبدأ من هناك.. في الصغر، كان لدي أفكار غريبة أحتفظ بها مثلما تحتفظ الجدّات بصندوق عتيق في دولاب ملابسهن، به صور وخطابات غرامية عندما كانوا عشاقّا، الفرق أن أفكاري أحتفظ بها من طفولتي، وأصدق بها تماما كلما كبرت.
مثلا، كان لدي قناعة بأن مروحة السقف لا تعمل بالكهرباء، بل إن جيراننا في الطابق الأعلى يتفرغ منهم شخص ليلفها بيده طوال الوقت، والجيران الأعلى منهم يلفونها لهم، وهكذا. وأؤمن بأن هناك أرنبًا يسكن القمر، لو دققت في الرسوم على سطح القمر في ليلة صافية لرأيته، أرنبًا جميلًا يقف أمام إناء يطبخ فيه جزر الأمنيات، وهو جزر برتقالي عادي من الذي تأكله الأرانب، لكنه مُحمّل بأمنيات البشر، وعندما ينتهي الأرنب من طهي الجزر، يرسله للعشاق المنتظرين آخر الليل ليحقق أمانيهم. ولطالما انتظرت هذا الأرنب وناديته، وودت أن يأتي ويلعب معي، أو أن أصعد للقمر وأساعده في الطهي، ولكن جزرة أمنيتي لم تأت بعد.
عندما كنت صغيرة، كنت أشك أن زميلتي في الفصل ذات العيون الخضراء، ترى كل شيء أخضر، وذات العيون الزرقاء ترى كل شيء أزرق، وعجبت حينها من لون عيوني الأسود، الذي أرى به الأشياء ملونة وليست بلون واحد. ولطالما عاملتهم كما القطط، أو هكذا اعتقدت، أنهن يرون كل شيء كأفلام الكرتون غير المجسمة، يرون الأجسام مسطحة ثنائية الأبعاد وبلون واحد، وكثيرا ما شعرت بالأسف لذلك لأنهم لا يرون جمال الكوكب.
أصدّق تماما في الثقب الأسود في الفضاء، وفي طيران طبق طائر فضائي فوق رؤوسنا دون أن نراه يفتح بابه فجأة ليشفط شخص ما لأعلى، وأن القطط تتحول في الليل إلى كائنات مرعبة، أشباح أو عفاريت، وأن مواءها هو بكاء أطفال تحولوا إلى قطط عندما رأوها في الليل، لذلك كانت أمي تنصحني دائما بألا أهشّ قطة في الليل كي لا أتحول مثلهم. وبأن هناك أناس سُخطوا إلى حيوانات وكائنات، قد يكون نبات أو شجرة أو طائر، لذا عليّ أن أحافظ على الروح بكل شكل كانت.
لطالما حدثت الهدهد الذي وقف على حافة شرفتي لسنوات، وظننت أنه هارب من عهد نبي الله سليمان، وأنه يستطيع أن ينقل إليّ الأخبار إذا تصادقنا، لكنه لم يمنحني الفرصة، وأكملت أنا سعيي وراء الأخبار وصرت صحفية كما تعلم. وتابعت بشغف قصة الحب بين اليمامتين الجالستين أعلى شباك الجيران في مكان سريّ أراه من شرفتي.
آمنت أن سمكة الرنجة الذهبية هي سمكة مقدسة لدى قدماء المصريين استطاعت عبور الزمن، لذا يأكلونها في الأعياد والمناسبات تعبيرًا عن فرحتهم، وأن ما بباطنها من بطارخ هي مولود جديد، كان سينتج عنه سمكة ذهبية جديدة، لولا أن العلم يقول أن الأسماك لا تلد. وعندما حكت لي صديقة قديمة أنها تخاطب النمل، وأمرت النمل أمامي أن يتحرك في اتجاه معاكس وفعل، صدقت أن النمل يسمع وينفذ ما تقوله، لكنها أفصحت عن سخريتها مني سريعًا، ولم أفهم لماذا سخرت رغم أن نبي الله كان يسمع النمل وهو بشر مثلنا.
حتى عندما كبرت، وسمعت سخرية الناس من أسطورة "النعل المقلوب" الذي يجلب النحس لأهل الشارع، ظللت كلما رأيت نعلًا في شارعنا أو أي شارع آخر عدلته. وكلما سقط رمش من عيني أو شعرة من وجهي علمت بأن أحدًا يفكر فيّ في هذه اللحظة، أما إذا تحشرج الماء في حلقي فهناك من يقول شيئًا عني. وإذا رأيت غرابًا في الصباح اتخذت حذري طوال اليوم من أي شيء قد يحدث. والدم الذي يظهر عند مغيب الشمس متناثر من مقصلة الغروب التي تأخذ أرواحًا ترسلها للعالم الآخر مع موكب الشمس الراحلة.
لماذا أحكي لك هذا؟ لأني وليعلم الله أني لست ساذجة، ولكني أصدق أن الحكايات والأساطير ليست من فراغ، لطالما استهوتني وبحثت عن أصلها حتى أفهمها. لي وجهة نظر في ما يحدث، وأحب البحث عن أصل الحكاية، ربما كان هذا سبب دخولي هذا المجال، لطالما سعيت وراء الدهشة، لأن ما من دخان إلا وراءه نار. ولهذا، أريدك يا صديقي أن تصدقني عندما أقول لك أني كنت أستمع إلى غناء في الليل، ولا أعرف مصدره، فهو ليس بصوت مسجّل أو آت عن جهاز إليكتروني، أسمع صوت حنون وهادئ، يغني كما يغني السندباد على سجادته وهو طائر في السماء بمفرده، يغني بكلمات غير مفهومة، أكاد أجنّ وألتقط واحدة منها، يغني بلغة أشبه باللغة الإيرانية التي أسمعها في الأفلام، لكن غناؤه حزين للغاية، وبلا مصدر محدد.
تفقدت كل غرف المنزل، وسألت الجيران كلهم عما إذا كان أحدًا يغني في الليل أو يسمعون ما أسمع، ولم ألحّ في سؤالي عندما رأيت نظرات مرتابة في أعينهم، تشكك في قواي العقلية، وأنا أمامهم صحفية وصاحبة عقل رزينة، تخوض المخاطر وتكشف الفساد وتظهر في التليفزيون ويصدر لها كتب لا يشترونها ولكن تعطيها لهم أمي كهدية من باب التفاخر وكيد بناتهن. ولكني، وأقسم لك، أني وقعت في غرام الصوت، ذلك الصوت المبحوح بحة حزينة ومؤلمة ومليئة بالشجن، كبحة صوت العاشقين المشتاقين عندما يتهالكون بسبب قوة أشواقهم. أكاد أشعر بأوتار قلبي ترتعش مع هزة حبال صوته، ويكاد جماله يذهب بعقلي كما تذهب النداهة بعقول الفلاحين، عفوًا لم أخبرك بتصديقي لأسطورة النداهة، لقد رأيت فلاحة مجذوبة ندهتها النداهة، والله رأيتها، وكانت تسير في الشوارع على غير هدى وبدون اتجاه، قد تقول أنت أنها سيدة مجنونة فقدت عقلها وهذا مرض، ولكني متأكدة أن الأمراض لا تأتي بكل هذا السحر، والشغف، والغواية، والمتعة، التي تسلب العقل، وأنا يا صديقي كدت أن أفقد عقلي من حلاوة الصوت، وأردت أن أعرف مصدره. أعترف أنه كان مزعجًا في البداية، وكنت أود التخلص منه لأنه يضعني في حالة حزينة تصل إلى حد البكاء الذي يلتهمني كما تفعل عجلات سيارة مسرعة مع أسفلت الطريق، ولكن، ربما التأقلم، أو لمحة الشجن الناعمة في الصوت، أو أن نقطة ضعفي هي رَجُل كَسَرَه الحب، تلك التي جعلتني ليلة بعد ليلة، من دراويشه.لم يقتصر الأمر على الليل، فصرت أسمعه في النهار، في العمل، في خلفية أي حديث مع أي شخص، أسمع هذه الكلمات المبهمة والموسيقى والأنّات كأنها وساوس، أو استغاثة آتية من بعيد جدًا، حتى أني استعذت بالله منها مرارًا فلم تذهب، وقلت أنه ربما كان شيطان يداعبني أو يؤرقني ولكن بلا فائدة، كان الصوت أجمل من أن يكون شيطانيًا، وكانت غوايته في براءته وصدقه، ومدى الحس المرهف الذي يطل من بين الكلمات غير المفهومة. فكرّت كثيرا في أن الأمر محض أسطورة من الأساطير التي أصدقها، هل هناك أساطير عن أشخاص مبحوحة أصواتهم يغنون في الليل؟ لم تصل إلى معلوماتي حتى الآن. وربما تقول أنت أنها محض هلاوس سمعية مرتبطة بمرض الفصام، أو كما يقول علماء التخاطر أنها نوع من الاستقبال الفائق للأصوات، والنداءات، تماما كما حلمت بغرق العبارة "السلام 98" وقت حدوثها بالضبط، وكما رأيت العديد من الحوادث والكوارث قبل وأثناء وقوعها. وإن صحّ ذلك فما تفسيرها وما أصلها؟ ولماذا يغني الصوت بكل هذا الحزن؟ لعلك تفهم الآن سبب وضعي لسمّاعات أذن طوال الوقت، لم أرغب في سماع الناس، وبدأت أختصر وأقتصر في الكلام على قدر ما أستطيع. أصبحت كتومة وصامتة أغلب الوقت، ومن يسألني أرد باختصار- لعلك جربت هذا عندما حاولت محادثتي أكثر من مرة- ومن يطلب مني شيء أفعله له كي أفرغ لنفسي، زحام الشوارع وأبواق السيارات والبائعين وكل هذا بات يصيبني بعصبية حادة، أضع سماعات طوال الوقت، ولا أشغل أي شيء، أنتظر فقط أن تلتقط أذني هذا الصوت، لعله، في يوم ما، يتضح.
أهملت عملي، وعندما ساءت حالتي خلال ستة أشهر تركته، وبعدما كنت اسمًا لامعًا يبشر بالخير في عالم الصحافة، سخر مني أصحاب الأقلام المزيفة والمعتادون على تلويث الحقائق. وقالوا أني فقدت عقلي من فرط تصديقي مهنيتي ووهم "الإعلام النزيه"، وبحثي عن الشرف والأمانة أدى بي إلى ذلك لأني لا أسير مع التيار. انقطعت عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وصرت مهووسة بهذا الصوت الآتي من حيث لا أدري.
انعزلت عن أسرتي وصرت أجلس في غرفتي لساعات طويلة ولا أخرج منها إلا لقضاء حاجة أو شرب الماء وتناول القليل من الطعام، ظنّ أهلي أن بي مرض، وجاءوا بطبيب للمنزل ليتفحص حالتي. قال لي الطبيب أن هناك غيوم على عقلي، وأن ظهري مُنحني كما لو كنت أحمل همّا ثقيلا على كتفيّ، وأن نظرات عيني الزائغة وشرودي المستمر يشير إلى أن هناك أمرًا عظيمًا يحتل تفكيري، وأن آلام مفاصلي وتصلّبها من الجلوس لساعات طويلة في برد الليل. وأخبرهم في النهاية أن لديّ سِرّ، وعليهم أن يكشفوه ويساعدوني قبل أن أتآكل تمامًا، وكتب لي روشتة علاج عبارة عن مسكن واسطوانات موسيقية لسليم سحاب!
ظن بي أهلي الظنون، من مشاكل بالعمل لعلاقة فاشلة لخسارة مال أو أصدقاء أو إحساس بالفشل أو الإدمان، لكن لم يكن هناك أعراض لأي مما سبق. لذا تعاملوا معي كأني مصابة بمسّ شيطاني، وقرأت أمي الكثير من الأذكار والأدعية والرقية الشرعية على رأسي، وكان صوت القرآن يملأ أركان بيتنا، وتذبح الذبائح وتذهب للمساجد، وكنت كما أنا، أقرأ كتب وأجلس في غرفتي جوار النافذة لأسمع الصوت، وأقضي الليل كله في شرفة غرفتي، أشرب قهوة وأنصت للصوت بكل حواسي حتى أغيب عن العالم وأنسى كل ما فيه، وأترنح مثل الدراويش الذين يسمعون الذِكر. لكي أكون صريحة، لم أرض عن نفسي تماما في هذه الحالة، لقد خسرت كل شيء من أجل شيء لا أعرفه، ولهذا، وهبت حياتي لهذا الصوت، وقررت أن الحال لن يكون أسوأ من ذلك، فلم يعد لديّ ما أخسره، وعاهدت نفسي أنه مهما طال بي العمر سأكتشف مصدره، وإن كان الثمن حياتي التي أفسدها. نذرت نفسي طوال عمري لكشف المجهول مهما طال الوقت، وأحببت المعرفة حتى وإن كانت نهايتي على يدها، لذا شغلت الكمبيوتر فورًا، وغرقت في بحور الإنترنت، قرأت كل ما لديّ من كتب تتحدث عن الأساطير الإغريقية والفرعونية والهندية والصينية والإفريقية، وغُصت في كل ما وقع تحت يدي، وبِتُّ أسهر الليالي بين الكتب والكمبيوتر، وفي النهار أجلس على الأرض لساعات في وسط الغرفة بستائرها المغلقة، وأحاول تخيل مصدر الصوت، هل هو لرجل؟ لمراهق؟ لشاب محبوس؟ لمحارب؟ لمعتقل؟ أضع كل الاحتمالات وأركبها على نغمة الصوت وأرى إن كانت تليق أم لا. ولكن بلا نتيجة.
هل استسلمت يا صديقي؟ أبدًا والله، قررت البحث في الماضي. فتحت كل أرشيف عملي في الصحافة من أول تدريب وأول خطّ بالقلم، وحتى الكتابة والعمل في كبرى الجرائد والقنوات التليفزيونية، كل قصة ذكرها لي معلميني، كل مستشفى أو مدرسة أو شخص قابلته أو سألته عن رأيه في الشارع، كل مكالمة تليفونية لمصدر، وكل لقاء مع حارس عقار أو مع وزير، مرّت أمامي ملايين الصور، كنت راضية عن أغلبها، إلا واحدة، أتذكرها جيدًا وكنت أضعها في خططي المستقبلية أن أحاول فعل شيء مهما طال الوقت.
كنت أتدرب حينها في إحدى الصحف عندما زرت قرية في منطقة نائية للغاية، لم يكن لها مواصلات إلا عربة نصف نقل، تمشي في طريق زراعي طويل، على يمينه خضرة لا متناهية وعلى يساره قناة مياة صغيرة. أعطيت للسائق الذي كان شابًا نحيلًا شديد اسمرار البشرة، في جلباب أخضر باهت متسخ عشرة جنيهات كانت نصف ما أملك حينها من مصروف جيبي، وطلبت منه أن يأخذني للقرية، فانطلق وسألني في الطريق عمن أكون، فأخبرته أني صحفية وأني آتية لعمل موضوع يخدم أهل القرية الفقراء. وسألته عن اسمه فسكت قليلًا وقال "تامر" وهو لا يبدو "تامر" أبدًا من لمعة الكذب التي بدت في عينيه وضحكة الاستهزاء على وجهه.
أخذني تامر إلى القرية، وبمجرد وصولنا وقف أمام أحد البيوت، ودخل وعاد بعد دقائق ومعه عباءة سوداء، وفردها أمامي وكانت مقطوعة من الظهر قطع صغير. كنت أرتدي بنطلون جينز أزرق وبلوزة خضراء، فأعطاني العباءة وأخبرني أن كل بنات القرية يرتدين مثلها، وإذا خالفتهن في الملبس لن يتحدث معي أحد، ولن أخرج بسلام. ففعلت ما طلبه، ومشينا في الشمس الحارقة بين البيوت الطينية، وكانت عكس ما تخيلت، فقيرة وميّتة، ليست بيوت ريفية جميلة كما ظننت، الممرات الصغيرة بينها تكاد تكون خالية، لا أطفال يلعبون بها، ولا بائعين، ولا رجال يجلسون ويشربون الشيشة على المصطبة، ولا نساء يبعن الطماطم والخيار والفجل والجرجير والخسّ.. أين أهل القرية؟ دقّ تامر على أحد الأبواب وفتحت سيدة ترتدي جلباب كحلي مزركش بالأصفر، ومنديل ملون لرأسها، دعتنا للدخول فدخلنا. واستأذنت لعمل كوبين من الشاي، وتركت طفلًا صغيرًا يلعب بطبق بلاستيك أمامنا، يسعل ويكح كل قليل.
لاحظ تامر نظرتي للطفل، فقال "كل أطفال القرية يعانون من السرطان والالتهاب الرئوي وأمراض في الأمعاء والدم"، سألته عن السبب، فدخلت السيدة تحمل صينية فضيّة صغيرة عليها كوبين من الشاي لونه أحمر باهت، وبجانبهما كوب به سائل أصفر، فسألتها ما هذا؟ فقالت "ماء". فاستغربت وسألتها عن لونه الغريب، فأوضحت أن كل أهل القرية يشربون هذا الماء الملوث لأنه لا يوجد غيره، وأنهم يشترونه بالجالون، لأنه لا توجد أنابيب توصل المياه للقرية، ولكن عربة تمر كل صباح فيأخذ كل بيت جالون بنصف جنيه.
أصابتني الصدمة بالخرس، واقترح تامر أن نذهب لمكان آخر، فمررنا أمام بيت صغير يدخله أناس كثيرين ويبدو فيه حركة غير طبيعية، قال أنه مصنع لإعادة تدوير القماش "الذي يرميه أولاد الذوات من ملابس وأغطية وفرش مستعمل، كله يأتي إلى هنا لنعيد تصنيعه وعمل سجّاد ومنتجات أخرى". وهناك قابلنا أحد معارف تامر، الذي حسب أني إحدى قريباته من قرية أخرى، ودعانا إلى حفل كتب كتاب إحدى بنات المصنع في المسجد بعد صلاة العصر.
استكملنا جولتنا في القرية صامتين، وسألت تامر عن الخرافات التي يصدق فيها أهل القرية، فقال بالطبع النداهة، فهي أسطورة ريفية أصيلة، وكذلك "خيال المآتة" الخشبي الذي يقف فاردًا ذراعاته بين الحقول، يصدقون بأنه يتحول ليلا إلى رجل حقيقي من لحم ودم، أما الأسطورة المرتبطة أكثر بالقرية فهم يرون أشباحا يشبهون أهل القرية الذين غادروها لأسباب كثيرة، يجلسون على شاطئ الترعة أو يتجولون في الحقول، ويعتقدون أنهم كانوا واقعين في حب بنات من القرية ولم يستطيعوا الزواج منهن، فتحولن إلى أشباح. ولكل حبيبة شبح يغني لها أغنيتها. واستكمل "البنات هنا إن كان حظها جيد يتزوجن أصحاب المصانع وأبناءهن، أو يوردوهن لخارج القرية للعمل كخادمات، أو يتزوجن ثري عربي لأسبوع أو اثنين، أما سيئات الحظ فيتزوجن خريجي السجون والهاربين منها، نسيت أن أخبرك أن المنطقة مليئة بهم كونها بعيدة عن الأنظار".
حضرنا مراسم كتب الكتاب بعد العصر، ورأيت العروس النحيلة ترتدي فستانًا ورديًا واسعًا ومتهدل الأكمام، تساقطت منه اللالئ والزركشات وبقي منها القليل، ووضعت طرحة بيضاء على رأسها مع أحمر شفاه ثقيل وكحل قويّ حول العينين الشاردة. وسط تصفيق أهلها وصديقاتها، سمعت صوت نغم حزين فاستغربته، وخرجت لأرى ما يحدث. كان أمام المسجد ممر مياه صغير جلس على حافته شاب صاحب الصوت ومعه ناي، قال لي تامر أنه حبيب هذه الفتاة منذ أعوام، لكنه ككل شباب القرية، فقير ومريض بالسرطان وأمراض أخرى، واحتمالية حياته وتحسن ظروف حياته ضئيلة للغاية، واعتاد أهل القرية على ذلك، مع كل زواج لفتاة يجلس حبيبها خارج الفرح، يبكيها، وينشد فيها أغاني فلكلورية من أغانيهم، ويعزف لها لحنًا على الناي، بلهجتهم الريفية، يقولون أنها تحمي الحبيبة أينما ذهبت، يتركوه هكذا إما ينساها أو يفقد عقله، أو يغادر القرية بلا رجعة.
اقتربت من الشاب وربتّ على كتفه، فنظر إليَّ بعينين دامعتين، وسأل تامر عني، فقال له أني ضيفة من ضيوف القرية وأني أعمل صحفية، فهبّ من مكانه وأمسك ذراعي وقال "ساعديني.. أرجوكِ". فسألته "كيف؟" قال "أريد فرصة عمل.. أريد إنقاذها، أريد أن أدخل مستشفى وأتعالج وأجد عمل أكسب منه قوت يومي ليرضى بي أهل حبيبتي، أرجوك، سأكون خادمك طوال العمر، سأفعل أي شيء تريدين، لا تتركيها تتزوج، أرجوكِ". "لكنها تتزوج الآن بالفعل!" قلت، فأخبرني أنه لازال هناك وقت حتى موعد الزفاف، وأنه يمكنني مساعدته. وعدته بالمحاولة وأعطيته رقم هاتفي، فقال أنه لا يمتلك هاتف ولا يوجد إلا تليفون واحد في القرية كلها، وأنني إذا كنت جادة في مساعدته عليّ أن أعود للقرية قبل شهر.
عدت مع تامر، وكنت أحدق في قناة المياه والطريق الزراعي فسألني عما أفكر فيه، فقلت أفكر في طريقة لمساعدة أهل القرية من كل شيء. فضحك وقال "أتعلمين، لستِ أول صحفية تزور المكان، لقد زار المكان صحفيين كُثُر من قبل، وما أنت فيه هو صدمة الزيارة الأولى فقط، ولكن، بمجرد عودتك لبيتك وحياتك، سيزول كل شيء"، فقلت بسرعة "لا.. لن أنسى" فضحك وقال "ستفعلين". فصمت حتى وصلنا ونزلت من السيارة وأعطيته الجنيهات العشرة الباقية في جيبي، فأخذها واستأذن ومشى.
سقطت قطرة على يدي فانتبهت أني أبكي، تذكرت كل صور هذه الواقعة وأنا جالسة في قلب غرفتي أحاول جذب أي ذكرى من الماضي تفسر لي هذا الصوت، لقد كان صوت الشاب العاشق، الذي وعدته بالمساعدة، كان هذا صوته وهو جالس على حافة الماء ينتظر أي أمل ويغني تعويذة تحمي حبيبته، لقد كنت الأمل بالنسبة له في لحظة، وخذلته دون أن أدرك فداحة ما فعلت. سلّمت الموضوع للجريدة وكنت في غاية التأثر، وفي اليوم التالي ذهبت للجريدة وبمجرد دخولي سألت السكرتير عن عدد اليوم، فأعطاني إياه وبحثت فيه بسرعة عن موضوعي، ووجدته في الصفحة السادسة، ولكنه كان دون اسم، وكان عكس ما كتبته تمامًا، كان موضوعًا عن قرية نموذجية ريفية تعيش في سلام وهدوء بعيد عن صخب العاصمة، مرفقا به تفاصيل كاذبة عن الصحة وسعادة أهل القرية وتأمينها. فغضبت ودخلت لرئيس التحرير ورميت الصحيفة في وجهه، كنت أشعر بغليان دمي، تحدثت وأنا غاضبة ومغتاظة وأبكي عن تدمير أحلام الناس في قرية فقيرة، وعن مرضى مساكين أصبح خطّ الفقر لهم حلم، ردّ رئيس التحرير باقتضاب أن هذا الموضوع لن يحقق أرباحًا بنشره، وأن غضبي أنا أهون بالطبع، وعليّ أن أختار الموضوعات "بعناية" كي لا أخسر عملي ومهنتي طول العمر. فمزقت أوراق الجريدة ونثرتها في الهواء، وما سقط منها على الأرض دسته بقدمي، وسببته بأمه وخرجت.
شغلني بعدها البحث عن عمل أو تدريب، وأثبت بها نفسي وعدت للمجال بقوة وخبرة، ولم أتذكر موضوع القرية وتامر إلا اليوم. وفكرّت أن ما حصل لي في الشهور الأخيرة هو ذنب خذلان العاشق الذي استغاث بي، والذي لا أعرف مصيره حتى الآن، ولا أعرف حتى اسمه، ولا أعرف كيف أصل إليه وإلى تامر بعد عشر سنوات.
في صباح اليوم التالي، كتبت آخر قصة صحفية في حياتي، وأرسلتها بالبريد الإليكتروني إلى كل الزملاء السابقين، الأصدقاء والحاقدين، وكل الصحف والوكالات التي عملت بها، وكل من خطر ببالي- أرسلت لك نسخة حينها على بريدك- كانت قصة "قرية العاشقين". وخرجت لأول مرة من شهور من البيت، وذهبت للبنك وسحبت كل أموالي التي جمعتها خلال سنوات، وذهبت لإحدى الجمعيات الخيرية وطلبت منها أن تنشئ وقفًا في هذه القرية لعلاج السرطان، وأخبرتهم عن مشكلة المياه فقالوا سيتفقدونها إذا كانت لاتزال موجودة فسيقومون بتوصيل مياه شرب نظيفة للقرية في أسرع وقت ممكن.
بعد أسبوعين، استجمعت شجاعتي وذهبت للقرية لأشهد بداية بناء الوقف، ذهبت متخفية في عباءة كما جئت أول مرة، وعندما وصلت وجدت القرية قد ازدادت فقرًا وموتًا، صحيح أنه دخلت بعض الهواتف النقالة وأطباق استقبال البث على أسطح البيوت، لكن الأهالي لازالوا مرضى. مشيت لقناة المياه أمام المسجد، فلم أجد أحدًا يجلس عندها، فجلست مكان الشاب الذي رأيته قبل أعوام، أفكر فيما جرى له، وهل تحوّل إلى شبح يغني لحبيبته المفقودة، وهل ظهر لي تحديدا لكي أساعده في استعادتها، أم لنسيانها، أو أنه فقط ضميري يؤنبني على ما مضى. فكرت وأنا أنظر لمياه الترعة الخضراء من أثر الشجر المحيط بها، وفي الأغنية الجميلة الحزينة التي باتت صديقتي.
كتبت لك يا صديقي، وأنا أعلم أنك تركت المهنة المتعبة، ولكن أحببت أن أعرفكما على بعض، لكي تعلم أن ذنب الخذلان سيلاحقك طوال عمرك إن ارتكبته، وأنت صحفي ممتاز وتستطيع أن تخدم العالم بعملك، وأن تنقذ الكثيرين من هذا المصير، على العالم أن يكون رحيمًا بالعشاق، وعلينا أن ندق الأجراس قبل أن يدهس المساكين في طريقه، كي لا يتحولوا إلى أشباح حزينة تتجول في الليل وتغني على ناي، العالم مليء بمثل هؤلاء، أتمنى يا صديقي أن يصلك الصوت، وأن تقع في غرامه مثلما فعلت، أنا أثق أنك ستفعل شيئًا، عد يا صديقي لساحة القتال التي تنتظر واحدًا من أفضل فرسانها، فربما تربتّ أفعالنا على كتف صاحب الناي الحزين وأمثاله، أينما كانوا.
جميع الحقوق محفوظة لمؤلفة القصة: بسمة العوفي
لقد اخترتك تحديدًا لأني أعرفك جيدًا، وأعرف قلبك الطيب، التقينا مرّات من قبل، ولم أخبرك أبدًا بإعجابي بذكاءك الحاد واجتهادك وأمانتك، أعرف أيضًا أن هناك من تكالب عليك لتترك مهنتك بسبب تحقيقك عن مواد كيماوية تصيب الأطفال بالسرطان واتضح أنها مافيا من كبار رجال الدولة، وأعرف أنك الآن تعمل موظفًا للعلاقات العامة بمصنع ملابس. ليس لدي شخص آخر يقوم بهذه المهمة غيرك، خاصة عندما علمت أنك تركت المهنة التي جمعتنا سويًا، ولكني أعلم أن قصة مثل هذه قد تعود بك إلى صفوف المقدمة، كما كنت دومًا.
سأبدأ من هناك.. في الصغر، كان لدي أفكار غريبة أحتفظ بها مثلما تحتفظ الجدّات بصندوق عتيق في دولاب ملابسهن، به صور وخطابات غرامية عندما كانوا عشاقّا، الفرق أن أفكاري أحتفظ بها من طفولتي، وأصدق بها تماما كلما كبرت.
مثلا، كان لدي قناعة بأن مروحة السقف لا تعمل بالكهرباء، بل إن جيراننا في الطابق الأعلى يتفرغ منهم شخص ليلفها بيده طوال الوقت، والجيران الأعلى منهم يلفونها لهم، وهكذا. وأؤمن بأن هناك أرنبًا يسكن القمر، لو دققت في الرسوم على سطح القمر في ليلة صافية لرأيته، أرنبًا جميلًا يقف أمام إناء يطبخ فيه جزر الأمنيات، وهو جزر برتقالي عادي من الذي تأكله الأرانب، لكنه مُحمّل بأمنيات البشر، وعندما ينتهي الأرنب من طهي الجزر، يرسله للعشاق المنتظرين آخر الليل ليحقق أمانيهم. ولطالما انتظرت هذا الأرنب وناديته، وودت أن يأتي ويلعب معي، أو أن أصعد للقمر وأساعده في الطهي، ولكن جزرة أمنيتي لم تأت بعد.
عندما كنت صغيرة، كنت أشك أن زميلتي في الفصل ذات العيون الخضراء، ترى كل شيء أخضر، وذات العيون الزرقاء ترى كل شيء أزرق، وعجبت حينها من لون عيوني الأسود، الذي أرى به الأشياء ملونة وليست بلون واحد. ولطالما عاملتهم كما القطط، أو هكذا اعتقدت، أنهن يرون كل شيء كأفلام الكرتون غير المجسمة، يرون الأجسام مسطحة ثنائية الأبعاد وبلون واحد، وكثيرا ما شعرت بالأسف لذلك لأنهم لا يرون جمال الكوكب.
أصدّق تماما في الثقب الأسود في الفضاء، وفي طيران طبق طائر فضائي فوق رؤوسنا دون أن نراه يفتح بابه فجأة ليشفط شخص ما لأعلى، وأن القطط تتحول في الليل إلى كائنات مرعبة، أشباح أو عفاريت، وأن مواءها هو بكاء أطفال تحولوا إلى قطط عندما رأوها في الليل، لذلك كانت أمي تنصحني دائما بألا أهشّ قطة في الليل كي لا أتحول مثلهم. وبأن هناك أناس سُخطوا إلى حيوانات وكائنات، قد يكون نبات أو شجرة أو طائر، لذا عليّ أن أحافظ على الروح بكل شكل كانت.
لطالما حدثت الهدهد الذي وقف على حافة شرفتي لسنوات، وظننت أنه هارب من عهد نبي الله سليمان، وأنه يستطيع أن ينقل إليّ الأخبار إذا تصادقنا، لكنه لم يمنحني الفرصة، وأكملت أنا سعيي وراء الأخبار وصرت صحفية كما تعلم. وتابعت بشغف قصة الحب بين اليمامتين الجالستين أعلى شباك الجيران في مكان سريّ أراه من شرفتي.
آمنت أن سمكة الرنجة الذهبية هي سمكة مقدسة لدى قدماء المصريين استطاعت عبور الزمن، لذا يأكلونها في الأعياد والمناسبات تعبيرًا عن فرحتهم، وأن ما بباطنها من بطارخ هي مولود جديد، كان سينتج عنه سمكة ذهبية جديدة، لولا أن العلم يقول أن الأسماك لا تلد. وعندما حكت لي صديقة قديمة أنها تخاطب النمل، وأمرت النمل أمامي أن يتحرك في اتجاه معاكس وفعل، صدقت أن النمل يسمع وينفذ ما تقوله، لكنها أفصحت عن سخريتها مني سريعًا، ولم أفهم لماذا سخرت رغم أن نبي الله كان يسمع النمل وهو بشر مثلنا.
حتى عندما كبرت، وسمعت سخرية الناس من أسطورة "النعل المقلوب" الذي يجلب النحس لأهل الشارع، ظللت كلما رأيت نعلًا في شارعنا أو أي شارع آخر عدلته. وكلما سقط رمش من عيني أو شعرة من وجهي علمت بأن أحدًا يفكر فيّ في هذه اللحظة، أما إذا تحشرج الماء في حلقي فهناك من يقول شيئًا عني. وإذا رأيت غرابًا في الصباح اتخذت حذري طوال اليوم من أي شيء قد يحدث. والدم الذي يظهر عند مغيب الشمس متناثر من مقصلة الغروب التي تأخذ أرواحًا ترسلها للعالم الآخر مع موكب الشمس الراحلة.
لماذا أحكي لك هذا؟ لأني وليعلم الله أني لست ساذجة، ولكني أصدق أن الحكايات والأساطير ليست من فراغ، لطالما استهوتني وبحثت عن أصلها حتى أفهمها. لي وجهة نظر في ما يحدث، وأحب البحث عن أصل الحكاية، ربما كان هذا سبب دخولي هذا المجال، لطالما سعيت وراء الدهشة، لأن ما من دخان إلا وراءه نار. ولهذا، أريدك يا صديقي أن تصدقني عندما أقول لك أني كنت أستمع إلى غناء في الليل، ولا أعرف مصدره، فهو ليس بصوت مسجّل أو آت عن جهاز إليكتروني، أسمع صوت حنون وهادئ، يغني كما يغني السندباد على سجادته وهو طائر في السماء بمفرده، يغني بكلمات غير مفهومة، أكاد أجنّ وألتقط واحدة منها، يغني بلغة أشبه باللغة الإيرانية التي أسمعها في الأفلام، لكن غناؤه حزين للغاية، وبلا مصدر محدد.
تفقدت كل غرف المنزل، وسألت الجيران كلهم عما إذا كان أحدًا يغني في الليل أو يسمعون ما أسمع، ولم ألحّ في سؤالي عندما رأيت نظرات مرتابة في أعينهم، تشكك في قواي العقلية، وأنا أمامهم صحفية وصاحبة عقل رزينة، تخوض المخاطر وتكشف الفساد وتظهر في التليفزيون ويصدر لها كتب لا يشترونها ولكن تعطيها لهم أمي كهدية من باب التفاخر وكيد بناتهن. ولكني، وأقسم لك، أني وقعت في غرام الصوت، ذلك الصوت المبحوح بحة حزينة ومؤلمة ومليئة بالشجن، كبحة صوت العاشقين المشتاقين عندما يتهالكون بسبب قوة أشواقهم. أكاد أشعر بأوتار قلبي ترتعش مع هزة حبال صوته، ويكاد جماله يذهب بعقلي كما تذهب النداهة بعقول الفلاحين، عفوًا لم أخبرك بتصديقي لأسطورة النداهة، لقد رأيت فلاحة مجذوبة ندهتها النداهة، والله رأيتها، وكانت تسير في الشوارع على غير هدى وبدون اتجاه، قد تقول أنت أنها سيدة مجنونة فقدت عقلها وهذا مرض، ولكني متأكدة أن الأمراض لا تأتي بكل هذا السحر، والشغف، والغواية، والمتعة، التي تسلب العقل، وأنا يا صديقي كدت أن أفقد عقلي من حلاوة الصوت، وأردت أن أعرف مصدره. أعترف أنه كان مزعجًا في البداية، وكنت أود التخلص منه لأنه يضعني في حالة حزينة تصل إلى حد البكاء الذي يلتهمني كما تفعل عجلات سيارة مسرعة مع أسفلت الطريق، ولكن، ربما التأقلم، أو لمحة الشجن الناعمة في الصوت، أو أن نقطة ضعفي هي رَجُل كَسَرَه الحب، تلك التي جعلتني ليلة بعد ليلة، من دراويشه.لم يقتصر الأمر على الليل، فصرت أسمعه في النهار، في العمل، في خلفية أي حديث مع أي شخص، أسمع هذه الكلمات المبهمة والموسيقى والأنّات كأنها وساوس، أو استغاثة آتية من بعيد جدًا، حتى أني استعذت بالله منها مرارًا فلم تذهب، وقلت أنه ربما كان شيطان يداعبني أو يؤرقني ولكن بلا فائدة، كان الصوت أجمل من أن يكون شيطانيًا، وكانت غوايته في براءته وصدقه، ومدى الحس المرهف الذي يطل من بين الكلمات غير المفهومة. فكرّت كثيرا في أن الأمر محض أسطورة من الأساطير التي أصدقها، هل هناك أساطير عن أشخاص مبحوحة أصواتهم يغنون في الليل؟ لم تصل إلى معلوماتي حتى الآن. وربما تقول أنت أنها محض هلاوس سمعية مرتبطة بمرض الفصام، أو كما يقول علماء التخاطر أنها نوع من الاستقبال الفائق للأصوات، والنداءات، تماما كما حلمت بغرق العبارة "السلام 98" وقت حدوثها بالضبط، وكما رأيت العديد من الحوادث والكوارث قبل وأثناء وقوعها. وإن صحّ ذلك فما تفسيرها وما أصلها؟ ولماذا يغني الصوت بكل هذا الحزن؟ لعلك تفهم الآن سبب وضعي لسمّاعات أذن طوال الوقت، لم أرغب في سماع الناس، وبدأت أختصر وأقتصر في الكلام على قدر ما أستطيع. أصبحت كتومة وصامتة أغلب الوقت، ومن يسألني أرد باختصار- لعلك جربت هذا عندما حاولت محادثتي أكثر من مرة- ومن يطلب مني شيء أفعله له كي أفرغ لنفسي، زحام الشوارع وأبواق السيارات والبائعين وكل هذا بات يصيبني بعصبية حادة، أضع سماعات طوال الوقت، ولا أشغل أي شيء، أنتظر فقط أن تلتقط أذني هذا الصوت، لعله، في يوم ما، يتضح.
أهملت عملي، وعندما ساءت حالتي خلال ستة أشهر تركته، وبعدما كنت اسمًا لامعًا يبشر بالخير في عالم الصحافة، سخر مني أصحاب الأقلام المزيفة والمعتادون على تلويث الحقائق. وقالوا أني فقدت عقلي من فرط تصديقي مهنيتي ووهم "الإعلام النزيه"، وبحثي عن الشرف والأمانة أدى بي إلى ذلك لأني لا أسير مع التيار. انقطعت عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وصرت مهووسة بهذا الصوت الآتي من حيث لا أدري.
انعزلت عن أسرتي وصرت أجلس في غرفتي لساعات طويلة ولا أخرج منها إلا لقضاء حاجة أو شرب الماء وتناول القليل من الطعام، ظنّ أهلي أن بي مرض، وجاءوا بطبيب للمنزل ليتفحص حالتي. قال لي الطبيب أن هناك غيوم على عقلي، وأن ظهري مُنحني كما لو كنت أحمل همّا ثقيلا على كتفيّ، وأن نظرات عيني الزائغة وشرودي المستمر يشير إلى أن هناك أمرًا عظيمًا يحتل تفكيري، وأن آلام مفاصلي وتصلّبها من الجلوس لساعات طويلة في برد الليل. وأخبرهم في النهاية أن لديّ سِرّ، وعليهم أن يكشفوه ويساعدوني قبل أن أتآكل تمامًا، وكتب لي روشتة علاج عبارة عن مسكن واسطوانات موسيقية لسليم سحاب!
ظن بي أهلي الظنون، من مشاكل بالعمل لعلاقة فاشلة لخسارة مال أو أصدقاء أو إحساس بالفشل أو الإدمان، لكن لم يكن هناك أعراض لأي مما سبق. لذا تعاملوا معي كأني مصابة بمسّ شيطاني، وقرأت أمي الكثير من الأذكار والأدعية والرقية الشرعية على رأسي، وكان صوت القرآن يملأ أركان بيتنا، وتذبح الذبائح وتذهب للمساجد، وكنت كما أنا، أقرأ كتب وأجلس في غرفتي جوار النافذة لأسمع الصوت، وأقضي الليل كله في شرفة غرفتي، أشرب قهوة وأنصت للصوت بكل حواسي حتى أغيب عن العالم وأنسى كل ما فيه، وأترنح مثل الدراويش الذين يسمعون الذِكر. لكي أكون صريحة، لم أرض عن نفسي تماما في هذه الحالة، لقد خسرت كل شيء من أجل شيء لا أعرفه، ولهذا، وهبت حياتي لهذا الصوت، وقررت أن الحال لن يكون أسوأ من ذلك، فلم يعد لديّ ما أخسره، وعاهدت نفسي أنه مهما طال بي العمر سأكتشف مصدره، وإن كان الثمن حياتي التي أفسدها. نذرت نفسي طوال عمري لكشف المجهول مهما طال الوقت، وأحببت المعرفة حتى وإن كانت نهايتي على يدها، لذا شغلت الكمبيوتر فورًا، وغرقت في بحور الإنترنت، قرأت كل ما لديّ من كتب تتحدث عن الأساطير الإغريقية والفرعونية والهندية والصينية والإفريقية، وغُصت في كل ما وقع تحت يدي، وبِتُّ أسهر الليالي بين الكتب والكمبيوتر، وفي النهار أجلس على الأرض لساعات في وسط الغرفة بستائرها المغلقة، وأحاول تخيل مصدر الصوت، هل هو لرجل؟ لمراهق؟ لشاب محبوس؟ لمحارب؟ لمعتقل؟ أضع كل الاحتمالات وأركبها على نغمة الصوت وأرى إن كانت تليق أم لا. ولكن بلا نتيجة.
هل استسلمت يا صديقي؟ أبدًا والله، قررت البحث في الماضي. فتحت كل أرشيف عملي في الصحافة من أول تدريب وأول خطّ بالقلم، وحتى الكتابة والعمل في كبرى الجرائد والقنوات التليفزيونية، كل قصة ذكرها لي معلميني، كل مستشفى أو مدرسة أو شخص قابلته أو سألته عن رأيه في الشارع، كل مكالمة تليفونية لمصدر، وكل لقاء مع حارس عقار أو مع وزير، مرّت أمامي ملايين الصور، كنت راضية عن أغلبها، إلا واحدة، أتذكرها جيدًا وكنت أضعها في خططي المستقبلية أن أحاول فعل شيء مهما طال الوقت.
كنت أتدرب حينها في إحدى الصحف عندما زرت قرية في منطقة نائية للغاية، لم يكن لها مواصلات إلا عربة نصف نقل، تمشي في طريق زراعي طويل، على يمينه خضرة لا متناهية وعلى يساره قناة مياة صغيرة. أعطيت للسائق الذي كان شابًا نحيلًا شديد اسمرار البشرة، في جلباب أخضر باهت متسخ عشرة جنيهات كانت نصف ما أملك حينها من مصروف جيبي، وطلبت منه أن يأخذني للقرية، فانطلق وسألني في الطريق عمن أكون، فأخبرته أني صحفية وأني آتية لعمل موضوع يخدم أهل القرية الفقراء. وسألته عن اسمه فسكت قليلًا وقال "تامر" وهو لا يبدو "تامر" أبدًا من لمعة الكذب التي بدت في عينيه وضحكة الاستهزاء على وجهه.
أخذني تامر إلى القرية، وبمجرد وصولنا وقف أمام أحد البيوت، ودخل وعاد بعد دقائق ومعه عباءة سوداء، وفردها أمامي وكانت مقطوعة من الظهر قطع صغير. كنت أرتدي بنطلون جينز أزرق وبلوزة خضراء، فأعطاني العباءة وأخبرني أن كل بنات القرية يرتدين مثلها، وإذا خالفتهن في الملبس لن يتحدث معي أحد، ولن أخرج بسلام. ففعلت ما طلبه، ومشينا في الشمس الحارقة بين البيوت الطينية، وكانت عكس ما تخيلت، فقيرة وميّتة، ليست بيوت ريفية جميلة كما ظننت، الممرات الصغيرة بينها تكاد تكون خالية، لا أطفال يلعبون بها، ولا بائعين، ولا رجال يجلسون ويشربون الشيشة على المصطبة، ولا نساء يبعن الطماطم والخيار والفجل والجرجير والخسّ.. أين أهل القرية؟ دقّ تامر على أحد الأبواب وفتحت سيدة ترتدي جلباب كحلي مزركش بالأصفر، ومنديل ملون لرأسها، دعتنا للدخول فدخلنا. واستأذنت لعمل كوبين من الشاي، وتركت طفلًا صغيرًا يلعب بطبق بلاستيك أمامنا، يسعل ويكح كل قليل.
لاحظ تامر نظرتي للطفل، فقال "كل أطفال القرية يعانون من السرطان والالتهاب الرئوي وأمراض في الأمعاء والدم"، سألته عن السبب، فدخلت السيدة تحمل صينية فضيّة صغيرة عليها كوبين من الشاي لونه أحمر باهت، وبجانبهما كوب به سائل أصفر، فسألتها ما هذا؟ فقالت "ماء". فاستغربت وسألتها عن لونه الغريب، فأوضحت أن كل أهل القرية يشربون هذا الماء الملوث لأنه لا يوجد غيره، وأنهم يشترونه بالجالون، لأنه لا توجد أنابيب توصل المياه للقرية، ولكن عربة تمر كل صباح فيأخذ كل بيت جالون بنصف جنيه.
أصابتني الصدمة بالخرس، واقترح تامر أن نذهب لمكان آخر، فمررنا أمام بيت صغير يدخله أناس كثيرين ويبدو فيه حركة غير طبيعية، قال أنه مصنع لإعادة تدوير القماش "الذي يرميه أولاد الذوات من ملابس وأغطية وفرش مستعمل، كله يأتي إلى هنا لنعيد تصنيعه وعمل سجّاد ومنتجات أخرى". وهناك قابلنا أحد معارف تامر، الذي حسب أني إحدى قريباته من قرية أخرى، ودعانا إلى حفل كتب كتاب إحدى بنات المصنع في المسجد بعد صلاة العصر.
استكملنا جولتنا في القرية صامتين، وسألت تامر عن الخرافات التي يصدق فيها أهل القرية، فقال بالطبع النداهة، فهي أسطورة ريفية أصيلة، وكذلك "خيال المآتة" الخشبي الذي يقف فاردًا ذراعاته بين الحقول، يصدقون بأنه يتحول ليلا إلى رجل حقيقي من لحم ودم، أما الأسطورة المرتبطة أكثر بالقرية فهم يرون أشباحا يشبهون أهل القرية الذين غادروها لأسباب كثيرة، يجلسون على شاطئ الترعة أو يتجولون في الحقول، ويعتقدون أنهم كانوا واقعين في حب بنات من القرية ولم يستطيعوا الزواج منهن، فتحولن إلى أشباح. ولكل حبيبة شبح يغني لها أغنيتها. واستكمل "البنات هنا إن كان حظها جيد يتزوجن أصحاب المصانع وأبناءهن، أو يوردوهن لخارج القرية للعمل كخادمات، أو يتزوجن ثري عربي لأسبوع أو اثنين، أما سيئات الحظ فيتزوجن خريجي السجون والهاربين منها، نسيت أن أخبرك أن المنطقة مليئة بهم كونها بعيدة عن الأنظار".
حضرنا مراسم كتب الكتاب بعد العصر، ورأيت العروس النحيلة ترتدي فستانًا ورديًا واسعًا ومتهدل الأكمام، تساقطت منه اللالئ والزركشات وبقي منها القليل، ووضعت طرحة بيضاء على رأسها مع أحمر شفاه ثقيل وكحل قويّ حول العينين الشاردة. وسط تصفيق أهلها وصديقاتها، سمعت صوت نغم حزين فاستغربته، وخرجت لأرى ما يحدث. كان أمام المسجد ممر مياه صغير جلس على حافته شاب صاحب الصوت ومعه ناي، قال لي تامر أنه حبيب هذه الفتاة منذ أعوام، لكنه ككل شباب القرية، فقير ومريض بالسرطان وأمراض أخرى، واحتمالية حياته وتحسن ظروف حياته ضئيلة للغاية، واعتاد أهل القرية على ذلك، مع كل زواج لفتاة يجلس حبيبها خارج الفرح، يبكيها، وينشد فيها أغاني فلكلورية من أغانيهم، ويعزف لها لحنًا على الناي، بلهجتهم الريفية، يقولون أنها تحمي الحبيبة أينما ذهبت، يتركوه هكذا إما ينساها أو يفقد عقله، أو يغادر القرية بلا رجعة.
اقتربت من الشاب وربتّ على كتفه، فنظر إليَّ بعينين دامعتين، وسأل تامر عني، فقال له أني ضيفة من ضيوف القرية وأني أعمل صحفية، فهبّ من مكانه وأمسك ذراعي وقال "ساعديني.. أرجوكِ". فسألته "كيف؟" قال "أريد فرصة عمل.. أريد إنقاذها، أريد أن أدخل مستشفى وأتعالج وأجد عمل أكسب منه قوت يومي ليرضى بي أهل حبيبتي، أرجوك، سأكون خادمك طوال العمر، سأفعل أي شيء تريدين، لا تتركيها تتزوج، أرجوكِ". "لكنها تتزوج الآن بالفعل!" قلت، فأخبرني أنه لازال هناك وقت حتى موعد الزفاف، وأنه يمكنني مساعدته. وعدته بالمحاولة وأعطيته رقم هاتفي، فقال أنه لا يمتلك هاتف ولا يوجد إلا تليفون واحد في القرية كلها، وأنني إذا كنت جادة في مساعدته عليّ أن أعود للقرية قبل شهر.
عدت مع تامر، وكنت أحدق في قناة المياه والطريق الزراعي فسألني عما أفكر فيه، فقلت أفكر في طريقة لمساعدة أهل القرية من كل شيء. فضحك وقال "أتعلمين، لستِ أول صحفية تزور المكان، لقد زار المكان صحفيين كُثُر من قبل، وما أنت فيه هو صدمة الزيارة الأولى فقط، ولكن، بمجرد عودتك لبيتك وحياتك، سيزول كل شيء"، فقلت بسرعة "لا.. لن أنسى" فضحك وقال "ستفعلين". فصمت حتى وصلنا ونزلت من السيارة وأعطيته الجنيهات العشرة الباقية في جيبي، فأخذها واستأذن ومشى.
سقطت قطرة على يدي فانتبهت أني أبكي، تذكرت كل صور هذه الواقعة وأنا جالسة في قلب غرفتي أحاول جذب أي ذكرى من الماضي تفسر لي هذا الصوت، لقد كان صوت الشاب العاشق، الذي وعدته بالمساعدة، كان هذا صوته وهو جالس على حافة الماء ينتظر أي أمل ويغني تعويذة تحمي حبيبته، لقد كنت الأمل بالنسبة له في لحظة، وخذلته دون أن أدرك فداحة ما فعلت. سلّمت الموضوع للجريدة وكنت في غاية التأثر، وفي اليوم التالي ذهبت للجريدة وبمجرد دخولي سألت السكرتير عن عدد اليوم، فأعطاني إياه وبحثت فيه بسرعة عن موضوعي، ووجدته في الصفحة السادسة، ولكنه كان دون اسم، وكان عكس ما كتبته تمامًا، كان موضوعًا عن قرية نموذجية ريفية تعيش في سلام وهدوء بعيد عن صخب العاصمة، مرفقا به تفاصيل كاذبة عن الصحة وسعادة أهل القرية وتأمينها. فغضبت ودخلت لرئيس التحرير ورميت الصحيفة في وجهه، كنت أشعر بغليان دمي، تحدثت وأنا غاضبة ومغتاظة وأبكي عن تدمير أحلام الناس في قرية فقيرة، وعن مرضى مساكين أصبح خطّ الفقر لهم حلم، ردّ رئيس التحرير باقتضاب أن هذا الموضوع لن يحقق أرباحًا بنشره، وأن غضبي أنا أهون بالطبع، وعليّ أن أختار الموضوعات "بعناية" كي لا أخسر عملي ومهنتي طول العمر. فمزقت أوراق الجريدة ونثرتها في الهواء، وما سقط منها على الأرض دسته بقدمي، وسببته بأمه وخرجت.
شغلني بعدها البحث عن عمل أو تدريب، وأثبت بها نفسي وعدت للمجال بقوة وخبرة، ولم أتذكر موضوع القرية وتامر إلا اليوم. وفكرّت أن ما حصل لي في الشهور الأخيرة هو ذنب خذلان العاشق الذي استغاث بي، والذي لا أعرف مصيره حتى الآن، ولا أعرف حتى اسمه، ولا أعرف كيف أصل إليه وإلى تامر بعد عشر سنوات.
في صباح اليوم التالي، كتبت آخر قصة صحفية في حياتي، وأرسلتها بالبريد الإليكتروني إلى كل الزملاء السابقين، الأصدقاء والحاقدين، وكل الصحف والوكالات التي عملت بها، وكل من خطر ببالي- أرسلت لك نسخة حينها على بريدك- كانت قصة "قرية العاشقين". وخرجت لأول مرة من شهور من البيت، وذهبت للبنك وسحبت كل أموالي التي جمعتها خلال سنوات، وذهبت لإحدى الجمعيات الخيرية وطلبت منها أن تنشئ وقفًا في هذه القرية لعلاج السرطان، وأخبرتهم عن مشكلة المياه فقالوا سيتفقدونها إذا كانت لاتزال موجودة فسيقومون بتوصيل مياه شرب نظيفة للقرية في أسرع وقت ممكن.
بعد أسبوعين، استجمعت شجاعتي وذهبت للقرية لأشهد بداية بناء الوقف، ذهبت متخفية في عباءة كما جئت أول مرة، وعندما وصلت وجدت القرية قد ازدادت فقرًا وموتًا، صحيح أنه دخلت بعض الهواتف النقالة وأطباق استقبال البث على أسطح البيوت، لكن الأهالي لازالوا مرضى. مشيت لقناة المياه أمام المسجد، فلم أجد أحدًا يجلس عندها، فجلست مكان الشاب الذي رأيته قبل أعوام، أفكر فيما جرى له، وهل تحوّل إلى شبح يغني لحبيبته المفقودة، وهل ظهر لي تحديدا لكي أساعده في استعادتها، أم لنسيانها، أو أنه فقط ضميري يؤنبني على ما مضى. فكرت وأنا أنظر لمياه الترعة الخضراء من أثر الشجر المحيط بها، وفي الأغنية الجميلة الحزينة التي باتت صديقتي.
كتبت لك يا صديقي، وأنا أعلم أنك تركت المهنة المتعبة، ولكن أحببت أن أعرفكما على بعض، لكي تعلم أن ذنب الخذلان سيلاحقك طوال عمرك إن ارتكبته، وأنت صحفي ممتاز وتستطيع أن تخدم العالم بعملك، وأن تنقذ الكثيرين من هذا المصير، على العالم أن يكون رحيمًا بالعشاق، وعلينا أن ندق الأجراس قبل أن يدهس المساكين في طريقه، كي لا يتحولوا إلى أشباح حزينة تتجول في الليل وتغني على ناي، العالم مليء بمثل هؤلاء، أتمنى يا صديقي أن يصلك الصوت، وأن تقع في غرامه مثلما فعلت، أنا أثق أنك ستفعل شيئًا، عد يا صديقي لساحة القتال التي تنتظر واحدًا من أفضل فرسانها، فربما تربتّ أفعالنا على كتف صاحب الناي الحزين وأمثاله، أينما كانوا.
جميع الحقوق محفوظة لمؤلفة القصة: بسمة العوفي
Published on February 11, 2016 14:29
January 25, 2016
كم تدفع لهذه العاهرة؟
تنويه: كل الأحداث المذكورة في هذا المقال حقيقية
1- "كنت في الأهرامات ورغبت أن أركب حصانًا، لم يكن معي أحد، وكان المنظر جميلًا، وعرض عليّ أحد الأشخاص ركوب حصان بسعر زهيد جدًا، قرابة 20 جنيه، وبالطبع كنت أعلم أنه ليس سعرًا حقيقيًا، ولكني وافقت على أمل أن يكون إجمالي الدفع 50 أو 100 جنيه على الأكثر، وأخذني الرجل على ظهر الحصان وبدأنا نمشي نحو الصحراء، وعرض عليّ أن يجعل الحصان يركض، ولأني غير محترفة، فقد عرض عليّ أن يركب خلفي لكي يتحكم في الحصان، وفعل، وعندما بدأ الحصان بالركض، وجدت يده تتحرك لتتحرش بي، حاولت الصراخ ولكن من يسمعني في هذا الخلاء؟ ولكن مع تكرار صراخي ومحاولاتي للتملص منه توقف، ونزلت فورًا من على الحصان، وكنا في قلب الصحراء، لا شبكة موبايل ولا شرطة سياحة، وقال أنني يجب أن أدفع 300 جنيه لكي يعود بي من حيث أتينا، وإلا سيتركني حيثما أنا، خفت من أن يتطور الأمر، قلت له أنني سأدفع عندما نصل، لكنه رفض، أخرجت كل الأموال التي في جيبي، وكانوا قرابة 250 جنيه مصري و10 دولار، أعطيته المال، وعاد بي من حيث أتينا، تعرفين، فكرت في أن أبلغ الشرطة، لكني عندما التفت كان ذلك الشخص مع زملاءه ضاحكًا، لذلك فضلت المشي بأقصى سرعة ممكنه، كنت خائفة، كنت خائفة حقًا، لن أنسى أبدًا ذلك.
2- كنت في وسط البلد مع صديقي أفكر في شراء بعض الهدايا التذكارية، ودخلت أكثر من محل، وفي المحل الأخير أعجبني شيء فعلا، ولكن لم يكن معي المال الكافي لشراؤه، فقلت للبائع أني سأذهب للفندق لآتي بالمال وأعود، وخرجنا من المحل أنا وصديقي، وشعرت بشخص يسير خلفنا، ووجدته عامل من المحل الذي كنا فيه، في البداية ظننته لص، لكنه سار خلفنا لمدة 20 دقيقة، حتى وقفت فجأة ونظرت في عينه وسألته "لماذا تلاحقني؟!" قال أن صاحب المحل أرسله ليتأكد من أننا سنعود، ولكني لم أعد أبدًا.
3- التجار ليس لديهم عملات صغيرة. لقد اشتريت الكثير من الأشياء، من المطار والأسواق، وعندما أدفع وأنتظر بقية نقودي، يقول لي البائع أنه لا يمتلك عملات صغيرة "فكة" لكي يعيد لي الباقي، فالسلعة التي أشتريها بـ 70 جنيه مصري، أدفع ثمنها 100!.
4- انتهيت من العمل مع زميل أجنبي، وكان يريد رؤية خان الخليلي قبل سفره، هو في الستين من عمره وأنا امرأة في نصف عمره تقريبًا، رحبت بالفكرة وذهبنا، بمجرد دخولنا المنطقة قام أحد الأشخاص بوضع قبعة على رأسه عليها نقوش فرعونية، أخبره أنها هدية، ودعاه ليدخل المحل ولم يعجبه شيء، وعند الخروج طالبه البائع بدفع ثمن القبعة "الهدية". استغرب وردها إليه لأنه لم يطلبها من الأساس، لكن صاحب المحل قال أنها كانت هدية للتجربة فقط! وأن رائحتها تغيرت وتشممت عرقه لذلك يجب أن يدفع ثمنها، رفض وتركها ومشينا وتلحقنا الشتائم. بعد قليل وجدنا شخصًا يمشي خلفنا، اشترى زميلي بعض الأشياء وواصلنا المشي، وبدأت في سماع ألفاظ كذبتها في البداية. حاول أحدهم جذبه من ناحيه ليرى بضاعة رغمًا عنه، وسمعت أحدهم يوجه إليّ الكلام ويقول "كم يدفع لكِ في الساعة؟ أليس أولاد بلدك أولى من الأجانب؟" ثم هتف أحدهم بالإنجليزية "هاي، أيها الزائر.. كم تدفع لهذه العاهرة؟" وضحكوا جميعًا. نظرنا لبعضنا البعض، وقررنا الابتعاد عن المكان فورًا، تأسف لي زميلي يومها على ما تعرضت له من إهانة، وتأسفت له بسبب ما حدث وإفساد ساعاته الأخيرة قبل السفر.
الصناعة المحلية للإرهاب
عندما أطلقت وزارة السياحة المصرية حملة كبرى لتنشيطها مرة أخرى، فرحت وقلقت في نفس الوقت، لأن الأحداث في مصر كثيرة وغير متوقعة، فالحظ يقابلنا أحيانًا - كما في حفل الموسيقار العالمي يانّي الذي كان له صدى جيد بالفعل- أو يذهب عنّا أحيانًا كثيرة - مثل سقوط الطائرة الروسية بعد الحفل بأيام!. لكن لا يصح أن نلقي باللوم كله على الحظ، لأن هناك حظًا آخر نصنعه بأيدينا.
مثلًا تقول صديقتي المتزوجة من رجل أجنبي أن زوجها دائمًا ما يقول لها "لديكم بحرين ونيل وشمس وطقس جيد وآثار ليس لها مثيل في العالم.. بالتأكيد أنتم تفسدون بلادكم عن قصد كي لا يأتي الناس من كل الكوكب للعيش هنا!". وأنا آمنت تمامًا بصحة هذه المقولة، فإذا كانت الظروف سيئة، وإذا كان العالم متآمر علينا، والإرهاب يحاصرنا من كل جانب، فماذا فعلنا نحن؟ وما الذي نفعله نحن لنغيّر هذا الوضع؟ الإجابة أننا صنعنا إرهابًا محليًا، بدأ صغيرًا بالتحرش ببنات وأبناء البلد، وانتهى كبيرًا بالتحرش بأي شخص، وأي نوع، وأي جنسية، وأي جنس. وكأن الـ 99.3 % نسبة التحرش بالنساء في مصر - وفق أحدث دراسة للأمم المتحدة للمرأة في 2015 - لا تكفينا!. وإلى جانب التحرش، فهناك الفهلوة، والقيادة الجنونية بالشوارع، والنصب، والإبلاغ عن السياح لمجرد الاشتباه بهم!. جعلنا السائح يخاف من الناس قبل الأحداث، لأنه يعلم أنه قد يتم الإبلاغ عنه لأنه جاسوس، أو لأنه كان يلتقط صورة لم تعجب "مواطنًا شريفًا"، أو للاغتصاب والانتهاك الجنسي.
اقترح أحد أصدقائي حل أذكى، وهو استثمار الظروف السيئة والترويج مثلًا لسياحة المخاطر! وتكون صيغة الإعلانات السياحية "إذا كنت ترغب في مغامرة تحبس أنفاسك.. ترغب أن تعيش في دور المشكوك فيه، أو أن يتم اختطافك والتحرش بك، وأن تختبر نفسك وقدراتك في الدفاع عن النفس، تعال إلينا.. هنا تعيش المغامرة كاملة". أعتقد أن هذه الصيغة أفضل من أن "تغري الزبون" بشيء ويصل ليجده شيء آخر!.
هذه هي مصر.. حقًا؟!
الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة بوسم "هذه هي مصر ThisIsEgypt" والتي سببت جدلًا كبيرًا بسبب نشر صور سياحية وصور وأخرى شاركها الجمهور من واقعهم، لم تكن مشكلتها مجرد صور تم تحريرها بالفوتوشوب وأخرى لم تخضع لذلك. لم تكن مشكلتها أن الإعلان يبيع سلعة غير التي تظهر في الإعلان. بنفس طريقة العاهرة في فيلم "الإرهاب والكباب" عندما قالت أن دورها "إغراء الزبون" فقط، وعندما يقع في الفخ، يجد فتاة أقل جمالًا.
لدينا نهر النيل، ولكن الناس القوارب تغرق فيه ولا تجد من ينتشل الجثث، ولدينا الأهرامات من عجائب الدنيا السبع، ولكن الشيء العجيب الثامن أن نهمل كل هذا، ونلقي اللوم على الآخرين، ولكننا نحن الآخرين. كنت أرغب أن أجد حلًا آخر لكن للأسف لا يوجد سائق تاكسي فضائي يستقبل السائح بالمطار مثلًا! كما لم أعثر على كائنات من المريخ تحاول النصب عليه، وبالطبع لا يوجد بشر من كوكب زحل يتحرشون بهم!
أعلم أن مصر ممتلئة بالأشخاص المحترفين في مجال السياحة، وأعلم أن كثير من المصريين يتوددون للسياح ويعاملونهم بمنتهى اللطف والكرم ولا ينتظرون مقابلًا أو شكرًا على ذلك وهذه عاداتنا. ولذلك أطلب من المختصين أن يقوموا بتدريب وتأهيل العاملين في المجال، والتصدي لأي جرائم بشكل صريح وحاسم. فإذا كان الوضع سيء لظروف خارجة عن إرادتنا، فلنقوم بتحسين ما هو متاح في أيدينا، فالناس أفضل سفراء لبلادهم، وحسن أخلاقهم وكرمهم أفضل من ألف إعلان سياحي. وقبل أن نعامل السياح كفريسة والسائحات كعاهرات، نفكر كم نكسب من مجيئهم، فلنفكر في ما يكسبوه هم من المجيء إلينا، وما يميزنا عن غيرنا، واستثمار وجودهم في عودة الحياة والعمل لقطاع كبير ممن فقدوا وظائفهم بسبب الركود.
صحيح أن بلادنا جنة لا مثيل لها في أي مكان في الأرض، وآثارنا نادرة وترابنا ذهب، لكن هذه المشكلة ستقضي على أيّة محاولات للنهوض بها، لأنه كما يقول المثل الشعبي "الجنة من غير ناس، ما تنداس".
1- "كنت في الأهرامات ورغبت أن أركب حصانًا، لم يكن معي أحد، وكان المنظر جميلًا، وعرض عليّ أحد الأشخاص ركوب حصان بسعر زهيد جدًا، قرابة 20 جنيه، وبالطبع كنت أعلم أنه ليس سعرًا حقيقيًا، ولكني وافقت على أمل أن يكون إجمالي الدفع 50 أو 100 جنيه على الأكثر، وأخذني الرجل على ظهر الحصان وبدأنا نمشي نحو الصحراء، وعرض عليّ أن يجعل الحصان يركض، ولأني غير محترفة، فقد عرض عليّ أن يركب خلفي لكي يتحكم في الحصان، وفعل، وعندما بدأ الحصان بالركض، وجدت يده تتحرك لتتحرش بي، حاولت الصراخ ولكن من يسمعني في هذا الخلاء؟ ولكن مع تكرار صراخي ومحاولاتي للتملص منه توقف، ونزلت فورًا من على الحصان، وكنا في قلب الصحراء، لا شبكة موبايل ولا شرطة سياحة، وقال أنني يجب أن أدفع 300 جنيه لكي يعود بي من حيث أتينا، وإلا سيتركني حيثما أنا، خفت من أن يتطور الأمر، قلت له أنني سأدفع عندما نصل، لكنه رفض، أخرجت كل الأموال التي في جيبي، وكانوا قرابة 250 جنيه مصري و10 دولار، أعطيته المال، وعاد بي من حيث أتينا، تعرفين، فكرت في أن أبلغ الشرطة، لكني عندما التفت كان ذلك الشخص مع زملاءه ضاحكًا، لذلك فضلت المشي بأقصى سرعة ممكنه، كنت خائفة، كنت خائفة حقًا، لن أنسى أبدًا ذلك.
2- كنت في وسط البلد مع صديقي أفكر في شراء بعض الهدايا التذكارية، ودخلت أكثر من محل، وفي المحل الأخير أعجبني شيء فعلا، ولكن لم يكن معي المال الكافي لشراؤه، فقلت للبائع أني سأذهب للفندق لآتي بالمال وأعود، وخرجنا من المحل أنا وصديقي، وشعرت بشخص يسير خلفنا، ووجدته عامل من المحل الذي كنا فيه، في البداية ظننته لص، لكنه سار خلفنا لمدة 20 دقيقة، حتى وقفت فجأة ونظرت في عينه وسألته "لماذا تلاحقني؟!" قال أن صاحب المحل أرسله ليتأكد من أننا سنعود، ولكني لم أعد أبدًا.
3- التجار ليس لديهم عملات صغيرة. لقد اشتريت الكثير من الأشياء، من المطار والأسواق، وعندما أدفع وأنتظر بقية نقودي، يقول لي البائع أنه لا يمتلك عملات صغيرة "فكة" لكي يعيد لي الباقي، فالسلعة التي أشتريها بـ 70 جنيه مصري، أدفع ثمنها 100!.
4- انتهيت من العمل مع زميل أجنبي، وكان يريد رؤية خان الخليلي قبل سفره، هو في الستين من عمره وأنا امرأة في نصف عمره تقريبًا، رحبت بالفكرة وذهبنا، بمجرد دخولنا المنطقة قام أحد الأشخاص بوضع قبعة على رأسه عليها نقوش فرعونية، أخبره أنها هدية، ودعاه ليدخل المحل ولم يعجبه شيء، وعند الخروج طالبه البائع بدفع ثمن القبعة "الهدية". استغرب وردها إليه لأنه لم يطلبها من الأساس، لكن صاحب المحل قال أنها كانت هدية للتجربة فقط! وأن رائحتها تغيرت وتشممت عرقه لذلك يجب أن يدفع ثمنها، رفض وتركها ومشينا وتلحقنا الشتائم. بعد قليل وجدنا شخصًا يمشي خلفنا، اشترى زميلي بعض الأشياء وواصلنا المشي، وبدأت في سماع ألفاظ كذبتها في البداية. حاول أحدهم جذبه من ناحيه ليرى بضاعة رغمًا عنه، وسمعت أحدهم يوجه إليّ الكلام ويقول "كم يدفع لكِ في الساعة؟ أليس أولاد بلدك أولى من الأجانب؟" ثم هتف أحدهم بالإنجليزية "هاي، أيها الزائر.. كم تدفع لهذه العاهرة؟" وضحكوا جميعًا. نظرنا لبعضنا البعض، وقررنا الابتعاد عن المكان فورًا، تأسف لي زميلي يومها على ما تعرضت له من إهانة، وتأسفت له بسبب ما حدث وإفساد ساعاته الأخيرة قبل السفر.
الصناعة المحلية للإرهاب
عندما أطلقت وزارة السياحة المصرية حملة كبرى لتنشيطها مرة أخرى، فرحت وقلقت في نفس الوقت، لأن الأحداث في مصر كثيرة وغير متوقعة، فالحظ يقابلنا أحيانًا - كما في حفل الموسيقار العالمي يانّي الذي كان له صدى جيد بالفعل- أو يذهب عنّا أحيانًا كثيرة - مثل سقوط الطائرة الروسية بعد الحفل بأيام!. لكن لا يصح أن نلقي باللوم كله على الحظ، لأن هناك حظًا آخر نصنعه بأيدينا.
مثلًا تقول صديقتي المتزوجة من رجل أجنبي أن زوجها دائمًا ما يقول لها "لديكم بحرين ونيل وشمس وطقس جيد وآثار ليس لها مثيل في العالم.. بالتأكيد أنتم تفسدون بلادكم عن قصد كي لا يأتي الناس من كل الكوكب للعيش هنا!". وأنا آمنت تمامًا بصحة هذه المقولة، فإذا كانت الظروف سيئة، وإذا كان العالم متآمر علينا، والإرهاب يحاصرنا من كل جانب، فماذا فعلنا نحن؟ وما الذي نفعله نحن لنغيّر هذا الوضع؟ الإجابة أننا صنعنا إرهابًا محليًا، بدأ صغيرًا بالتحرش ببنات وأبناء البلد، وانتهى كبيرًا بالتحرش بأي شخص، وأي نوع، وأي جنسية، وأي جنس. وكأن الـ 99.3 % نسبة التحرش بالنساء في مصر - وفق أحدث دراسة للأمم المتحدة للمرأة في 2015 - لا تكفينا!. وإلى جانب التحرش، فهناك الفهلوة، والقيادة الجنونية بالشوارع، والنصب، والإبلاغ عن السياح لمجرد الاشتباه بهم!. جعلنا السائح يخاف من الناس قبل الأحداث، لأنه يعلم أنه قد يتم الإبلاغ عنه لأنه جاسوس، أو لأنه كان يلتقط صورة لم تعجب "مواطنًا شريفًا"، أو للاغتصاب والانتهاك الجنسي.
اقترح أحد أصدقائي حل أذكى، وهو استثمار الظروف السيئة والترويج مثلًا لسياحة المخاطر! وتكون صيغة الإعلانات السياحية "إذا كنت ترغب في مغامرة تحبس أنفاسك.. ترغب أن تعيش في دور المشكوك فيه، أو أن يتم اختطافك والتحرش بك، وأن تختبر نفسك وقدراتك في الدفاع عن النفس، تعال إلينا.. هنا تعيش المغامرة كاملة". أعتقد أن هذه الصيغة أفضل من أن "تغري الزبون" بشيء ويصل ليجده شيء آخر!.
هذه هي مصر.. حقًا؟!
الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة بوسم "هذه هي مصر ThisIsEgypt" والتي سببت جدلًا كبيرًا بسبب نشر صور سياحية وصور وأخرى شاركها الجمهور من واقعهم، لم تكن مشكلتها مجرد صور تم تحريرها بالفوتوشوب وأخرى لم تخضع لذلك. لم تكن مشكلتها أن الإعلان يبيع سلعة غير التي تظهر في الإعلان. بنفس طريقة العاهرة في فيلم "الإرهاب والكباب" عندما قالت أن دورها "إغراء الزبون" فقط، وعندما يقع في الفخ، يجد فتاة أقل جمالًا.
لدينا نهر النيل، ولكن الناس القوارب تغرق فيه ولا تجد من ينتشل الجثث، ولدينا الأهرامات من عجائب الدنيا السبع، ولكن الشيء العجيب الثامن أن نهمل كل هذا، ونلقي اللوم على الآخرين، ولكننا نحن الآخرين. كنت أرغب أن أجد حلًا آخر لكن للأسف لا يوجد سائق تاكسي فضائي يستقبل السائح بالمطار مثلًا! كما لم أعثر على كائنات من المريخ تحاول النصب عليه، وبالطبع لا يوجد بشر من كوكب زحل يتحرشون بهم!
أعلم أن مصر ممتلئة بالأشخاص المحترفين في مجال السياحة، وأعلم أن كثير من المصريين يتوددون للسياح ويعاملونهم بمنتهى اللطف والكرم ولا ينتظرون مقابلًا أو شكرًا على ذلك وهذه عاداتنا. ولذلك أطلب من المختصين أن يقوموا بتدريب وتأهيل العاملين في المجال، والتصدي لأي جرائم بشكل صريح وحاسم. فإذا كان الوضع سيء لظروف خارجة عن إرادتنا، فلنقوم بتحسين ما هو متاح في أيدينا، فالناس أفضل سفراء لبلادهم، وحسن أخلاقهم وكرمهم أفضل من ألف إعلان سياحي. وقبل أن نعامل السياح كفريسة والسائحات كعاهرات، نفكر كم نكسب من مجيئهم، فلنفكر في ما يكسبوه هم من المجيء إلينا، وما يميزنا عن غيرنا، واستثمار وجودهم في عودة الحياة والعمل لقطاع كبير ممن فقدوا وظائفهم بسبب الركود.
صحيح أن بلادنا جنة لا مثيل لها في أي مكان في الأرض، وآثارنا نادرة وترابنا ذهب، لكن هذه المشكلة ستقضي على أيّة محاولات للنهوض بها، لأنه كما يقول المثل الشعبي "الجنة من غير ناس، ما تنداس".
Published on January 25, 2016 15:05
10 خطوات عشان تظهر كشخص مثقف.. التاسعة ستبهرك
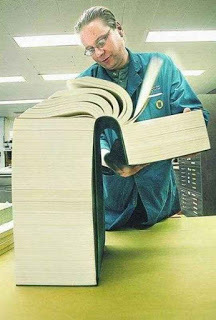
1- صوّر الكتب الجديدة اللي بتلاقيها في سكتك، وطبعا لازم تكون الكتب دي حديث السوشيال ميديا عشان تبان مواكب للأحداث، مش لازم تقراها بس لازم تصورها كتير، وانستجرام بقى بصورك وانت بتقرأ ومش واخد بالك.
2- اتكلم كتير عن إن الكتب خاربة بيتك ومضيع فلوسك عليها، مش لازم تشتريها بس لازم تقول كده.
3- شيّر اقتباسات واعمل قلوب فوقها، ولازم تحط هاشتاج في آخر كل جملة، حاجات زي#في_عشق_القراءة
heart emoticon 4- عارف محل النمرسي بتاع الترتر؟ أو الشيف شربيني وهو بيحط متزاريلا على أي أكل؟ اعمل زيّه مع التشكيل.. امسك حبة كده في إيدك ورشّهم على الكلام، مش مهم يكون تشكيل الحروف والكلمات مظبوط، بس اكتب بتشكيل أي كلام، فانت مثلا ممكن تكتب "القَرْعٌ لًمَا اسّتُوِى قُالِ للخًيارْ يًا لٌوبِيًا".. التشكيل بيدي هيبة كده ويحسس اللي قدامك إن الكلام مهم.
5- لما تلاقي حد معجب بكتاب انت متعرفوش، قوله لالالالا مش حلو خالص، ولما يسألك عن رأيك فيه، قوله "لا تعليق" ولازم تقولها بجد كده كأنك قرفان.
6- بقية النقطة السابقة، لما تلاقي حد بيقرأ رواية، اضحك، ولما يسألك بتقرأ إيه حاليًا، عرفه انك بتقرأ كتاب معقد جدًا عن "الراديكالية الاستراتيجية والمؤامرة الصهيونية في لفّ ورق العنب"، ولما يسألك يعني ايه، بص له باستخفاف كده مع ضحكة خفيفة وخد تنهيدة كده (ولازم يكون فيها هوا) وقوله "لما تكبر هقولك".
7- لو في واحد عنده فولورز كتير وبيكتب أي قلش، وجات سيرته قدامك، قول "ده صديقي"، اوعى تقول "صاحبي"، المثقف مبيقولش "صاحبي"، لازم "صديقي"، ومثلا لو هو اسمه محمد أحمد لازم تضيف انت، وتقول "على فكرة اسمه الحقيقي محمد سيد أحمد" واتكّ على السين، واتكلم عن آخر بوستات كتبها وقد إيه كانت عبقرية وانه كتبها وانتوا سوا "بتتصعلكوا في شوارع القاهرة الكئيبة".
8- اكتب بوستات طويلة، مش مهم جايبها منين، مش مهم بتقول إيه، ممكن تدخل أي منتدى وتجيب أي حوار وتاخده كوبي وتحطه على صفحتك، ولازم في آخر البوست تكتب هاشتاج باسمك عشان الأشرار ميسرقوش تعبك وكتابتك.
9- ستبهرك
10- جمع أي هري هريته طول حياتك واعمل كتاب في معرض الكتاب، مش كتاب في أي وقت، لأ لازم يكون في المعرض، وقول لأصحابك اللي عندهم صفحات كبيرة يشيروا ويكتبوا عن أعظم كتاب جه البشرية، واعمل حسابات مزيفة وادخل اشكر في نفسك، وبعد يومين بالظبط من صدور الكتاب، ادخل اشكر جمهورك على بيع الطبعة العشرين واكتب انك متردد تجهز الـ 21، وسيبهم يتحايلوا عليك شوية.
Published on January 25, 2016 14:54
December 3, 2015
غرام في المقبرة
كانت أول مرة رأيت صورته في كتاب مدرسي، صورة شاحبة فقيرة الألوان، لكنها جميلة، مصحوبة بعبارات عنه، لازلت أتذكرها جيدًا، وكان معها مجموعة صور بالأبيض والأسود أيضًا لمن وجدوا صورته الأولى، عندما فتح هاورد كارتر مقبرته لأول مرة عام 1922.
أنا أتحدث عن توت عنخ آمون، الملك الفرعوني الوسيم الذي أبهر العالم بقناعه، والذي أحببته منذ كنت طالبة في المدرسة، أرى صوره في الكتب، وأتشوق لمعرفة أي شيء عن مقبرته وكنوزه. وأتخيل نفسي مع فريق الباحثين أدخل المقابر لأول مرة، أبعد قدميّ عن الحشرات القاتلة، وأسعل بسبب التراب الكثيف، ثم أفتح عيناي على اتساعهما لأرى الألوان والنقوش التي حفظها الزمن، وأنظر إليها بدون شبع.
عندما اشترينا جهاز كمبيوتر لأول مرة في عام 2004 تقريبًا، أول مرة تعلمت استخدام الإنترنت، بحثت عن صور توت ومقبرته، كنت أفتح صورته واتأملها لوقت طويل، اتأمل ملامح وجه، الكحل في عينيه، نظرته، أحاول تخيل وجه الشاب خلف القناع، وأرسم له صورة من لحم ودم، وأتخيل، أن هذا الشاب صاحب الـ 19 عامًا، كان يحكم حضارة عظيمة مثل مصر.
بحثت عن قصته، قرأت تحليلات تشير إلى احتمال وفاته بالمرض، وقرأت أبحاث أخرى عن مقتله فشعرت بغصّة، كنت ولازلت شغوفة بالبحث عن كل ما نشر عن شكله وملامحه، والدراسات التي تحوم حول طبيعة حكمه وسبب نهايته.
كان توت صديقي طوال فترة المراهقة، كان فتى أحلامي، وكان أصدقائي في المدرسة يسخرون مني عندما نسأل بعضنا البعض عن فرسان أحلامنا، فالكل يقول مطرب أو ممثل مشهور أو لاعب كرة قدم، وكنت ببساطة أحب توت عنخ آمون. وكنت أحلم باليوم الذي أدرس فيه الآثار لأراه عن قرب، وأتعلم كيف أبحث عن المزيد من الكنوز والذهب المدفون تحت أرضنا، كنت أحلم باليوم الذي أصبح فيه عالمة آثار تعيش مع الفراعنة، تعرف لغتهم ورموزهم، تفكر مثلهم، وتزيح التراب عن وجوههم الجميلة وأعيدهم للحياة.

وجه نفرتيتي وعين ترانا بها
كبرت، وعندما جاء وقت الالتحاق بالجامعة سألت عن كلية الآثار ولكن ما سمعته أحبطني، فدرست الإعلام، ونسيت حلمي القديم بالعمل في مجال الآثار، لكني لم أنس حبي وشغفي بها. في بيتي الكثير من التحف والأشياء الفرعونية، وأحرص دائمًا على إهداء شيء فرعوني لأي صديق أو زائر غير مصري ألتقيه. أبحث عن أخبار الآثار، أتابع ما عثروا عليه، مرة تابوت، وأخرى سور مدينة، وتارة قطع أثرية، وأخرى برديات عريقة. في كل مرة يعثر فيها العلماء على شيء تمنيت لو أكون معهم.
مثلًا، قبل أيام أعلنت سلطات الآثار المصرية احتمالية وجود غرفة سرية في مقبرة توت عنخ آمون، وهذه الغرفة قد تكون مقبرة نفرتيتي جميلة الجميلات. نفرتيتي التي لا يوجد من لا يحبها، الجميلة السمراء صاحبة النظرة الثاقبة بعينها الواحدة، أردت أن أكون معهم، تمامًا كما أردت بشدة أن أراها في العاصمة الألمانية "برلين" عندما زرتها لكن المتحف كان مغلقًا، سألت صديقتي الألمانية عنها فقالت "موضوعة في غرفة بها إضاءة خافتة، محاطة بالكريستال، يمنعونك من التصوير أو أي أجهزة، لكنك بمجد رؤيتها، ستذهلين حقًا، إنها مثل قلب نابض في حجرة مظلمة هادئة".
كانت تحرك مصريتي كلما رأيتها في برلين في كل مكان، في محطات المترو والشوارع والأسواق التجارية، فلحسن الحظ كان هناك مهرجان موسيقى اختار وجه نفرتيتي للتسويق له، بقبعة زرقاء كبيرة وعين يخرج منها النور. ورأيت النور يشعّ من عينها التي لا ترى، وكأنها مصدر الخير والجمال للعالم. فرحت كثيرًا بذلك، وكنت أحمل معي هدية "نفرتيتي صغيرة" لصديقتي الألمانية، فأعطيتها إياها، وفرحت أكثر عندما أطلقت عليها اسم "بسمة الصغيرة"، وشعرت بأن هناك شيء أكبر يربطني بها، خاصة بعد ما رجح علماء الآثار احتمالية أن تكون الملكة هي والدة توت.
العصر الذهبي للفزع
في أوروبا، قتلتني الآثار المصرية المسروقة، ورأيت بعيني دولًا أخرى تتربح من تاريخنا وحضارتنا العريقة. وفي مصر، قتلني أكثر أني لم أجد من يهتم بذلك مثلما يفعل الغرب. في الأقصر، المدينة التي لا شبيه لها، وفي أسوان التي تحتوي على معابد لا يوجد مثلها في العالم، مثلها ككل مصر، مهملة وبدون خدمات، بينما تجد زوارًا يقطعون آلاف الأميال لزيارة المسلة المصرية في باريس! أو يلتقطون الصور أمام إحدى المسلات المصرية في روما!. كان ينتابني القهر كلما رأيت ذلك.. ألسنا نحن أولى؟ أليس هذا تاريخنا وحضارتنا؟ ولكني كنت أعود واسأل نفسي "ماذا فعلنا لتاريخنا وحضارتنا؟!". كلما قرأت عن قرب اكتشاف أثري جديد، دقّ قلبي بسرعة، خوفًا على إهمال المزيد. عندما عرفت بلصق ذقن توت عنخ آمون بمادة لاصقة رخيصة وغير مناسبة اشتعلت غضبًا، شعرت بأن شخصًا أهانني، وبأن هناك من يهزأ مني ومن عائلتي، وعندما رأيت التوابيت الفرعونية محمولة على الأكتاف أثناء نقلها مثل الأموات، شعرت بأنهم في طريقهم إلى موت آخر.
المهتمين بالاكتشافات الأثرية في العالم الآن في لحظة ترقب، لأنه بين لحظة وأخرى، قد يتم الكشف عن مقبرة فرعونية جديدة، وإزاحة الستار عن المزيد من الأسرار، وهو الأمر الذي يفرحني ويربكني في آن واحد، في الحقيقة، لا أعرف لماذا أكتب هذا المقال، لكنني فقط أحب الفراعنة، وأغار عليهم بشدة، وأفرح لأي اكتشاف جديد عنهم، وأحزن جدًا عندما يسرقهم خسيس أو يفرط فيهم نذل أو يهملهم مسئول، وأشعر بأن لديّ علاقة وثيقة بتوت وعائلته، لقد كبرت على حبه وحب تاريخنا العريق، ويؤذيني أن أرى من لا يحافظ على ذلك، وفي أعتاب عصر ذهبي جديد من الاكتشافات والأسرار المدفونة، وهو أيضًا عصر الإرهاب والقتل والفزع، أتمنى أن نحافظ على ما وجدناه وما سنجده، لأن هناك الكثيرون ممن هم مثلي، الذين لايزالون يفخرون بمصريتهم وحضارتهم العريقة.

أنا أتحدث عن توت عنخ آمون، الملك الفرعوني الوسيم الذي أبهر العالم بقناعه، والذي أحببته منذ كنت طالبة في المدرسة، أرى صوره في الكتب، وأتشوق لمعرفة أي شيء عن مقبرته وكنوزه. وأتخيل نفسي مع فريق الباحثين أدخل المقابر لأول مرة، أبعد قدميّ عن الحشرات القاتلة، وأسعل بسبب التراب الكثيف، ثم أفتح عيناي على اتساعهما لأرى الألوان والنقوش التي حفظها الزمن، وأنظر إليها بدون شبع.
عندما اشترينا جهاز كمبيوتر لأول مرة في عام 2004 تقريبًا، أول مرة تعلمت استخدام الإنترنت، بحثت عن صور توت ومقبرته، كنت أفتح صورته واتأملها لوقت طويل، اتأمل ملامح وجه، الكحل في عينيه، نظرته، أحاول تخيل وجه الشاب خلف القناع، وأرسم له صورة من لحم ودم، وأتخيل، أن هذا الشاب صاحب الـ 19 عامًا، كان يحكم حضارة عظيمة مثل مصر.
بحثت عن قصته، قرأت تحليلات تشير إلى احتمال وفاته بالمرض، وقرأت أبحاث أخرى عن مقتله فشعرت بغصّة، كنت ولازلت شغوفة بالبحث عن كل ما نشر عن شكله وملامحه، والدراسات التي تحوم حول طبيعة حكمه وسبب نهايته.
كان توت صديقي طوال فترة المراهقة، كان فتى أحلامي، وكان أصدقائي في المدرسة يسخرون مني عندما نسأل بعضنا البعض عن فرسان أحلامنا، فالكل يقول مطرب أو ممثل مشهور أو لاعب كرة قدم، وكنت ببساطة أحب توت عنخ آمون. وكنت أحلم باليوم الذي أدرس فيه الآثار لأراه عن قرب، وأتعلم كيف أبحث عن المزيد من الكنوز والذهب المدفون تحت أرضنا، كنت أحلم باليوم الذي أصبح فيه عالمة آثار تعيش مع الفراعنة، تعرف لغتهم ورموزهم، تفكر مثلهم، وتزيح التراب عن وجوههم الجميلة وأعيدهم للحياة.

وجه نفرتيتي وعين ترانا بها
كبرت، وعندما جاء وقت الالتحاق بالجامعة سألت عن كلية الآثار ولكن ما سمعته أحبطني، فدرست الإعلام، ونسيت حلمي القديم بالعمل في مجال الآثار، لكني لم أنس حبي وشغفي بها. في بيتي الكثير من التحف والأشياء الفرعونية، وأحرص دائمًا على إهداء شيء فرعوني لأي صديق أو زائر غير مصري ألتقيه. أبحث عن أخبار الآثار، أتابع ما عثروا عليه، مرة تابوت، وأخرى سور مدينة، وتارة قطع أثرية، وأخرى برديات عريقة. في كل مرة يعثر فيها العلماء على شيء تمنيت لو أكون معهم.
مثلًا، قبل أيام أعلنت سلطات الآثار المصرية احتمالية وجود غرفة سرية في مقبرة توت عنخ آمون، وهذه الغرفة قد تكون مقبرة نفرتيتي جميلة الجميلات. نفرتيتي التي لا يوجد من لا يحبها، الجميلة السمراء صاحبة النظرة الثاقبة بعينها الواحدة، أردت أن أكون معهم، تمامًا كما أردت بشدة أن أراها في العاصمة الألمانية "برلين" عندما زرتها لكن المتحف كان مغلقًا، سألت صديقتي الألمانية عنها فقالت "موضوعة في غرفة بها إضاءة خافتة، محاطة بالكريستال، يمنعونك من التصوير أو أي أجهزة، لكنك بمجد رؤيتها، ستذهلين حقًا، إنها مثل قلب نابض في حجرة مظلمة هادئة".
كانت تحرك مصريتي كلما رأيتها في برلين في كل مكان، في محطات المترو والشوارع والأسواق التجارية، فلحسن الحظ كان هناك مهرجان موسيقى اختار وجه نفرتيتي للتسويق له، بقبعة زرقاء كبيرة وعين يخرج منها النور. ورأيت النور يشعّ من عينها التي لا ترى، وكأنها مصدر الخير والجمال للعالم. فرحت كثيرًا بذلك، وكنت أحمل معي هدية "نفرتيتي صغيرة" لصديقتي الألمانية، فأعطيتها إياها، وفرحت أكثر عندما أطلقت عليها اسم "بسمة الصغيرة"، وشعرت بأن هناك شيء أكبر يربطني بها، خاصة بعد ما رجح علماء الآثار احتمالية أن تكون الملكة هي والدة توت.
العصر الذهبي للفزع
في أوروبا، قتلتني الآثار المصرية المسروقة، ورأيت بعيني دولًا أخرى تتربح من تاريخنا وحضارتنا العريقة. وفي مصر، قتلني أكثر أني لم أجد من يهتم بذلك مثلما يفعل الغرب. في الأقصر، المدينة التي لا شبيه لها، وفي أسوان التي تحتوي على معابد لا يوجد مثلها في العالم، مثلها ككل مصر، مهملة وبدون خدمات، بينما تجد زوارًا يقطعون آلاف الأميال لزيارة المسلة المصرية في باريس! أو يلتقطون الصور أمام إحدى المسلات المصرية في روما!. كان ينتابني القهر كلما رأيت ذلك.. ألسنا نحن أولى؟ أليس هذا تاريخنا وحضارتنا؟ ولكني كنت أعود واسأل نفسي "ماذا فعلنا لتاريخنا وحضارتنا؟!". كلما قرأت عن قرب اكتشاف أثري جديد، دقّ قلبي بسرعة، خوفًا على إهمال المزيد. عندما عرفت بلصق ذقن توت عنخ آمون بمادة لاصقة رخيصة وغير مناسبة اشتعلت غضبًا، شعرت بأن شخصًا أهانني، وبأن هناك من يهزأ مني ومن عائلتي، وعندما رأيت التوابيت الفرعونية محمولة على الأكتاف أثناء نقلها مثل الأموات، شعرت بأنهم في طريقهم إلى موت آخر.
المهتمين بالاكتشافات الأثرية في العالم الآن في لحظة ترقب، لأنه بين لحظة وأخرى، قد يتم الكشف عن مقبرة فرعونية جديدة، وإزاحة الستار عن المزيد من الأسرار، وهو الأمر الذي يفرحني ويربكني في آن واحد، في الحقيقة، لا أعرف لماذا أكتب هذا المقال، لكنني فقط أحب الفراعنة، وأغار عليهم بشدة، وأفرح لأي اكتشاف جديد عنهم، وأحزن جدًا عندما يسرقهم خسيس أو يفرط فيهم نذل أو يهملهم مسئول، وأشعر بأن لديّ علاقة وثيقة بتوت وعائلته، لقد كبرت على حبه وحب تاريخنا العريق، ويؤذيني أن أرى من لا يحافظ على ذلك، وفي أعتاب عصر ذهبي جديد من الاكتشافات والأسرار المدفونة، وهو أيضًا عصر الإرهاب والقتل والفزع، أتمنى أن نحافظ على ما وجدناه وما سنجده، لأن هناك الكثيرون ممن هم مثلي، الذين لايزالون يفخرون بمصريتهم وحضارتهم العريقة.

Published on December 03, 2015 07:57
August 29, 2015
10 أشياء تعلمتها من صديقتي الكافرة
بمقاييس مجتمعنا الشرق فصديقتي التي سأحكي عنها فاسقة ومنحلة وكافرة، وبما إني نشأت في سنوات عمري الأولى بدولة عربية غير وطني، وكان مصطلح "الحلال والحرام" و"الإيمان والكفر" أكثر ما يتردد في أذني في مآذن المساجد والدروس المدرسية، فإن ما تعلمته من هذه الكافرة كان واضحًا جليًا، لأني لم أتعلمه في المدرسة أو في بيتنا العربي التقليدي.
1- كم الوقت؟ "هل لديك 10 دقائق لنقوم بهذا الشيء؟"، "هذه المهمة تكفيها 45 دقيقة".. هذه الجمل عادية جدًا بالنسبة لها، وبالنسبة لي، فالثقافة الشائعة مع الوقت "6 ونص يعني 10 بالكتير" هي الغالبة في تحديد مواعيدنا وحياتنا. كم تستغرق للوصول من هنا لهناك؟ كم ساعة تحتاج لتختم هذه الورقة من الموظف المسئول؟ أو تحجز تذكرة قطار؟ لا قيمة للوقت في بلادنا، أعمارنا مهدورة في مواصلات وزحام وروتين لا ينتهي، والغالبية العظمى من الناس لا تشعر بقيمة الوقت، وإن شعرت بها فهي متراخية متكاسلة ترتدي الساعات حول معاصمها للأناقة فقط. علمتني صديقتي أني لا أستطيع التحكم في العامة، لكني أستطيع التحكم في وقتي، فإذا كنت مجبرة على ركوب أوتوبيس ممل بطيء لمدة ساعتين، فلماذا لا أستثمر الوقت في التخطيط لشيء ما أو قراءة صحيفة أو كتاب أو إنجاز أعمال معلقة؟
2- بلدك ليست سيئة إلى هذا الحد: تحب صديقتي الشمس الحارقة التي نكرهها في أغسطس، وتتمنى لو ولدت في بلد طقسه حار مثلنا، وتفاجئني بأنها تعرف شوارع ومناطق ومقاهي ومطاعم لا أعرفها، وتقرأ لكتّاب وأدباء لم أسمع بهم من قبل. هي أحبت مصر من نجيب محفوظ، وعندما كنا نتسكع في أحد الشوارع أوقفتني وقالت لي "في اتجاه الشرق يوجد مطعم كذا وأفضل أطباقه كذا، وفي الغرب توجد مكتبة أسعارها باهظة، وفي الجنوب محلات للملابس والتسوق، وفي الشمال يوجد فندق شهير"، كل هذا وهي في زيارة لأيام قليلة، تأتي إلى هنا لتستمع بالكرم والضيافة والطقس، وبعض المنتجات التي لا تجدها في مكان آخر. هي علمتني أن أبحث عن الجمال في المتاح حولي، حتى وإن كان مدفونًا ومهجورًا، وأن مشكلتنا ليست في القبح من حولنا، ولكن في جهلنا بطرق البحث عن الجمال.
3- هل احترمت الآخر اليوم؟ هي لا تؤمن بشيء، لكننا عندما نخرج سويًا وتسمع الأذان تسألني "بسمة.. هل نتوقف لتصلي في مكان ما؟" واسأل نفسي لماذا عليها أن تهتم بي وبمعتقداتي. غالبًا لا نتحدث عن الدين والمعتقدات، وإن تحدثنا يكون حديث منطقي، لماذا تؤمن بهذا ولا تصدق ذاك؟ تستمع لكل الآراء ولا تتعصب لشيء، ولديها قابلية لتغيير أفكارها في التو إذا اكتشفت أنها على خطأ.
4- هل لديك خطة بديلة؟ عندما سألتني هذا السؤال كنت محرجة جدًا، لأنه لا خطة أصلًا لدي لكي يكون لدي "خطة بديلة"، هي تتحدث عن المستقبل، كيف تخطط له وكيف تنفذ هذه الخطة، وما هي خطتها البديلة إذا ما فشلت الأولى، وما الصعوبات التي قد تواجهها، وما الحلول. ثقافة التخطيط ليست في مجتمعاتنا العربية عمومًا، فنحن نعيش "بالبركة"، وكلما سمعت حديث صديقتي عن الخطط والمستقبل، سألت نفسي، أي بركة في ناس يسيرون بلا هدف وبلا نظرة للمستقبل؟، نحن نعتقد بأن الله سيعطينا الكثير ولا نفعل شيئًا لنستحق هذا العطاء، لكن الحقيقة أن الأمر مختلف تمامًا، فالله يعطي المجتهد ومن يسعى لإعمار الأرض، لا من يمشي فيها مستهلكّا ملوثُا فقط.
5- لماذا أضايق الناس؟ كانت ترتدي فستان قصير مكشوف في منزلها، وكنا على وشك الذهاب لنأكل في مطعم، فاستأذنت لتغير ملابسها، قلت لها أن الفستان جميل وبإمكانها الخروج وليس عليها تغيير ملابسها، على أي حال ملامحها أجنبية واضحة والناس ستتقبل الأمر، ردت "ولماذا عليّ أن أضايقهم أو أستفزهم بملابسي؟ سأرتدي شيء آخر" وعادت وهي ترتدي ملابس تقليدية مثل أي بنت عربية عادية. قرأت الكثير من القصص عن أشخاص يسافرون للخارج ليخرجون أسوأ ما فيهم من رغبات مكبوتة بدعوى الحرية، لكن الحرية أن تحترم مساحة الآخر وإن كان مختلفًا معك كليًا.
6- لست أفضل من في الكوكب: قالت لي "تعرفين، هذا المطعم جميل جدًا، لكني حزينة لأنهم يقتلون الأسماك، قال لي أحد العاملين في المكان أنهم يصرفون نفاياتهم الصحية في النيل". صديقتي تفكر في الحيوانات، والطيور، والنباتات، عندما أعطيتها وردة هرعت إلى كوب ماء لتضعها فيه. قلت لها أننا بشر وأن كل هذه الكائنات مسخرة لخدمتنا، قالت "ولكن علينا أن نحترمها، لأنها حية وبها روح تمامًا مثلنا، يكفي أننا نستخدمها، وهي تقدم لنا خدمة عظيمة وبدونها نموت، كما أنها كائنات مسالمة ليست مثلنا، لا داع لإهانتها". طبعًا عندما أخبرتني أنها نباتية لأنها غير راضية عن معاملة الحيوانات المذبوحة في بلدها، وأنا.. سكتّ بالطبع!
7- لنستمتع!: انتهينا من وقت العمل، وهذا وقت المرح، لماذا لا نذهب لنشرب قهوة في مكان ما؟ العمل في الصباح أمر ضروري، والمتعة في المساء أكثر ضرورة. نحن بشر ولسنا آلات، وحتى الآلات الضخمة ترتاح من العمل. لماذا لا نروّح عن أنفسنا بالمشي قليلًا؟ بكوب من العصير؟ ببعض الموسيقى الهادئة؟ لا يتطلب الأمر الكثير من المال، ولكنه يتطلب الكثير من تقدير وشكر الذات.
8- أريد أن أنظف دماغي: اتصلت بي مرة لأن قنوات التليفزيون لديها بها عطل ما، وتريد إصلاحه، زرتها في منزلها ووجدت أن كل شيء سليم، لكنها قالت "قنوات BBC و"ناشيونال جيوجرافيك" و"ديسكفري" غير موجودة، لا أستطيع مشاهدة هذا الكم من التوك شو والصراخ والأخبار السيئة، أريد مشاهدة شيء "ينظف دماغي". هكذا تتعامل مع التليفزيون كمادة تختار ما يؤثر فيها، لم أخبرها طبعًا بروعة المشاجرات التليفزيونية ووصلات الردح والذم والسباب والإسفاف في إعلامنا، فقط أمسكت الريموت وبحثت لها عن القنوات، وعندما وجدتها، شكرتني وتنهدت وقالت "الآن أستطيع أن أشاهد شيئًا ممتعًا".
9- لا وجود للـ 100%: حكت لي مرة أنها ضربت شخصًا وشتمته، وأخرى كانت غاضبة وكسرت زجاج المنزل. هي ليست آلة، ولا إنسان من كوكب آخر. تسبّ بألفاظ سيئة، تضحك، تشرب، تفعل ما يحلو لها، تتأخر في مواعيدها أحيانًا، لا تلتزم بما تقوله أحيانًا أخرى، لكنها في النهاية إنسان، لا تؤذي الآخر بأفعالها قدر المستطاع. لم تتدع المثالية أبدًا لأن جزء من تقبلنا لأنفسنا أن نعرف أننا أخطأنا، ونخطئ، وسنخطئ مستقبلًا، وعلينا فقط ألا نكابر في ذلك. وكلنا كذلك، وبإمكاننا دائمًا أن ننظر للشيء الجيد في أي شخص.
10- ما هو الكفر؟ سردت بعضًا من صفات صديقتي التي إن حكيت لأحدًا عنها لقال إنها كافرة وحتمًا ستدخل النار، لكني طوال الوقت أعيد التفكير فيمن هو الكافر بحق؟ هل هو من لم يعلمنا احترام آدميتنا والكون الذي خلقه الله؟ هل هو من يهدر أعمارنا في دوامات لا نخرج منها أبدًا؟ بالتأكيد أن الله لا يحابي الجهلاء، وبخلاف المعتقدات الدينية والمصطلحات التقليدية، أعتقد أننا في حاجة لإيجاد تعريف آخر للكفر.
1- كم الوقت؟ "هل لديك 10 دقائق لنقوم بهذا الشيء؟"، "هذه المهمة تكفيها 45 دقيقة".. هذه الجمل عادية جدًا بالنسبة لها، وبالنسبة لي، فالثقافة الشائعة مع الوقت "6 ونص يعني 10 بالكتير" هي الغالبة في تحديد مواعيدنا وحياتنا. كم تستغرق للوصول من هنا لهناك؟ كم ساعة تحتاج لتختم هذه الورقة من الموظف المسئول؟ أو تحجز تذكرة قطار؟ لا قيمة للوقت في بلادنا، أعمارنا مهدورة في مواصلات وزحام وروتين لا ينتهي، والغالبية العظمى من الناس لا تشعر بقيمة الوقت، وإن شعرت بها فهي متراخية متكاسلة ترتدي الساعات حول معاصمها للأناقة فقط. علمتني صديقتي أني لا أستطيع التحكم في العامة، لكني أستطيع التحكم في وقتي، فإذا كنت مجبرة على ركوب أوتوبيس ممل بطيء لمدة ساعتين، فلماذا لا أستثمر الوقت في التخطيط لشيء ما أو قراءة صحيفة أو كتاب أو إنجاز أعمال معلقة؟
2- بلدك ليست سيئة إلى هذا الحد: تحب صديقتي الشمس الحارقة التي نكرهها في أغسطس، وتتمنى لو ولدت في بلد طقسه حار مثلنا، وتفاجئني بأنها تعرف شوارع ومناطق ومقاهي ومطاعم لا أعرفها، وتقرأ لكتّاب وأدباء لم أسمع بهم من قبل. هي أحبت مصر من نجيب محفوظ، وعندما كنا نتسكع في أحد الشوارع أوقفتني وقالت لي "في اتجاه الشرق يوجد مطعم كذا وأفضل أطباقه كذا، وفي الغرب توجد مكتبة أسعارها باهظة، وفي الجنوب محلات للملابس والتسوق، وفي الشمال يوجد فندق شهير"، كل هذا وهي في زيارة لأيام قليلة، تأتي إلى هنا لتستمع بالكرم والضيافة والطقس، وبعض المنتجات التي لا تجدها في مكان آخر. هي علمتني أن أبحث عن الجمال في المتاح حولي، حتى وإن كان مدفونًا ومهجورًا، وأن مشكلتنا ليست في القبح من حولنا، ولكن في جهلنا بطرق البحث عن الجمال.
3- هل احترمت الآخر اليوم؟ هي لا تؤمن بشيء، لكننا عندما نخرج سويًا وتسمع الأذان تسألني "بسمة.. هل نتوقف لتصلي في مكان ما؟" واسأل نفسي لماذا عليها أن تهتم بي وبمعتقداتي. غالبًا لا نتحدث عن الدين والمعتقدات، وإن تحدثنا يكون حديث منطقي، لماذا تؤمن بهذا ولا تصدق ذاك؟ تستمع لكل الآراء ولا تتعصب لشيء، ولديها قابلية لتغيير أفكارها في التو إذا اكتشفت أنها على خطأ.
4- هل لديك خطة بديلة؟ عندما سألتني هذا السؤال كنت محرجة جدًا، لأنه لا خطة أصلًا لدي لكي يكون لدي "خطة بديلة"، هي تتحدث عن المستقبل، كيف تخطط له وكيف تنفذ هذه الخطة، وما هي خطتها البديلة إذا ما فشلت الأولى، وما الصعوبات التي قد تواجهها، وما الحلول. ثقافة التخطيط ليست في مجتمعاتنا العربية عمومًا، فنحن نعيش "بالبركة"، وكلما سمعت حديث صديقتي عن الخطط والمستقبل، سألت نفسي، أي بركة في ناس يسيرون بلا هدف وبلا نظرة للمستقبل؟، نحن نعتقد بأن الله سيعطينا الكثير ولا نفعل شيئًا لنستحق هذا العطاء، لكن الحقيقة أن الأمر مختلف تمامًا، فالله يعطي المجتهد ومن يسعى لإعمار الأرض، لا من يمشي فيها مستهلكّا ملوثُا فقط.
5- لماذا أضايق الناس؟ كانت ترتدي فستان قصير مكشوف في منزلها، وكنا على وشك الذهاب لنأكل في مطعم، فاستأذنت لتغير ملابسها، قلت لها أن الفستان جميل وبإمكانها الخروج وليس عليها تغيير ملابسها، على أي حال ملامحها أجنبية واضحة والناس ستتقبل الأمر، ردت "ولماذا عليّ أن أضايقهم أو أستفزهم بملابسي؟ سأرتدي شيء آخر" وعادت وهي ترتدي ملابس تقليدية مثل أي بنت عربية عادية. قرأت الكثير من القصص عن أشخاص يسافرون للخارج ليخرجون أسوأ ما فيهم من رغبات مكبوتة بدعوى الحرية، لكن الحرية أن تحترم مساحة الآخر وإن كان مختلفًا معك كليًا.
6- لست أفضل من في الكوكب: قالت لي "تعرفين، هذا المطعم جميل جدًا، لكني حزينة لأنهم يقتلون الأسماك، قال لي أحد العاملين في المكان أنهم يصرفون نفاياتهم الصحية في النيل". صديقتي تفكر في الحيوانات، والطيور، والنباتات، عندما أعطيتها وردة هرعت إلى كوب ماء لتضعها فيه. قلت لها أننا بشر وأن كل هذه الكائنات مسخرة لخدمتنا، قالت "ولكن علينا أن نحترمها، لأنها حية وبها روح تمامًا مثلنا، يكفي أننا نستخدمها، وهي تقدم لنا خدمة عظيمة وبدونها نموت، كما أنها كائنات مسالمة ليست مثلنا، لا داع لإهانتها". طبعًا عندما أخبرتني أنها نباتية لأنها غير راضية عن معاملة الحيوانات المذبوحة في بلدها، وأنا.. سكتّ بالطبع!
7- لنستمتع!: انتهينا من وقت العمل، وهذا وقت المرح، لماذا لا نذهب لنشرب قهوة في مكان ما؟ العمل في الصباح أمر ضروري، والمتعة في المساء أكثر ضرورة. نحن بشر ولسنا آلات، وحتى الآلات الضخمة ترتاح من العمل. لماذا لا نروّح عن أنفسنا بالمشي قليلًا؟ بكوب من العصير؟ ببعض الموسيقى الهادئة؟ لا يتطلب الأمر الكثير من المال، ولكنه يتطلب الكثير من تقدير وشكر الذات.
8- أريد أن أنظف دماغي: اتصلت بي مرة لأن قنوات التليفزيون لديها بها عطل ما، وتريد إصلاحه، زرتها في منزلها ووجدت أن كل شيء سليم، لكنها قالت "قنوات BBC و"ناشيونال جيوجرافيك" و"ديسكفري" غير موجودة، لا أستطيع مشاهدة هذا الكم من التوك شو والصراخ والأخبار السيئة، أريد مشاهدة شيء "ينظف دماغي". هكذا تتعامل مع التليفزيون كمادة تختار ما يؤثر فيها، لم أخبرها طبعًا بروعة المشاجرات التليفزيونية ووصلات الردح والذم والسباب والإسفاف في إعلامنا، فقط أمسكت الريموت وبحثت لها عن القنوات، وعندما وجدتها، شكرتني وتنهدت وقالت "الآن أستطيع أن أشاهد شيئًا ممتعًا".
9- لا وجود للـ 100%: حكت لي مرة أنها ضربت شخصًا وشتمته، وأخرى كانت غاضبة وكسرت زجاج المنزل. هي ليست آلة، ولا إنسان من كوكب آخر. تسبّ بألفاظ سيئة، تضحك، تشرب، تفعل ما يحلو لها، تتأخر في مواعيدها أحيانًا، لا تلتزم بما تقوله أحيانًا أخرى، لكنها في النهاية إنسان، لا تؤذي الآخر بأفعالها قدر المستطاع. لم تتدع المثالية أبدًا لأن جزء من تقبلنا لأنفسنا أن نعرف أننا أخطأنا، ونخطئ، وسنخطئ مستقبلًا، وعلينا فقط ألا نكابر في ذلك. وكلنا كذلك، وبإمكاننا دائمًا أن ننظر للشيء الجيد في أي شخص.
10- ما هو الكفر؟ سردت بعضًا من صفات صديقتي التي إن حكيت لأحدًا عنها لقال إنها كافرة وحتمًا ستدخل النار، لكني طوال الوقت أعيد التفكير فيمن هو الكافر بحق؟ هل هو من لم يعلمنا احترام آدميتنا والكون الذي خلقه الله؟ هل هو من يهدر أعمارنا في دوامات لا نخرج منها أبدًا؟ بالتأكيد أن الله لا يحابي الجهلاء، وبخلاف المعتقدات الدينية والمصطلحات التقليدية، أعتقد أننا في حاجة لإيجاد تعريف آخر للكفر.
Published on August 29, 2015 16:14
مايا.. بطلة "الأدب" و"قلة الأدب"
 مايا من فيلم الفيل الأزرق
مايا من فيلم الفيل الأزرق مرحبًا صديقي القارئ، إذا كنت تعتقد أن هذا المقال يخص بطلة الأفلام الإباحية – مايا خليفة- فربما تكون على حق، لأنه كذلك، وربما تكون مخطئ لأنه ليس كذلك بالضبط.إذا كنت تبحث عن إثارة في هذا الموضوع قد تجدها أو لا تجدها، الأمر متعلق باستمتاعك، وهو الأمر الذي راهن عليه نزار قباني الذي أعتقد أنه أول من كتب عن "مايا" المثيرة، في قصيدته التي تحمل اسمها.
"إنِّي تعبتُ من التفاصيل الصغيرة"..
قد تكون قصيدة لا تتمتع بنفس شهرة باقي قصائد نزار، ربما لأن مطربًا لم يفكر أن يغنيها، وربما لن يفكر أحدًا في ذلك. ولكني على يقين أن لها شهرة سرية كالمنشورات، وكلمات الحب المكتوبة في ظهردفتر مدرسي، نتلصص عليها، نستمتع بها، ولا نخبر أحدًا. فالقصيدة تصف مايا بكل ما فيها، بشكل قد يعتبره البعض إباحي، أو مجرد مذكرات شاعر مع عاهرة، وكثير ما يتداولها الناس على أنها حقيقة وواقع، وأن نزار قابل هذه الفتاة وقصّ قصته معها في قصيدة، وأنها مستحيل أن تكون غير ذلك. حسنًا، لنعترف بالأمر. عندما قرأت القصيدة لأول مرة لم أنتبه إلى إثارة الجسد المذكورة بين طياتها بقدر انتباهي لصدق المكتوب، هناك أشياء عندما تقرأها، ربما من شدة جمالها أو قبحها، يصعب عليك أن تتخيل أنها مجرد قصيدة أو قصة، هناك شيء أبعد من ذلك، هناك تجربة حقيقية عاشها الكاتب وكتب عنها. وهو ما دفعني لسؤال "لماذا يُسبّ الكاتب الذي يقصص قصة حياته؟ ألا يمتلك إنسان على سطح الكوكب قصته الخاصة؟". بالنسبة لي، مهارة الكاتب أن يحكيها بشكل أدبي حتى لو كانت حقيقية وكما حدثت بالفعل، ما يهمني أن أستمتع بالقصة، لا أن ألبس دور محقق الشرطة وأتدخل في حياة كاتب لا يعنيني، وأنا أحببت "مايا" الجميلة المفعمة بالأنوثة والحياة في قصيدة نزار، أحببت وصفه لها. اتهم الكل نزار بممارسة الرذيلة والفجور وخدش حياء المجتمع، ولم يتهم أحد "مايا" على كونها شخصية لا يفوّتها كاتب، لم يحاسبها أحد على كل هذا الشغف والإلهام الذي أوحت به لشاعر، ليكتب قصيدة. "وأنا.. أسافرُ في أنوثتها.. وضحكتها..وأرسو كلّ ثانيةٍ.. على أرضٍ جديدة"..لأن مايا خرجت حيّة من بين الورق، عبرت كونها امرأة في قصيدة، لتكون "مايا" التي مجرد ما قرأت اسمها في رواية "الفيل الأزرق" لأحمد مراد، شككت أنه اقتبس شخصية روايته من القصيدة، فكما هي مكتوبة بلغة شعرية بالغة الجمال بخط نزار، كُتِبت مرة أخرى، بحيوية وجرأة في نصّ أحمد مراد. "مايا" التي بمجرد إطلالتها على شاشة السينما الكبيرة في عرض الفيلم المقتبس عن الرواية، امتلأت القاعة بالتصفيق والصفارات، وسمعت همسات الرجال حولي "مايا.. مايا" وسألت نفسي "ما الذي حدث؟ ما الذي فعلتيه يا مايا؟". عندما قرأت الرواية، استغربت من كمّ النقد الذي طال قصتها وحبكتها وألفاظها، وتجاهل الكلّ "مايا" التي أعطت البطل حبّات مخدر "الفيل الأزرق" الذي قامت عليه القصة ككل، "مايا" هكذا، تقلب الدنيا ولا تنال شيئًا حتى من الجدل. تشعل حريقًا وتمسك الشعلة في يدها وتقف جوار النار، لكن الأنظار تتجه للدخان، لعلها لا تقوى على النظر إلى مصدر اللهب الأحمر الناري. كلما قرأ شخص لنزار اتهمه بأنه "زير نساء" على الرغم من اعترافه بأنه لم يحب في حياته سوى مرات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكذلك أحمد مراد الذي واجه موجة نقد قوية وسباب وشتائم بسبب روايته وأسلوبه ونجاحه، لكن أحدًا لم يذكر مايا! "مايا مبللةٌ وطازجةٌ كتفاح الجبال" هكذا وصفها نزار، ولعله الوصف الأدق والأجمل لامرأة. لكن جمالها هنا أنها مكتوبة، لا نستطيع أن نرى "مايا" في الحقيقة، لكننا نتخيلها كتفاحة جبلية مرطبة بماء المطر، وتلقائيًا تفكر في تفاح الجبل، وعلوّه، وصعوبة الوصول إليه، وندرة وجوده، وإمكانية وجوده أصلًا على شجرة مزروعة على جبل، وعن المطر الذي سقط على شجرة التفاح واختص هذه التفاحة بقطرات باردة، تبلل وجهها وترطبها. كل هذه الصور مطوية في شطر واحد من القصيدة، فماذا لو تعمقنا في "الشمسُ تشرقُ دائماً مِنْ ظهر مايا " أو "مايا وراء ستارة الحمام واقفةٌ كسنبلةٍ"، و"مايا مهيأةٌ كطاووسٍ ملوكيٍّ"، و"مايا تفتّش عن فريستها كأسماكِ البحار".. لو بقيت في الاقتباس لطبعت القصيدة كلها هنا، فلكل شطر ألف صورة، ولكل صورة ألف رحلة، وهذا ما يصنعه الأدب، سواء كان عن تجربة حقيقية أو غير حقيقية، فوظيفتنا هو الاستمتاع فقط، والركض في رحلات قصيرة بأماكن لا نعرفها، ومع أشخاص نود لو نكتشفهم.وكذلك وصفها مراد، فقال ""مايا لادين لها"فهي دائمًا بطلة زئبقية، لا تستطيع الإمساك بها، وضعها في برواز، حبسها داخل قفص، "مايا – والتي تجسد المرأة في إحدى صورها الحرّة" ترفض أن تخضع لأي شيء، تغني وترقص، تتدلل، تقرأ، تفعل كل شيء، وتختار كل شيء. مشكلة "مايا" الخارجة للتو من القصيدة أو الرواية، وبطلة الأفلام الإباحية التي تحمل نفس الاسم، أن الأخيرة رخيصة، مباشرة، ومبتذلة، لا تقدم شيء – أعرف أن بعض الرجال يعارضونني في ذلك- لكن الحقيقة أننا نتغذى بالخيال أكثر من الواقع. مايا الأولى قد تتخيلها في ألف شكل، وألف طول، وألف لون، قد تحبها أو تكرهها، قد تصدقها أو لا، قد تبحث عنها أو تفتقدها، قد تتخيلها في كل امرأة حولك، لكن الأخرى ليس لديها الكثير من الاختيارات، فقد حددت نفسها مسبقًا، وهو فخ إن وقعت فيه المرأة، باتت كأي شيء آخر، يمكن استبداله. "وأنا أصدّقُ كلّ ما قال النبيذ..وكلّ ما قالتهُ مايا !"أنا أيضًا أصدقها، أصدق أن الخيال حيّ ونابض، مهما حاول الواقع طمسه أو التغلب عليه، مهما سخر منه الناس أو رفضه الكتّاب، يظل الخيال أشهى وأطيب، يظل ملاذًا لنا من حقارة العالم، ومن الأدب الرديء، وإذا كان خطأ أن يُكتب الأدب بناء على تجربة شخصية، أو قصة واقعية، فهو خطأ جميل، لأننا لن نعرف أبدًا الحقيقة، فالكاتب وحده يعلمها، والرواية كما "مايا" في قول نزار "تحلو حين ترتكبُ الخطايا!".
Published on August 29, 2015 16:12
عز الدين شكري فشير.. لاعب الورق المخادع

هل قابلت يومًا شخصًا ما وتمنيت لو أنه والدك، أو أن والدك مثله؟ هل قابلت ذلك الشخص الكبير في السن، الأنيق بتواضع، المهذب فكرًا وخُلُقًا وكلامًا، وجذبك سحر كلماته المنمقة، المرتبة بعناية، فتتمنى أكثر أن تلتصق به، ثم تفاجأ بأنه سياسي، فتخاف منه، خاصة عندما تعرف أنه ليس سهلًا أو مغلوبًا على أمره، هو فقط يعرف أصول اللعبة، ويترك الحبال تخنق ذويها دون أن يلمسها، هل أفزعك اقترابه الشديد من السلطة؟ وندمت على ما تمنيت؟ ثم عدت وقلت لنفسك يكفيه أنه يعترف بالخطأ، يكفيه أنه صادق.
هل سمعت في حديثه صوت العاشق الخائب، صوت الشاب الطموح الذي انكسر، فتحول لأب فاشل شبابًا وشيخوخة، هل أغرتك قوّة السياسي الذي يعرف كل الحيل ولا حيلة تنقذه، والرجل الطيب.. الخائن الصامت، الذي يغلب شيطانه الخاص ويتفوق على ملاكه الحارس، يدخل في الموضوع هكذا ببساطة وبوضوح، لكنه وضوح مخادع، وضوح الجريمة التي تقع أمام عينيك ولا تراها لأنك مشغول بشيء ما، وضوح الساحر في حبْك اللعبة أمام كل الجمهور، وشد انتباههم نحو شيء واحد فقط، ليعميهم عما يدور في الكواليس، ويكتشفوا أنهم جزء من العرض وليسوا متفرجين، وليسوا بهذه البراءة التي ظنوا أنفسهم بها، ولكنهم مغفلون، عميان، وربما مسحورين.. هذا هو ببساطة عز الدين شكري فشير.
كان الكثير من الناس يحكون عنه أمامي ولا أهتم، أو كما هي عادتي، لا أسعى للكتاب ولكني أتركه يسعى إليّ، وعندما وجدت "باب الخروج" أمامي فتحته، أملًا في الخروج من الواقع، في وقت كنت مللت فيه الكتب الطويلة بدون داع أو فائدة، ومن الصفحة الأولى التصق غلاف الكتاب في يدي، وشعرت بأن هناك شيء ما يربطني بهذا الكاتب، وبدلًا من أن أعبر "باب الخروج" وجدتني أدخل في عالم جديد.
مررت بنفس التجربة التي ذكرتها بالأعلى، تمنيت لو أن هذا الرجل الذي يكتب خطاب لابنه قبل موته بساعات هو أبي، كنت أقرأ الكتاب لأستمع إلى صوته، وأعيد قراءة فقرات لأني انتبهت للصوت وغفلت عن القراءة. ولكني عندما قرأت نصّ الخطاب، وهذا البرود والركود والتجاهل والسلبية الشديدة، تراجعت عما تمنيت. وبالتدريج عرفت حجم الكارثة التي حكاها الأب لابنه، ولم أعرف، هل أعذره أم أكرهه، هل ألعنه على مستقبلنا أم أقدّر محاولة إنقاذه؟ هل ما رواه لابنه حقيقي أم خدعة؟ وإلى أي مدى تكون الخدعة قريبة إلى حد مخيف من الواقع؟ هل كان يتنبأ، أم كان يحكي، أم يعترف؟ هل حصل على معلومات فعلًا؟ أم أنه خيال كاتب صادفت موهبته معلوماته السياسية؟ كانت هناك الكثير من الأسئلة التي تعصف بيّ، والنهاية الكئيبة الحزينة التي دمرتني لأيام، حتى أني صرت أطابق عناوين الصحف بسطور من الرواية، وأضحك.. وأرتجف، ويُشلّ تفكيري للحظات، وأحدق في الفراغ.
لم تكن المعلومات وحدها الجاذبة، ولكن طريقة الحكي أيضًا. يحكي فشير الحكايات بدون تزيين أو تجميل أو زخرفة، يكتب كما الواقع، بشكل مباشر وصريح ويدخل في صلب الموضوع، بمهارة جرّاح اعتادت يده على الأنصال الحادة. يقطع ويفتح ويبتر ويداوي، تتلوث يديه بالدم، يجفف عرقه ويكمل الحكاية، ليتركك سليمًا مُعافى أو جثة ميتة. في كل مرة يختار حدث سياسي هام، مرة ثورة وما بعدها حتى النهاية الكارثية النووية، ومرة ثورة وما قبلها من عفن ينهش جسد البلاد وفساد وتجاهل "الفرعون" والفراعين الصغيرة التي تقف خلفه كما تنظم أوراق "الدومينو" وعندما يسقط أولهم وأكبرهم، يسقطون جميعًا. ثم يذهب إلى "غرفة العناية المركزة"، ومن هناك يقص قصة "أبو عمر المصري" الملحمية، للمحام الذي تحوّل لإرهابي، والعناق المؤلم على جسر بروكلين، ويسافر مع الفراعين في أسفارهم، وغيرها الكثير من الحكايات.
يذكرني فشير بأمي، عندما كانت أمي تذبح الدجاجات أمامي، كنت أستغرب من قوتها، وسهولة وصعوبة ما تفعله في آن واحد، من ناحية هي تذبح الدجاجات لتكون على مائدة الغذاء، ومن جهة أخرى فهي تذبح.. تذبح كائن حيّ من رقبته!، ومن الجبروت أن تضع هذا المذبوح بعد نصف ساعة على طاولة الغذاء لنأكله. هل هذه دناءة أم حق؟ هل نحن متهمين أم ضحايا؟ هذا هو بالضبط ما يفعله فشير، فهو يقدم لك أصعب ما في الكون "إزهاق الروح" على طبق، ومعه ملعقة وشوكة من التساؤلات. اسأل نفسي كلما وضع أمامي طبق، من أين يأتي هذا الرجل بكل هذا السواد في الكتابة ورؤية تفاصيل العالم المعتم؟ كيف يقدر على الجمع بين الرقة والعذوبة والظلام؟! وما هي الوجبة التي سآكلها؟ أي حيوان مذبوح سألتهم جسده اللذيذ على مائدة الرواية؟
يقولون أن تلخيص فن الرواية في كلمتيّ "السهل الممتنع"، وأقول، أنه ربما التقت هاتين الكلمتين في رواية لعز الدين شكري، ربما عرّفهما على بعض، فهو يعطيني المعلومات كلها، بكفاءة وبإتقان، كأنما ساحر يعرف جيدًا من ومتى وأين وفي أي ثانية ستصنع اللعبة ويصفق الجمهور، ولا يترك لك مساحة للسؤال أو التشكك، فكل ما بقي على وجهك شيء من اثنين، الدهشة أو الصدمة مما يقدمه أمامك، لكن بعد انتهاء العرض، تفكر ألف مرّة، فيما سلبه هذا الساحر من عقلك.
Published on August 29, 2015 16:08
أسئلة سوزان عليوان.. إجاباتها تضعك في مأزق
 من رسوم سوزان عليوان
من رسوم سوزان عليوانفي مقهى جانبي عتيق بالقاهرة، قرأت بعضًا من أشعارها وسط حضور يحتفي بزيارتها وبحبهم لها، وجلست إلى جانب حائط، أقرأ معها في سرّي ما حفظته من أشعارها. طوال حياتي كانت لديّ عادة أن أحفظ ما أحب فقط، دون قصد، وإذا قصدت لن يثبت في ذهني. كانت تقرأ بصوت متقطع من الخجل، بعينين على وشك الدمع، بحزن تخجل من تعريته أمام العالم. عندما قرأت "لأن اللهَ واحدٌ والموت لا يُحصَى/ ولأننا لم نعد نتبادل الرسائلْ/ يُحدِث المطر في الفراغ بين قطرة وأخـرى.. هذا الدويَّ الهائل"، وهنا التقينا، بأعيننا وبكلامنا، في "هذا الدويّ الهائل".
على عكس العادة، لا يدفعني الغضب للكتابة هنا، وإنما التساؤل ومزيج من الحب والخوف. فمنذ قرأت لسوزان عليوان أول مرة، وتغيّر فيّ شيء ما، شيء لا أعرفه، وربما أحاول اكتشافه، واكتشاف نفسي، من خلالها. ببساطة، أكثر ما جذبني هو أسئلة سوزان في نصوصها الأنيقة، ولا أقول هنا أنها أنيقة مثل لوحة فنية في متحف، بالعكس، هي أنيقة مثل صندوق فضة تحتفظ به امرأة تحب، وتضع فيه كل ذكريات سعادتها وحزنها، وتفتحه كل قليل لتلقي نظرة، وتدمع وتبتسم.
الملفت في سوزان، ليس كتابتها فقط، ولكن هي نفسها، أتذكر أنني عندما التقيتها، كنت أتوقع رؤية سيدة لبنانية بطابع باريسي، حسب ما تخيلته من كتابتها، بها مزيج من روح العصر والفخامة التي تحجب الروح، ولكنها كانت بسيطة وهادئة ودافئة وخجولة، تشعر معها أنك وجدت شيء ما، شيء كنت تبحث عنه، أو ربما، من فرط ولعك به، وإيمانك به، وفقدان الأمل في لقاءه، أعطاك القدر إياه فجأة، هكذا، وبدون أي مقدمات أو تمهيد.
تسأل سوزان في أشعارها أسئلة كأسئلة الأطفال، أسئلة بريئة، وعميقة، ولا إجابات لها. تشبه فيها رسوماتها بأطفال مسدلين الرموش يحملون حمامات بيضاء فوق رؤسهن، وأغصان زيتون. تكتب وترسم لتبحث عن مدينتها، مدينة الأطفال والأحصنة الملونة والصور المبتسمة. لا تهتم بالنشر والمبيعات والدواوين وعناوين الصحف والمانشيتات عنها، تطبع الكتب وتهديها لمن تحبهم ويحبونها، هكذا فقط، الموضوع بسيط.
لسوزان أسلوب مميز في الكتابة، فهي تكتب بنصل سكين صغيرة مخفية في هيئة قلم، ولكنه ليس أداة عنف، قدر ما هو سهم في يد ملاك على سقف كنيسة. تكتب الجملة هكذا، قصيرة، ومباشرة، وغنية بالمعاني، وتشعر معها أنها لا تؤلف شيئا أو تجلس على كرسي الشاعر، ولكن تشعر بأنها تقول حقائق مطلقة، مثلا "لا شيء يُعادل قربك" جملة تنهي بها كل الصراعات الداخلية، وتضع قاعدة لا تقبل النقاش، تحتاج فقط لإدراجها في قوائم الحقائق العلمية.
أسئلة سوزان هي الجزء الأصعب من القصائد، فعندما تسأل مثلا "هل من عقاب، أقسى من الزمن؟" فتكون إجابتي "بالطبع لا"، ولكني أصمت، في كل مرة أقرأ القصيدة وأصل للسؤال وأصمت. وأسأل الكبار، الذين سبقوني في العمر بعشر سنوات أو أكثر، "هل الحياة عادلة؟" فتكون إجابتهم "لا"، "هل الحياة طيبة؟"، "لا". "هل الزمن عقاب؟" فلا أجد رد. إجاباتهم تخيفني، كأني ذاهبة في طريق رغما عني، ويجب أن أتقدم في العمر، وأذوق نفس الكأس، دون رغبة مني. كلما قرأت السؤال عاودني الأمل في أن يكون "الزمن" ليس عقاب، وإنما مكافأة، أو هدية، أو نتيجة. أي شيء يوصلني لحقيقة يمكنني أن أحلم بها، وأنتظر الأعوام القادمة من عمري – إن شاء الله لي – بحلم، مجرد حلم في أن يكون الزمن، طيّب معي.
السؤال الثاني هو "ما الذي بوِسْعي أن أقولَهُ، سوى أنَّ الأعداءَ كانوا أكثرَ عَدْلاً؟!"، وهنا لا أدعي أني عشت الكثير، فلازلت في العشرينات، ولكني ذقت مرارة الإجابة عنه مبكرًا. ليس لي أعداء عادلين حتى الآن، أو أعداء أحترم ذكاءهم وأخلاقهم وأتمنى أن نصبح أصدقاء يوما ما. كل ما لي هو خيبات أصدقاء، كان ظلمهم لي، أشد قسوة من ألف عدو. وتمنيت من شدة قسوتهم، أن يكونوا أعداء، ربما هان عليّ فراقهم. لم أحب أبدا الإجبار على الفراق، ولا يدرك عقلي – مهما حاولت إقناعه – بانتهاء الأشياء. الأبدية هي المعنى الأقرب لي، فالكون لا ينتهي، بل يتجدد، حتى الموت هو بداية لكون آخر. كيف لي أن أصدق أن شيئا قد انتهى؟ ما معنى الانتهاء في كون لا نهاية له؟ ما معنى النهاية والله موجود؟
وفي السؤال الثالث، التقيت جزء منها شديد الصلة بي، اللون الأزرق الذي يتحول من مجرد لون يتعامل الناس باعتباره ضمن باقة ألوان، إلى بحر، وسماء، وكوكب. فتسأل مثلا "أرى العالم، حجرة زرقاء.. هل ترى، ما أرى؟" وكأنها تسألك عن أهمية الأزرق لدي، وهل تشعر بالفعل أنه لون مقدس، لو لم يكن مقدس لما خُلق منه كل شيء، وفي سؤالها أيضا، تستشعر النبض، لتتأكد ما إذا كانت تحيا بمفردها في الكوكب الأزرق، أم أن هناك آخرين على سطح الكوكب. وتقول في جملة أخرى "من عرشها الأزرق البعيد، ستراهم بأحجامهم الحقيقية، بلا أسف.. أو حنين". العرش الأزرق على الكوكب الأزرق، تذكرني سوزان نفسها بقصة "الأمير الصغير" لأنطوان دي سانت أكزوبيري، الذي بحث بين الكواكب عن صديق، وعندما التقى بشريّ، طلب منه "ارسم لي خروفا" فقط. وطلب أن يكون الخروف غامض، داخل صندوق، لا يعرف أحد أن بداخله خروف صغير أبيض بفراء ناعم. هكذا هي سوزان، تقوم بمناوراتها خارج كوكبها، تبحث عن أصدقاء يرسمون لها خراف، وترسم لهم أحلامًا جميلة، وأطفال برموش مسدلة يؤمنون بكوكبها الأزرق، وعندما لا تجدهم، تكتب "كل ما حلمت به، خذلني، كأن قدميّ الصغيرتين مخلوقتين للانزلاق".
في كوكب سوزان أشياء تجدها أينما ذهبت، تشعر معها أنك في بيتك، فتجد: مصابيح، نوافذ، أصدقاء، الظل، أضواء، حزن، دمعة، وعلى عكس أغلب الشعراء الذين يسرفون في تكرار الكلمات، فإن سوزان تُعرّفك على أصدقاءها، وتشربون جميعا قهوة في بيتها، على أنغام موسيقى مجنونة لا تتوقع أبدا أن تكون لديها، حتى إنك إن قرأت قصيدة لها، ولم تجدهم، راجعت قراءتها أكثر من مرة، لتتأكد أن لا حزن هنا، هنا مساحة للفرح، فتثبت حضور الشيء بالتضاد. وتحمل أسئلتها هنا معاني بين الطيبة والعتاب واللوم والانكسار، فسؤال مثل "أينَ نافذتي أيَّتُها الجدران؟" قد تحسبه سؤال شخص غاضب محبوس بين جدران. ولكن، إن أعدت قراءته، ستشعر أنه لطفلة صغيرة ضاع منها شيء، نافذة في جدار مخبأ بغرفتها، اعتادت على الهروب منها لتشم الهواء وتشاهد القمر ليلا. وإن قرأته مرة ثالثة ستجد أنه لامرأة هدّها الزمن، وتبحث عن أي نافذة يدخل منها الضوء لحياتها، أو حبيبة تبحث عن أمل، أو سجين يشتهي الضوء، وكلما قرأت السطر نفسه، وجدت كثير من الأشخاص المحبوسين داخله.
كثير كثير من الأسئلة، والإجابات تتراوح بين صمت أو ملايين الكلمات، لازلت أبحث عن إجابات لها:بهذه الأطراف الطافئة.. كيف أحصي كم أحببتك؟ ألا يكفي ما فعلته بضحكتنا هذه البلاد؟كم من تلك الضحكة مضى من أسوار أعمارنا؟ كم من الوردة تبقّى؟ كم الساعة في نبضنا؟ لولا العصافير على أكتافها.. من يحدث التماثيل؟
أمام الأبواب الخاطئة.. ماذا نفعل بمفتاح؟
Published on August 29, 2015 16:04
صيام الكتابة

تأخرت في كتابة المقال الأسبوعي، فكرت في الأمر أكثر من مرة وصديقي يحثني على كتابة المقال وإرساله، كنت في سيارة أجرة عندما تلقيت رسالة نصية منه يسأل عن المقال الجديد، وكان سائق السيارة يقود ببطء وخلفنا سيارة أخرى لا يكف صوتها، لاحقتنا ثم أصبحت جوارنا، ثم سبقتنا، بعد أن رمق سائقها سائقي بنظرة غضب، استقبلها الأخير بجملة قالها بكل هدوء "مستعجل على إيه؟ لك معاد هتوصل فيه".
لا أصدق أن أشياء مثل هذه تحدث من قبيل الصدفة، خاصة في الوقت الذي أفكر فيه بكثافة في الوقت، كيف يتحول مرة إلى أرنب وأخرى إلى سلحفاة. وحولنا هوس إعلاني وإعلامي بالوقت، يحثنا دائمًا على اللحاق بالفرصة قبل أن تنتهي، أو على استرجاع ما مضى وإثارة ذكرياته وشجونه. على عكس كثير من الناس، لا أريد العودة للماضي، ولا أريد الذهاب للمستقبل، فقط أريد أن أستمتع بالحاضر وأتذوقه، لكن كيف ذلك دون ضغط مما سبق ومما هو آت؟ كيف نصوم عن التفكير في التفاهات وننزل أحمال تقطم ظهور إبداعنا؟
يقول د. محمد المخزنجي في كتابه "مداواة بلا أدوية" في فصل "العلاج بالصوم"، (والمقصود هنا الصوم عن الطعام) أن سقراط كان يصوم عشرة أيام كلما أراد حسم أمر ما، كما اعتاد المصريين القدماء صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفق ما ذكره المؤخر هيرودوت، كما استطاعوا علاج بعض الأمراض به، وكذلك أبو قراط أبو الطب اليوناني الذي اعتاد علاج المرضى بالصوم، وكان يقول أن "كل إنسان منا في داخله طبيب، وما علينا إلا أن نساعده حتى يؤدي عمله".
عندما قرأت فصل العلاج بالصوم في الكتاب، جذبتني فكرة الصيام الروحي عن متاعب الحياة، فكما يتعب الجسد من الأكل المصنع والملوث، تتعب الروح من اللهاث والركض المتواصل وراء الواقع. نحن – ككتاب- تشغلنا متطلبات الحياة مثلما تشغل أي شخص عادي، لا نعيش بقوقعة زجاجية، الخبز لا يأتِ إن لم ندفع ثمنه، وهذا يجعلنا في صراع دائم طوال الوقت، هل نعمل لنشتري الخبز والكتب، أم نكتب جيدًا لعل الكتابة تعطينا بعض الربح المادي، فنشتري الخبز والكتب أيضًا؟ كتبنا خبزنا، وخبزنا كتبنا، لا نستطيع الاستغناء عن أي منهما، لأننا بشر. ولأن الأنظمة السياسية والاجتماعية لا تلتفت إلى أصحاب الأقلام، إلا إن سبّوها أو مدحوها، وما دون ذلك يُعتبر كتابة على الماء.
أتوقف أحيانًا عن الكتابة، وأتوقف كثيرًا عن الحياة. كلما ذهبت أو سافرت لمكان للعمل تخطفني الكتابة منه، نهاري للعمل وليلي للكتابة. وكلما ذهبت لمكان سألت نفسي، ماذا لو جئت هنا لأجل الكتابة فقط؟ ماذا لو عشت حياتي كما أريدها فعلا، أطبق أفكاري المجنونة، أتأمل لساعات طويلة، وأعتزل البشر وقتما أريد. الاندماج وسط البشر والأحداث طوال الوقت مرهق للناس العادية، ومرهق بشكل مضاعف للكتّاب، فهم كالأطفال حالمين بسندباد يأخذهم كل يوم إلى رحلة جديدة.
الحياة مثل الأم، توقظنا رغمًا عنا لنذهب إلى المدرسة. لطالما كرهت الذهاب الإجباري للمدرسة، لكننا بدونه لن نتعلم، ولطالما كرهت قطع أحلامي في منتصفها، ومنبه هاتفي الغبي، ولكني من دونه سأمضي أيامًا في النوم، لكن تلك العتمة والتشويش من التتابع الممل لروتين الحياة وإجبارها لنا، يوقعنا بالتأكيد في فخ قفلة الكاتب، التي يقول عنها المخزنجي "تلك الحالة التي يفقد فيها الكاتب قدرته علي الكتابة والرغبة فيها. يغدو الوجود لديها بلا معني. ويكون ضعيفا أضعف ما يكون .ويصير انزواؤه فيما يشبه الصندوق المحكم نوعا من الكُمُون الواقي. يتحاشي مواجهة العالم بمثل هذه الدرجة المبرحه من الضعف ويأمل أن تعود روحه إلى انتفاضها في مثل هذه السكينة والهدأة".
كلما قرأت الجملة السابقة أدركت أن ما أبحث عنه هو السكينة والهدأة، ولا أجدهما إلا في صيام الروح، أو كما أحب أن أسميه صيام الكتابة، صيام من الواقع الذي يفوق قدرتنا وتحملنا كبشر، ننقي فيه أرواحنا كما ننقي أجسادنا، نصوم عن الضجيج المشتت، وعن الكتابة الرديئة، نصوم عن القبح لننتج الجمال، نصوم عن الواقع لنفطر على الخيال، نصوم قبل أن يصوم عنّا القلم. لا أعرف متى سيتحقق ذلك، لكني أطيّب خاطري بمقولة سائق التاكسي.
Published on August 29, 2015 15:58
قواعد "الناشر السحري" الأربعون
مشكلة دور النشر في مصر لا يمكن حصرها في مقالة، لأنك تحتاج لعشرات وربما مئات المقالات، للكتابة عن الكتب، والطباعة، والتغليف، والنشر، والتوزيع، والمكتبات، ومنظومة كاملة تحتاج للنسف وإعادة البناء. ولأن النشر في مصر سيطرت عليه "سبّوبة"، ولأن كل من امتلك بضعة آلاف جنيهات افتتح دارًا للنشر وجمع على اسمها آلاف الجنيهات من الشباب الراغبين في نشر أعمالهم، جاءت المشكلة. باستثناء عدد من دور النشر الكبرى والمعروفة اسمًا، والتي لا تقبل إلا أعمال كبار الكتّاب، أو الكتّاب الشباب لكن بعد أن يحققوا أرباح خيالية ومبيعات ضخمة، لن تجد في مصر ناشر يقوم بدوره على أكمل وجه إلا واحد أو اثنين على الأكثر، ومن هنا يمكن أن نضع المواصفات التي نأمل أن تكون في "الناشر السحري" لأنه كائن غير موجود، وغير حقيقي، وأي تشابه بينه وبين الواقع لا يمت له بصلة. وهذه المواصفات هي:1. أن يطبع ألف نسخة من الكتاب كطبعة أولى، وبهذا جدل كبير، فكثير من دور النشر تطبع مئة نسخة كطبعة أولى، وتفاجئ بأن كتاب ركيك قد حقق مبيعات لعشرة طبعات، وفي الحقيقة لم يطبع إلى واحدة!2. لا يحذف أي شيء من الكتاب أو يُغيره بدون موافقة الكاتب. 3. الطباعة النظيفة، والورق الجيد، والغلاف المناسب. وأن تكون كل المواصفات السابقة كما تم الاتفاق عليها مع الكاتب. 4. يجب أن يكون لدى الدار مصحح لغوي، وأن يكون بالفعل "مصحح لغوي" لا شخصًا يضع الهمزات والتشكيل بشكل عشوائي على الحروف. 5. الكاتب يختار الغلاف الأنسب للمادة المكتوبة، لا الأنسب للنقود التي في جيبك. 6. يجب أن يكون هناك لجنة قراءة من الخبراء. والخبراء هنا ليس "الناشر وزوجته"، أي أننا نريد مختصين يقيّمون الكتّاب فعليًا، "مش عشان عجب المدام!"، إلا إذا كانت "المدام" متخصصة. 7. نفترض أننا ككتّاب لا يجب أن ندفع من أجل أن يُنشر لنا، ولكن بسبب استحالة الأمر، فيمكننا أن ندفع، بشرط أن نجد مقابلًا على أرض الواقع لما دفعناه. 8. إذا كنا سندفع، فيجب أن ندفع التكلفة الحقيقية للطباعة، لأننا نستطيع أن نسأل المطابع بأنفسنا.. وحينها لن يكون موقفك مقبول أبدًا. 9. من أهم مواصفات الناشر السحري، أن يجيب على هاتفه بعد أن يحصل على الأموال! 10. يقوم بوضع شروط منطقية في العقد، مثل أن حقوق الملكية الفكرية للكاتب وليست للدار، وكذلك الأرباح يجب أن تكون مناصفة كما أن الدفع وتكلفة الكتاب مناصفة! وأن أي طبعة أخرى يجب أن تكون بموافقة الكاتب! 11. أن يحترم الكاتب ويعامله على أنه صاحب فكر ومبدع، وليس "فرصة" يمكنه من وراءها كسب المال، ولتعلم يا عزيزي "الناشر السحري" أن الكتابة الجيدة تحقق أرباح خيالية، واسأل القرّاء وهم سيخبرونك. 12. بالعودة إلى العقد، يجب أن يكون مسجل، وألا يماطل، أو "يستهبل" في كتابة العقد والتوقيع عليه وتسجيله!. 13. يتضمن العقد أن الناشر هو المسئول عن الدعاية بصفته دار للنشر، ومن أساسيات عملها أن "تنشر" وتتواصل مع الإعلام، وتوفر الكتاب في أكبر عدد ممكن من المكتبات. 14. استكمالًا للنقطة السابقة: إذا كان الكاتب صحفي أو عامل بمجال الإعلام، فهو يقوم بالتسويق لكتابه لأنه كتابه، وليس لأنك الناشر، لذا فإنه يقوم بذلك فضلًا منه وليس دور، وعليك كناشر – سواء قام بذلك أم لا – أن تقوم بدورك أنت في الدعاية.. تخيل!. 15. الكتاب يُطبع ليكون مكانه المكتبات، ليس المخازن ولا "شنطة" سيارتك.. آه والله. 16. الكاتب يتصل بك ليطمئن على كتابه، هل تم توزيعه، أين يوجد، ما هي أسماء المكتبات الموجود بها.. لا ليتغزل بك، من فضلك أجب على هاتفك!. 17. لا يوجد معنى لعدم نشر القصص والشعر والأبحاث.. ماذا عملك إذا؟ إذا لم تحقق هذه الكتب مبيعات فذلك لأنك لم تسوّق لها من الأساس، ولأنك تعتمد على ثقافة المجتمع الذي يفضل الرواية والمقالات الساخرة، ولكن ما دورك أنت إذا لم تضف أي شيء من خلال عملك؟ ما دورك إذا لم تغيّر تفكير المجتمع وتثبت له أن الشعر والقصة في أهمية الرواية والضحك؟! 18. هل أنت صاحب دار نشر محدودة بالمكان؟ هل هناك حدود جغرافية تضعها للكتب التي تنشرها؟ لماذا تنشر الكتب في وسط البلد والقاهرة والإسكندرية على أقصى تقدير؟ لماذا لا تكسر هذه الحدود وتصل للقراء في الصعيد وفي كل مكان؟ 19. بما إنك اخترت مجال النشر، فهذا يعني أنك ماهر في التعامل مع المطابع والمكتبات وغيرها، من فضلك لا تتدخل في النص ولا تتفذلك على الكاتب، إلا إذا كنت تقول رأي حقيقي وليس مجرد "تكسر مقاديف"، وإذا كنت أصلًا خبيرًا في النقد. 20. النشر للكاتبات حلال، ويمكن أن تنشر لهم بدون معاكسة أو تظبيط، أو استغفال لحقوقهن، أو "استهبال" أو "بصبصة"، أو تحرش. 21. ليس كل "قلش" يعتبر أدب ساخر، ولا كل "هرتلة" على "فيسبوك" تصلح للنشر في كتب. 22. لا تُقاس مهارة الكاتب بعدد "الفولورز" على حسابه وصفحته، ولكن بمهارته في صناعة الفن، فمثلُا قد تكون هيفاء وهبي لديها ملايين المتابعين لكنها لا تستطيع أن تكتب كتابًا (أعلم أنها فرصة ينتظرها كثير من الناشرين وربما يقترح عليها أحدًا ذلك بعد قراءته للمقال). 23. لا تستهين بما تفعل، ولا تنشر كتابًا رديئًا لمجرد الربح، أنت تغيّر ثقافة ووعي القراء بما تنشر، وإذا كان الكاتب فعلا يطمح في النشر فعليه أن يطوّر من نفسه. 24. معارض الكتب والمكتبات والأرصفة أماكن عامة لبيع الكتاب.. من فضلك اخبر الكاتب بها لعله يرى كتابه مرة في السوق قبل أن يموت. 25. أنت تتعامل مع كاتب، أي "صاحب رأي"، لذلك لا تسأله لماذا كتبت هذا ولماذا لم تكتب ذلك، لأنه ببساطة لم يسألك لماذا أصبحت ناشرًا ولماذا لم تصبح "طيار" في كنتاكي! 26. للكاتب حق في أرباح كتابه.27. إذا كنت نشرت الكتاب بالفعل، فهذا دورك، عملك الذي تكسب منه قوت يومك، فلا مجال للتنطيط على خلق الله وإقناعهم أنك حوّلتهم إلى كتّاب، هو كاتب بالفعل وألّف كتابًا وأعطاه لك لتنشره، وهناك آلاف يقومون بدورك، أنت لا تمنّ علينا بنشر الكتاب، بل تأخذ حقك، وزيادة!.28. كيف تخبر كتّاب دارك أن كتبهم فاشلة ولا تحقق مبيعات.. وأنت تغيّر سيارتك لأحدث ماركة كل بضعة شهور؟ ألا تعمل معهم في نفس الدار؟! أم أنك تاجر مخدرات بعد الظهر؟! 29. حفلات التوقيع والندوات دورك، جزء من دعايتك للكتاب، وتنظيمها ودعوة الناس والصحفيين إليها دورك أيضًا.30. انصب على قارئ مرّة ولن يشتري من دارك مرة أخرى، انصب على كاتب مرة، وسوف تندم على ذلك طوال حياتك. 31. اشتري الأفكار واستثمر فيها، دور النشر في الخارج تتفق مع الكتّاب وتمولهم ليكتبوا أفكارهم.. دعنا نفعل مثل "أوروبا والدول المتقدمة". 32. بالحديث عن "أوروبا والدول المتقدمة"، فالكتاب يتم طباعته في الموعد المحدد الذي تم الاتفاق عليه، لا بعد مماطلات وتأخير وتأجيل. 33. كونك كائن مسرف ولا تستطيع تدبير أموال للنشر، وتنتظر أن يدفع لك كاتب لتنشر لكاتب آخر، أو لتحاسب كاتب آخر على أرباحه، مشكلتك الشخصية، لا علاقة لي بها. (يمكنني فقط أن أدلّك على شخص يعالج إسرافك). 34. احترم كلمتك ووعودك قبل النشر وبعده. 35. نعلم أن القضاء المصري بعافية، وأن الحقوق والقانون في مصر مرحلة لم تأت بعد، لكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع أخذ حقوقنا، أسهل شيء يا عزيزي هو "الفضيحة"، لكنناعندما نسكت يكون اختيارًا منا.. صدقني. 36. أسعار الكتاب يجب أن تناسب السوق الذي تُباع فيه.. لا طموحاتك بالثراء السريع. والسعر الذي يباع به الكتاب يجب أن تخبر به الكاتب، لأننا سنعلم بأي حال. 37. الكتّاب الكبار لم يولدوا كذلك، ودور النشر العريقة لم تبدأ كذلك، وهذه دعوة لدور النشر الكبرى أن تفتح مجالًا للمواهب الشابة وأن تخصص لها نسبة من مطبوعاتها، وأن يتم ذلك في وقت مناسب. 38. لا يوجد فرق بين كاتب وكاتبة، والمقياس يجب أن يكون جودة النص، وليس النوع، والتفرقة بين حقوق الكتّاب على أساس نوعهم يدل على أنك لا تفهم مهنتك جيدًا ولا تفوم بها باحتراف. 39. لا نطلب منك أن تكون مثاليًا، ولكن يجب أن تكون محترفًا في عملك، والمحترف يستطيع التعامل مع الأخطاء وإصلاحها.
40. حسبي الله ونعم الوكيل.
Published on August 29, 2015 15:51



