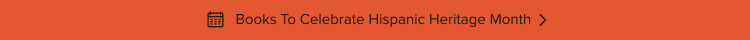أقفاص عبد الرزاق غورناه

عبد الرزاق غورناه- أقفاص..
كانت هناك أوقات شعر بها حامد كما لو كان دائما في المحل، وأن حياته ستنتهي عند هذا الحد. لم يعد يشعر بعدم الراحة، ولم يعد كذلك يسمع تلك الغمغمات السرية في ساعات الفراغ التي أفرغت قلبه من الخوف. لقد علم الآن أن الغمغمات قد آتت من هذا المستنقع الموسمي الذي فصل المدينة عن البلدات، والتي كانت تعج بالحياة. كان المحل في حال جيد؛ على مفترق طرق رئيسي من ضواحي المدينة. يفتحه عند أول بصيص ضوء عندما كان العمال المبكرون يمرون به، ولا يغلقه مرة أخرى إلا مع عودة المتشردون إلى منازلهم. كان يحب أن يقول أنه من موقعه قد رأى الحياة كلها تمر به. في ساعات الذروة، كان يقف على قدميه طوال الوقت، يتحدث ويمزح مع العملاء، ويرافقهم مستمعا بالعمل بخبرة من يتعامل بها مع نفسه والسلع. بوقت لاحق غرق منهكا فوق الكنبة التي تصلح كذلك كصندوق للنقود.
ظهرت الفتاة في المتجر بوقت متأخر بإحدى الأمسيات، بينما كان يعتقد أن الوقت قد حان للإغلاق. لقد وجد نفسه يغفو مرتين، وهي خدعة خطيرة في مثل هذه الأوقات البائسة. بالمرة الثانية، استيقظ في البدء، معتقدا بأن يدا كبيرة كانت تمسك بحلقه وترفعه عن الأرض. كانت تقف أمامه، منتظرة بنظرة اشمئزاز على وجهها.
قالت بعد انتظارها لدقيقة طويلة بقحة: “السمن”.. “بشلن واحد.”
وبينما تتحدث، التفتت، كما لو كان مشهده مزعجا. تم لف قطعة من القماش حول جسدها، مثنية عند الإبطين. تشبث القطن الناعم بها، مشكلا الحدود الخارجية لشكلها الرشيق. كانا كتفاها عاريين ومتألقين في الظلام. أخذ منها الإناء وانحنى إلى تنكة السمن. كان مليئا بالشوق وبألم مفاجئ. عندما أعاد لها الوعاء، نظرت إليه بشكل غامض، وعيناها بعيدتان وملتمعتان بالتعب. رأى أنها شابة، بوجه دائري صغير وعنق رفيع. دون أن تنبس ببنت شفة، استدارت وعادت إلى الظلام، آخذة خطوة كبيرة لتتفادى الخندق الإسمنتي الذي يفصل الرصيف عن الطريق. راقب حميد هيئتها المتراجعة وأراد أن ينادي عليها تحذيرا لها. كيف عرفت أنه لم يكن هناك شيء في الظلام؟ لم يخرج سوى صرير ضعيف وهو يخنق الدافع ليهرع إليها. انتظر، بين توقع بأن يسمع صراخها، لكنه فقط سمع الصفعات الصادرة عن حذائها بينما كانت تتقدم أكثر في الليل.
كانت فتاة جذابة، ولسبب ما بينما وقف يفكر فيها ويراقب الحفرة في الليلة التي اختفت فيها، بدأ يشعر بالاشمئزاز من نفسه. كانت محقة في النظر إليه بازدراء. بدا جسده، مع فمه مهترئيين. أصبح هناك سببا بسيطا باليوم ليغتسل أكثر من مرة باليوم. تستغرق الرحلة من السرير إلى المتجر دقيقة أو نحو ذلك. ولم يمضِ أبدا لأي مكان آخر. ما الذي يمكن أن يغتسل لأجله؟ ترنخت قدماه من عدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. كان قد قضى اليوم في عبودية. مرت أشهر وسنوات على هذا النحو، أحمق عالق مع قلم طوال حياته. أغلق المتجر بضجر، وهو يعلم أنه خلال الليل سوف ينغمس في قذارة طبيعته.
في المساء التالي جاءت الفتاة مرة أخرى إلى المتجر. كان حميد يتحدث إلى أحد زبائنه الدائمين، وهو رجل أكبر منه سناً، يُدعى منصور، يعيش في الجوار، وفي بعض الأمسيات يأتي إلى المتجر للتحدث. كان نصف أعمى بسبب غشاوة على عينه، وكان الناس يضايقونه بشأن معاناته، يجري عليه البعض منهم بعض الحيل القاسية. قال بعضهم عن منصور، لكونه أعمى، لأن عينيه كانتا مليئتين بالقذارة. لم يستطع الابتعاد عن الأولاد. أحيانا حميد يتساءل ما إذا كان منصور يتسكع في المحل لغرض ما، نحوه! لكن ربما كان محض خبث وإشاعات. توقف منصور عن الكلام عندما اقتربت الفتاة، ثم حدق بها بشدة وهو يحاول إخراجها من هذا الضوء الضعيف.
“هل لديك ملمع أحذية؟ أسود؟”
قال حميد: “نعم”. بدا صوته متجمدا ، تمتم ثم كرر كلمتها، “نعم”. ابتسمت الفتاة. قال منصور ‘مرحبا.. حبيبتي. كيف حالك اليوم؟” كانت لهجته شديدة الوضوح، ومليئة بفخر زائد، لدرجة أن حميد تساءل عما إذا كان المقصود منها مزحة. “يا لها من رائحة جميلة، التي تضعينها! صوت مثل العطر وجسد مثل الغزال. اخبريني، يا فتاتي(*)، ما هو الوقت الذي تكونين فيه متفرغة الليلة؟ أحتاج إلى شخص ليقوم بتدليك ظهري.”تجاهلته الفتاة. سمع حميد منصور وهو يجلس وظهره لهما بينما كان منصور يواصل الدردشة مع الفتاة وهو يغني لها بمديح جامح، محاولا تحديد موعد. في حيرته لم يستطع حميد أن يجد صفيحة الملمع. عندما استدار بها أخيرا، اعتقد أنها كانت تراقبه طوال الوقت وكانت مستمتعة لكونه مرتبكا للغاية. ابتسم، لكنها عبست ثم دفعت له. كان منصور يتحدث بجانبها، يتمايل ويتغزل، ويهزّ العملات المعدنية في سترة جيبه، لكنها استدارت وغادرت دون أن تنبس ببنت شفة. “انظر إليها، كما لو أن الشمس بنفسها لن تجرؤ على أن تشرق عليها.” فخور للغاية! لكن الحقيقة أنها لحم رخيص..” كان جسده يترجرج بلطف مع ضحك مكبوت. “سأحصل على هذا قبل أن يمضي وقتا بعيدا. كم تعتقد أنها سوف تأخذ؟ إنهن يفعلن ذلك دائما، هؤلاء النسوة، كل هذه الأجواء والنظرات المثيرة للاشمئزاز.. ولكن بمجرد أن تدخلهن في السرير، وتضعه بداخلن، فإنهن يعرفن من هو السيد..”
وجد حميد نفسه يضحك، رأى بأنه بذلك سيحفظ السلام بين الرجال، لكنه لم يكن يعتقد أنها فتاة يتم شراؤها. كانت متأكدة ومرتاحة للغاية في كل عمل لدرجة أنه لم يستطع تصديقها بما يكفي لتصورات منصور. ذهب باله إلى الفتاة مرارا وتكرارا، وعندما كان وحيدا، تخيل نفسه بحميمية معها. في الليل بعد أن أغلق المحل، ذهب ليجلس لبضع دقائق مع الرجل العجوز “فجر” الذي يملك المحل ويعيش بمؤخرة المحل. لم يعد يستطيع أن يرى بنفسه ونادرا ما يطلب منه مغادرة سريره. جاءت امرأة تعيش في الجوار، لتراه أثناء النهار وتأخذ في المقابل مواد بقالة مجانية من المتجر، لكن في الليل كان الرجل العجوز المريض يحب أن يجالسه حامد لفترة قصيرة. كانت رائحة الرجل المحتضر تعطر الغرفة أثناء حديثهم. لم يكن هناك الكثير مما يمكن قوله، وهو طقس من الشكاوى حول الأعمال السيئة والصلاة الحزينة من أجل استعادة الصحة. في بعض الأحيان، عندما تكون معنوياته منخفضة، كان فجر يتحدث بدموع عن الموت والحياة التي كانت تنتظره هناك. ثم يأخذ حميد الرجل العجوز إلى المرحاض، ويتأكد من أن وعاء غرفته نظيف وخالٍ، ويتركه. في وقت متأخر من الليل، كان فجر يتحدث إلى نفسه، وأحيانا يرتفع صوته بهدوء ينادي اسم حميد.
نام حميد بالخارج في الفناء الداخلي. أثناء هطول الأمطار، كان قد أفرغ مكانا في المتجر الصغير ونام هناك. أمضى لياليه بمفرده ولم يخرج قط. لقد مر أكثر من عام منذ أن غادر المحل، وقبل ذلك كان قد خرج مع فجر فقط، قبل أن يصيب الرجل العجوز قرحة الفراش. كان فجر يصطحبه إلى المسجد كل يوم جمعة، وتذكر حميد حشود الناس والأرصفة المتصدعة التي تبخرت تحت المطر. وفي طريقهم إلى المنزل ذهبا إلى وقام الرجل العجوز بتسمية الفاكهة اللذيذة والخضروات ذات الألوان الزاهية له، والتقط بعضا منها ليشمها، ويلمسها. منذ أن كان مراهقا، عندما جاء لأول مرة للعيش في هذه المدينة، كان حميد يعمل لدى الرجل العجوز. أعطاه فجر لوحته وعمل في المحل. في نهاية كل يوم كان يقضي لياليه بمفرده وغالبا ما يفكر في والده ووالدته، و مدينة ولادته. على الرغم من أنه لم يعد صبيا، إلا أن الذكريات جعلته يبكي ويتهيج بسبب المشاعر التي لا تتركه بحاله. عندما جاءت الفتاة إلى المتجر مرة أخرى لشراء الفول والسكر، كان حميد كريما في ميزانه. لاحظت ذلك وابتسمت له. ابتسم بسرور، رغم أنه كان يعلم أن ابتسامتها كانت مليئة بالسخرية. في المرة التالية قالت له شيئا ما، فقط تحية، لكنها قالتها بلطف.
أخبرته لاحقا أن اسمها رُقية وأنها انتقلت مؤخرا إلى المنطقة لتعيش مع أقاربها. سأل “أين منزلك؟” قالت “موويبييمارينغو”، وهي ترفع ذراعها للإشارة إلى أن الطريق كان بعيدا. “لكن عليك أن تمضي في الطرق الخلفية وفوق التلال..” كان بإمكانه أن يرى من الفستان القطني الأزرق الذي كانت ترتديه خلال اليوم الذي كانت تعمل كخادمة. عندما سألها عن مكان عملها ، زفرت بهدوء في البدء، وكأنها تقول إن السؤال غير مهم. ثم قالت له بأنها ستعمل ذلك حتى تتمكن من العثور على شيء أفضل، كانت خادمة في أحد الفنادق الجديدة في المدينة. قالت “أفضل فندق، خط الاستواء”. “يوجد حمام سباحة وسجاد في كل مكان. تقريبا كل شخص يقيم هناك “موزنجو** أوروبي. لدينا عدد قليل من الهنود أيضا، لكن لا أحد من هؤلاء الأشخاص من الأدغال يعرف كيفية تهوية الملاءات .”
توقف عند مدخل حجرة النوم في الفناء الخلفي لمنزله بعد أن أغلق المحل ليلا. كانت الشوارع فارغة وساكنة في تلك الساعة، وليست بالأماكن المزدحمة والخطيرة في الصباح. كان يفكر في رقية كثيرا، ويتحدث باسمها أحيانا، لكن التفكير فيها جعله أكثر وعيا بعزلته وقذارته. لقد تذكر كيف نظرت إليه أول مرة، مبتعدة بظل المساء المتأخر. أراد أن يلمسها.. كان يعتقد أن سنوات العيش في الأماكن المظلمة قد فعلت ذلك به، حتى أنه الآن ينظر إلى شوارع المدينة الأجنبية ويتخيل أن لمسة فتاة مجهولة سيكون بها خلاصه.
ذات ليلة نزل إلى الشارع وأغلق الباب خلفه. سار ببطء نحو أقرب مصباح بالشارع، ثم إلى المصباح الذي بعد ذلك. ولدهشته لم يشعر بالخوف. سمع شيئا يتحرك، لكنه لم ينظر. إذا لم يكن يعرف إلى أين يذهب، فلا داعي للخوف، لأن أي شيء يمكن أن يحدث. كان هناك راحة في ذلك. حول ناصية إلى شارع تصطف على جانبيه المحلات التجارية، أضاء واحد أو اثنان منها، ثم استدار نحو ناصية أخرى هربا من الأضواء. لم ير أحدا، لا شرطي ولا حارس ليلي. على حافة الميدان جلس لدقائق قلال على مقعد خشبي، متعجبا بأن كل شيء يجب أن يبدو مألوفا جدا. في إحدى الزوايا كانت ساعة البرج تنقر بهدوء في الليل الصامت. أعمدة معدنية مبطنة بجوانب الميدان، لا تعمل ولكن صحيحة. كانت الحافلات متوقفة في صفوف بأحد طرفيها، ومن مسافة كان يسمع صوت البحر.
تحرى مصدر الصوت واكتشف أنه لم يكن بعيدا عن الميناء. فجأة، جعلته رائحة الماء يفكر في منزل والده. كانت تلك المدينة أيضا بجانب البحر، وبمجرد أن لعب على الشواطئ وفي المياه الضحلة مثل جميع الأطفال الآخرين. لم يعد يعتقد أنه في مكان ما ينتمي إليه، في مكان ما كان منزله. تصاعدت المياه برفق عند سفح جدار البحر، وتوقف لينظر إليه وهو يتحول إلى زبد أبيض على الخرسانة. كانت الأضواء لا تزال تسطع بشكل ساطع على أحد الأرصفة وكان هناك أزيز من النشاط الميكانيكي. لا يبدو أنه من الممكن أن يعمل أي شخص في تلك الساعة من الليل.
كانت هناك أضواء مضاءة عبر الخليج، نقاط مفردة معزولة معلقة على خلفية من الظلام. تساءل متعجبا.. من عاش هناك؟ مرت عليه رعشة من الخوف. حاول تصور الناس الذين يعيشون في تلك الزاوية المظلمة من المدينة. أعطاه عقله صورا لرجال أقوياء بوجوه قاسية نظروا إليه وضحكوا. لقد رأى مساحات مضاءة بشكل خافت حيث تكمن الظلال في انتظار الشخص الغريب، وحيث يتزاحم الرجال والنساء في وقت لاحق على جسد المدينة. سمع صوت أقدامهم في طقوس قديمة وسمع صرخات الانتصار مع تدفق دماء أعدائهم في الأرض الواقعة. ولكن لم يكن التهديد الجسدي الذي يشكلونه فقط هو السبب الذي جعله يخشى الناس الذين يعيشون في الظلام عبر الخليج. كان ذلك لأنهم عرفوا مكانهم، وكان في وسط اللا مكان.
عاد نحو الدكان، غير قادر على المقاومة رغم كل شيء، شعورًا بأنه قد تجرأ على شيء. أصبحت عادة لديه فبعد أن يغلق المحل ليلا يذهب ليرى فجر، يذهب في نزهة إلى الميناء. لم يعجب فجر واشتكى من تركه وشأنه، لكن حميد تجاهل تذمره. بين الحين والآخر كان يرى الناس، لكنهم سارعوا بمحاذاته دون أن يلحظوه. خلال النهار كان يراقب الفتاة التي تملأ ساعات عمله. في الليل كان يتخيل نفسه معها. بينما كان يتجول في الشوارع الصامتة، حاول أن يعتقد أنها كانت هناك معه، تتحدث وتبتسم، وأحيانًا تضع راحة يدها على رقبته. عندما تأتي إلى المتجر، كان يضع دائمًا شيئا إضافيا وينتظر منها أن تبتسم. تحدثا في كثير من الأحيان، بضع كلمات من التحية والصداقة. عندما كان هناك نقص، أكمل خدمته لها من الاحتياطيات السرية التي احتفظ بها لعملاء مميزين. فكلما تجرأ امتدحها على مظهرها، وتلوى في شوق وارتباك عندما تكافأه بابتسامات مشرقة. ضحك حميد على نفسه وهو يتذكر تفاخر منصور بالفتاة. لم تكن فتاة تُشترى ببضعة شلنات، بل فتاة تُغنى لها، تُربح بالإقدام والشجاعة. ولم يكن لدى منصور، نصف الأعمى مع القرف الذي هو عليه، ولا حميد كذلك الكلمات أو الصوت لمثل هذا العمل الفذ.
في وقت متأخر من مساء أحد الأيام، جاءت رقية إلى المتجر لشراء السكر. كانت لا تزال ترتدي ثوب العمل الأزرق الذي كان ملطخا بالعرق تحت الذراعين. لم يكن هناك أي زبائن آخرين، ولا يبدو أنها في عجلة من أمرها. بدأت في مضايقته برفق، قائلة شيئا عن مدى صعوبة عمله.
“يجب أن تكون ثريا جدا بعد كل الساعات التي تقضيها في المتجر. هل لديك حفرة في الفناء حيث تخفي أموالك؟ يعلم الجميع أن أصحاب المتاجر لديهم كنوز سرية. هل توفر لأجل العودة إلى بلدتك؟
احتج قائلا: “ليس لدي أي شيء”. “لا شيء هنا يخصني”.
ضحكت غير مصدقة. قالت: “لكنك تعمل بجد أكثر من اللازم، على أي حال”. “لا تمرح بأي شكل.” ثم ابتسمت وهو يضع غرفة من السكر.
قالت وهي تميل إلى الأمام لأخذ الطرد منه: “شكرًا لك”. بقيت على هذا الحال للحظة أطول من اللازم؛ ثم عادت ببطء. “أنت دائما تعطيني أشياء. أعلم أنك سترغب في شيء في المقابل. عندما تفعل ذلك، سيكون عليك أن تعطيني أكثر من هذه الهدايا الصغيرة. لم يرد حميد، مملوء بالخزي. ضحكت الفتاة بخفة وابتعدت. استرقت النظر نحوه لحظة، مستهزئة به، قبل أن تغرق في الظلام.
* المعنى بالتنزانية..
**: تعني رجل أبيض، عند شرق أفريقيا..